البيانات: أصوات تُشكّل رواية السودان
“من قلب المعاناة يولد الأمل… شباب معسكر سرتوني يشيّدون “خزان الحياة” لمواجهة أزمة المياه”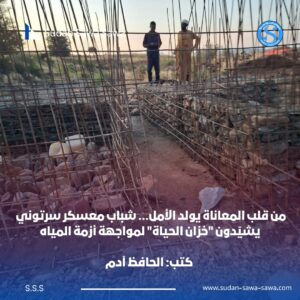


كتب: الحافظ آدم
سودان سوا سوا – 12 ديسمبر 2025
تتواصل فصول معاناة آلاف النازحين في إقليم دارفور – غرب السودان، في ظل تفاقم أزمة المياه التي تضرب معظم مناطق الإقليم، وعلى رأسها معسكر سرتوني الواقع شمال جبل مرة، وعلى بُعد 50 كيلومترًا جنوب محلية كبكابية بولاية شمال دارفور – غرب السودان.
وسط هذه الظروف، أطلق قروب شباب معسكر سرتوني للنازحين مبادرة مجتمعية رائدة تهدف إلى إنهاء معاناة استمرت أكثر من أربع سنوات، من خلال صيانة آبار “كوبي” وبناء خزان مياه جديد لتوفير الإمداد المائي لآلاف الأسر داخل المعسكر.
سرتوني… حكاية نزوح طويل منذ 2003:
قبل اندلاع الهجمات المسلحة على قرى دارفور عام 2003م ، كانت منطقة سرتوني تنعم بحياة هادئة يقطنها أبنائها، ويعتمدون على الزراعة والرعي في أرض عُرفت بخصوبتها.
لكن مع تصاعد وتيرة الهجمات، اضطر السكان للنزوح نحو الجبال والوديان، قبل أن يستقر عدد كبير منهم في مناطق شمال جبل مرة، فيما اتجه آخرون نحو المدن القريبة بحثًا عن الأمان. وفي عام 2004 وصلت بعثة الاتحاد الإفريقي إلى المنطقة، ما سمح للمنظمات الإنسانية بالدخول وتقديم الإغاثة.
وفي عام 2007، جاءت بعثة اليوناميد (البعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة) لتعزيز حفظ السلام. ورغم ذلك، تكررت الهجمات عام 2016، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة نتج عنها قيام معسكر سرتوني كملاذ لآلاف الأسر الهاربة من النزاع.
وبعد انتهاء مهمة اليوناميد في 2021، ومع اندلاع حرب 15 أبريل 2023، ارتفع عدد النازحين في المعسكر إلى أكثر من 40 ألف أسرة، لتتفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة كبيرة، خصوصًا في قطاعات المياه والغذاء والصحة.
أزمة المياه… جفاف مستمر منذ خروج اليوناميد:
وفقًا لإدارات المعسكر وشهود عيان، بدأت أزمة المياه في سرتوني بعد خروج بعثة اليوناميد في 2021، إذ توقفت الصيانة عن آبار كوبي غربي المعسكر بسبب نقص المعدات والدعم الفني. ومنذ ذلك الوقت، واجه السكان صعوبة كبيرة في الحصول على المياه النظيفة، في ظل تدهور الوضع الإنساني.
شباب سرتوني… مبادرة تصنع الفرق:
في 20 مايو 2024، أعلن قروب شباب معسكر سرتوني—عبر لجنته الإشرافية داخل وخارج السودان—إطلاق حملة لجمع التبرعات لصيانة الآبار وتنفيذ مشروع الخزان. وذكر أعضاء اللجنة، ومن بينهم كاتب التقرير باعتباره مقررًا للجنة، أن المبادرة تطوعية بالكامل وتعتمد على مساهمات الشباب والروابط والخيرين داخل السودان وخارجه.
وبعد أن تكفلت إحدى المنظمات الإنسانية بصيانة آبار كوبي، انتقلت المبادرة إلى الخطة (ب): بناء خزان مياه جديد يضمن توفير الإمداد المائي المستدام لسكان المعسكر.
تنفيذ المشروع… “نفير” يعيد الروح للمجتمع:
انطلقت أعمال البناء رسميًا في 1 يونيو 2025 بنفير شعبي واسع شارك فيه سكان المعسكر. شملت المراحل الأولى نقل الحجارة والرمال وتنظيف موقع الخزان، قبل الانتقال إلى الحفر وبناء الأساسات خلال شهري يونيو ويوليو.
وفي 17 أكتوبر 2025، تم تركيب ربط السايفون، بينما تتواصل الآن أعمال صب الخرسانة وتركيب الأبواب وبناء حوض المياه تحت إشراف المهندس ياسين الطاهر.
وبحسب دراسة الجدوى، تجاوزت تكلفة المشروع 50 مليون جنيه سوداني، تم جمع جزء كبير منها عبر تبرعات الشباب والجهات الخيرية،ومتبرعون أفراد من داخل السودان وخارجه.
كما دعت اللجنة الإشرافية إلى استمرار تدفق التبرعات حتى اكتمال المشروع بصورة كاملة.
ترحيب واسع ودعم متزايد:
لقيت المبادرة إشادة كبيرة من إدارة معسكر سرتوني وسكانه الذين أكدوا دعمهم الكامل لاستكمال المشروع، مؤكدين أنه يمثل خطوة نوعية نحو تحسين الخدمات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
كما عبّر عدد من النازحين عن امتنانهم للشباب المتطوعين، مؤكدين أن الخزان يمثل “نقطة أمل وسط العتمة”.
توقعات ما بعد اكتمال المشروع:
من المنتظر أن يحقق مشروع خزان سرتوني جملة من الفوائد، أبرزها:
-توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب لآلاف الأسر.
-تعزيز التكافل والعمل الجماعي داخل مجتمع المعسكر.
-تشجيع مبادرات شبابية جديدة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي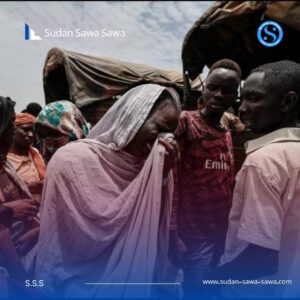
سودان سوا سوا – 25 نوفمبر 2025
أطلقت مؤسسة سودان سوا سوا اليوم الثلاثاء، حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحماية النساء والفتيات في مختلف أنحاء السودان.
وشددت المؤسسة على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في كشف الانتهاكات وتوثيقها، باعتباره أداة مؤثرة في دعم جهود المساءلة، وتمكين المجتمع من فهم حجم التحديات التي تواجه النساء، إلى جانب تعزيز ثقافة المساواة والكرامة الإنسانية.
ويواجه السودان مستويات مرتفعة من العنف ضد النساء والفتيات، خاصة في مناطق النزاعات، حيث تشير تقارير محلية ودولية إلى حالات عنف جنسي واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب، مما يعكس خطورة الوضع وضرورة تكثيف التدخلات الإنسانية وبرامج الحماية.
ودعت المؤسسة جميع وسائل الإعلام والمنظمات والمجتمع المدني إلى تنسيق الجهود والعمل المشترك لضمان بيئة آمنة وخالية من العنف والتمييز، مؤكدة أن مواجهة هذه الانتهاكات مسؤولية جماعية تتطلب عملاً منظماً ومستمراً.
الأغذية العالمي واليابان يتعاونان لتوفير وجبات مدرسية للأطفال في السودان
سودان سوا سوا أكتوبر 2025م
كتب:حسين سعد
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تلقيه مساهمة جديدة من حكومة اليابان بقيمة 400 مليون ين ياباني (حوالي 2.7 مليون دولار أمريكي) لدعم توفير وجبات مدرسية للأطفال في السودان.وقال لوران بوكيرا، المدير والممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، في بيان صحفي إطلعت عليه مدنية نيوز اليوم إن هذه المساهمة تأتي في وقت حرج مع إعادة فتح المدارس، مؤكداً أنها ستساعد الأطفال الضعفاء على استئناف تعليمهم وتحسين نتائجهم الدراسية. وأضاف: “نحن ممتنون للغاية لحكومة وشعب اليابان على تضامنهما المستمر مع شعب السودان”.
من جانبه، أوضح ميزوتشي كنتارو، القائم بأعمال السفير الياباني لدى السودان، أن الحرب المطولة حرمت مئات الآلاف من الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، معرباً عن أمله في أن تسهم الوجبات المدرسية في تشجيعهم على العودة للفصول الدراسية.
وترفع هذه المساهمة إجمالي دعم اليابان لعمليات برنامج الأغذية العالمي في السودان إلى 21 مليون دولار أمريكي منذ عام 2022، ما يعكس التزام طوكيو المستمر بالعمل الإنساني ودعم الشعب السوداني.
ويمثل التمويل الجديد نحو 13% من احتياجات البرنامج للأشهر الستة المقبلة، بينما لا يزال البرنامج بحاجة إلى 14.8 مليون دولار أمريكي إضافية لمواصلة أنشطته الخاصة بالوجبات المدرسية حتى مارس 2026.
يُذكر أن السودان يواجه حالياً أكبر أزمة جوع في العالم، حيث يعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 638 ألف شخص في ظروف كارثية، ما يجعل الاستثمار في التعليم والتعافي المبكر خطوة بالغة الأهمية.
“من أكتوبر إلى ديسمبر: أين اختفى المثقف السوداني في زمن الحرب(2)”
كتب: حسين سعد
سودان سوا سوا 1 أكتوبر 2025
لعب المثقفون السودانيون دوراً محورياً في لحظات التحول التاريخي في ثورة أكتوبر 1964، كانوا في طليعة الحركة الطلابية والنقابية التي فتحت أفق الحرية والديمقراطية، ، في أبريل 1985، أسهموا في صياغة خطاب التغيير وإعادة الاعتبار لقيم الديمقراطية، وفي ثورة ديسمبر 2019، كان حضورهم واضحاً في صياغة شعارات الحرية والسلام والعدالة التي ألهمت الجماهير، لكن المشهد الحالي يكشف عن غياب مقلق لصوت المثقف، لقد هيمنت لغة السلاح على الحياة العامة، وأُقصي الفكر النقدي إلى الهوامش. ومع انقسام القوى المدنية والسياسية والنقابية، وجد المثقف نفسه إما محاصراً بالخوف أو مُستغرقاً في انحيازات حزبية أفقدته استقلاليته. والنتيجة: فراغ فكري خطير سمح لخطاب الكراهية والعنصرية بأن يملأ الساحة بلا مقاومة تُذكر، إن إعادة الاعتبار لدور المثقف تتطلب منه شجاعة أخلاقية وفكرية مضاعفة، ليصبح صوتاً للوعي العام، لا صدى لصراعات النخب السياسية. فالمثقف ليس مجرد مراقب محايد، بل شريك أساسي في صياغة المستقبل. فالسلام الحقيقي لا يُبنى فقط على طاولة المفاوضات، بل في فضاء الحوار الفكري الذي يُعيد تعريف معنى الوطن والمواطنة. فالجدل الفكري ليس ترفاً، بل أداة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ولتجاوز الثنائية الصفرية بين الغالب والمغلوب، عندما ينفتح الفضاء السوداني على نقاش جاد لقضايا الهوية، والدين والدولة، والعدالة الاجتماعية، يمكن حينها أن يتحول الخلاف من صراع دموي إلى تعددية خلاقة. وهذا ما يجعل استدعاء الفكر ضرورة، لأن بدونه سيظل أي اتفاق سياسي هشاً، معرضاً للانهيار مع أول أزمة جديدة، إن الجدل الفكري المطلوب اليوم لا يقتصر على النخب وحدها، بل يجب أن يمتد إلى القواعد الشعبية عبر النقابات، الجامعات، الإعلام، ومنابر المجتمع المدني، بحيث يتحول إلى حوار وطني شامل يفتح الباب لتأسيس مشروع جامع يعيد صياغة الدولة السودانية على أسس العدالة والمواطنة.
غياب الفكر وهيمنة السلاح:
ورداً علي سؤال مجلة (قضايا فكرية) في ظل الحرب المدمرة التي يعيشها السودان، يبرز سؤال جوهري: لماذا يغيب البعد الفكري في معالجة الأزمات بينما يتصدر المشهد الخطاب العسكري ولغة السلاح؟ يري أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الدكتور الفاتح تبار :
الأزمة السودانية ليست وليدة اللحظة، بل هي متجذّرة في طبيعة الدولة نفسها منذ نشأتها، فالدولة التي ورثها السودانيون عن الاستعمار لم تكتمل بنيتها، إذ هدم الاستعمار البُنى التقليدية القديمة دون أن يبني مؤسسات حديثة متماسكة وراسخة ، فظل السودان في وضع انتقالي معلق: لا هو دولة حديثة ولا هو دولة تقليدية، ما أدى إلى تداخل المراحل وتشابكها، ويضيف دكتور الفاتح أن النخب السياسية التي تولت القيادة بعد الاستقلال لم تضع أسساً متينة لبناء الدولة الوطنية، بل إنشغلت بالصراعات الحزبية والطائفية والقرارات المتسرعة، مثل قضية تقرير المصير لجنوب السودان، ما أدى إلى إضعاف الوحدة الوطنية وتفكيك النسيج الاجتماعي، كما أن الدولة، بحسب حديثه، فشلت في كسب ولاء المواطنين بعيداً عن القبيلة والطائفة، إذ لم تقدم خدمات أو فرصاً عادلة للجميع. ومع تكرار الانقلابات العسكرية وتغلغل الإسلاميين في مفاصل السلطة، تعمقت الأزم.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن جوهر الأزمة ليس فكرياً محضاً، بل هو في الأساس أزمة سلطة مرتبطة بمحتواها الاجتماعي، فالسلطة تركزت في يد مجموعات محددة من الشمال والوسط، مما أدى إلى تهميش بقية الأقاليم وإقصائها من الموارد والتمثيل السياسي والثقافي، وهو ما جعل قضايا الهوية أو الصراع بين المركز والهامش أو بين العروبة والأفريقانية مجرد عناوين لصراع أعمق حول السلطة وتوزيع الثروة، وأضاف أستاذ العلوم السياسية :هذا الأداء الهش أدى إلى غياب (الممسكات القومية) الجامعة، وفتح الباب أمام خطابات الكراهية والعنصرية، خاصة وأن الدولة لم تستطع أن تقنع المواطنين بالولاء لها بديلاً عن القبيلة أو الطائفة، لأنها ببساطة لم تقدم لهم ما يرسّخ هذا الولاء. ومع تكرار الانقلابات العسكرية وتغلغل الإسلاميين في مفاصل الدولة، تعمّقت الأزمة أكثر، ويرى دكتور الفاتح أن جوهر الإشكال في السودان ليس فكرياً بحتاً، بل هو أزمة سلطة في مضمونها الاجتماعي. فالمحتوى الاجتماعي للسلطة تركّز في يد مجموعات محدودة من شمال ووسط البلاد، بينما جرى تهميش بقية الأقاليم، وبذلك أصبح الصراع على السلطة والثروة هو جوهر كل الخلافات التي يُروَّج لها فكرياً: من صراع الهوية بين العروبة والأفريقانية، إلى جدل الدين والدولة، وحتى ثنائية المركز والهامش، فالقضية، في جوهرها، هي قضية عدالة شاملة: اقتصادية، سياسية، وثقافية. فهناك مواطنون يجبرون على التخلي عن لغاتهم الأصلية لصالح العربية، وهناك جماعات تعاني من التهميش الاقتصادي والاجتماعي بحكم انتمائها الإثني أو الجغرافي. ومن هنا يصبح الصراع حول الهوية والدين والثقافة انعكاساً لمصالح طبقية وجهوية أكثر منه خلافاً فكرياً مجرداً،
تراجع صوت المثقفين:
ويشير إلى أن كل الصراعات، سواء حول الدين والدولة أو اللغة والثقافة، في جوهرها ليست خلافات فكرية، وإنما انعكاس لمصالح اقتصادية وسياسية لفئات بعينها، مستشهداً بتجربة حكم الإسلاميين التي استغلت الدين لتحقيق مصالح دنيوية بحتة، ويخلص إلى أن الحل يكمن في تحقيق العدالة الشاملة: الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بحيث يحصل جميع السودانيين على فرص متكافئة في السلطة والموارد، وهو السؤال الذي حاولت ثورة ديسمبر 2018 الإجابة عنه عبر شعار (حرية، سلام، وعدالة)، لكن هذه المطالب اصطدمت بمصالح القوى المهيمنة، وعليه، فإن الأزمة السودانية تكمن في سؤال واحد: من يحصل على ماذا، وكيف؟ فظل السودان يدور في حلقة الصراع على السلطة والموارد؟ أما عن دور المثقفين، فيرى دكتور الفاتح أن أصواتهم تراجعت كثيراً خلال الحرب، بعد أن كان لهم حضور أوضح في ثورة أكتوبر وتجارب سابقة، وما تلاها، تضاءل تأثيرهم مع تصاعد عسكرة المشهد، واليوم، لم يعد صوت المثقف مغيباً فحسب، بل أصبح متهماً بالخيانة ومعرضاً للقمع، في وقت تتسيد فيه لغة السلاح، وسط هيمنة السلاح والخطاب العسكري، بات صوت المثقف ضعيفاً ومتهماً أحياناً بالخيانة، ما أدى إلى عسكرة المشهد وتراجع دور الفكر النقدي في صناعة الوعي.(يتبع)
“من سطوة السلاح إلى قوة الكلمة؟
هل يمنح الفكر للسودان فرصة للنجاة من دورته الدموية؟(1)”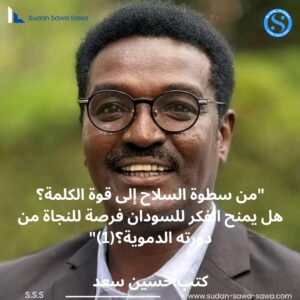
كتب:حسين سعد
سودان سوا سوا 1 أكتوبر 2025
عندما نتأمل المشهد السوداني الراهن، لا يمكننا أن نغفل عن حجم المأساة التي أفرزتها الحرب مدن مدمرة، ملايين النازحين، مجاعة طرقت الأبواب، وإنهيار شامل لمؤسسات الدولة ومع ذلك، فإن ما يفاقم هذه المأساة ليس فقط الخراب المادي والإنساني، وإنما العجز المستمر عن إنتاج بدائل فكرية قادرة على أن تضيء الطريق وسط هذا الظلام، لقد صار السلاح هو اللغة الغالبة، والخطاب العسكري هو الصوت الأعلى، بينما تراجع صوت الفكر والحوار النقدي إلى الهوامش، وكأنّ الأزمة في جوهرها صراع قوة وليس صراع رؤى، نشرالتقرير في مجلة قضايا فكرية في عددها الرابع الصادر مؤخراً، وسط هذه المأساة تتقاطع رائحة البارود مع صرخات النازحين، يطلّ سؤال قديم متجدد: لماذا نعجز عن تحويل أزماتنا إلى فرص لبناء وطن يتسع للجميع؟ لقد جرّب السودان، عبر عقود متلاحقة، كل أشكال الحلول العسكرية والسياسية التقليدية، لكن ما تزال الدائرة المفرغة تحاصرنا، إنقلابات تتبعها إتفاقيات هشة، ثم جولات دم جديدة، فالأزمة الحالية ليست مجرد صراع علي السلطة ، بل أزمة فكر لم يتجذر في الوعي الجمعي مشروع وطني جامع يجيب علي أسئلة الهوية والعدالة والسلام والحرية ، بينما يتصدّر السلاح المشهد، ويعلو خطاب الكراهية والعنصرية والانقسام في صفوف القوى المدنية والسياسية والنقابات وحتى الإعلام، يغيب الصوت الفكري العقلاني القادر على بناء جسور الحوار، وإضاءة المخارج الممكنة، فهل يمكن أن يشكل الجدل الفكري بما يحمله من قدرة علي إعادة صياغة المفاهيم وفتح الأفق ، كمدخل لاحياء مشروع السلام في السودان ؟ ولماذا غاب المثقف في لحظة تحتاج البلاد فيها إلي جرأته الاخلاقية وطاقته النقدية عن مائدة الفعل العام؟ مجلة قضايا فكرية في هذا العدد طرحت بعض الأسئلة علي عدد من المثقفين وأستاذة العلوم السياسية بالجامعات ، السؤال الجوهري هنا: لماذا يغيب البعد الفكري عن مقاربة أزمات السودان، في حين يملأ الفضاء العام خطاب الكراهية والعنصرية والتعبئة الضيقة؟ أليست جذور أزمتنا متصلة أصلاً بمسائل فكرية عميقة لم تُحسم منذ الاستقلال، مثل سؤال الهوية، العلاقة بين المركز والهامش، ثنائية العروبة والأفريقانية، وعلاقة الدين بالدولة؟ إن تهميش هذه الأسئلة أو تحويلها إلى شعارات سياسية آنية جعلها تنفجر في شكل صراعات مسلحة، وكأن التاريخ يكرر نفسه في دوامة لا تنتهي،أليست الأزمة السودانية كأزمة فكر قبل أن تكون أزمة سلطة؟ و كيف تحوّلت الخلافات الفكرية (الهوية، المركز والهامش، العروبة والأفريقانية، الدين والدولة) إلى صراعات مسلحة؟ وغياب مشروع وطني جامع كخلفية لغستمرار الأزمات؟ وماهو دور المثقفين السودانيين في لحظات التحول ؟ مقارنة بين أدوار المثقفين في أكتوبر 1964، أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2019م كيف تراجع صوت المثقف في ظل عسكرة المشهد؟
الفكر الغائب والسلام المستحيل:
لقد عرف السودان لحظات مفصلية كان فيها للمثقفين والفكر النقدي حضور قوي ومؤثر، في ثورة أكتوبر 1964 حين أعادوا تعريف معنى الحرية، وفي أبريل 1985 حين فتحوا أفق التغيير، وفي ثورة ديسمبر 2019 حين صاغوا شعارات الحرية والسلام والعدالة. غير أنّ المشهد الراهن يشهد تراجعاً حاداً في دور المثقف، الذي وجد نفسه محاصراً بين عسكرة الحياة العامة وانقسام القوى المدنية والسياسية والنقابية والإعلامية، حتى صار حضوره باهتاً في لحظة تاريخية تتطلب شجاعة فكرية مضاعفة؟ من هنا ينهض سؤال المقال: هل يمكن للجدل الفكري، بما يمتلكه من قدرة على إعادة قراءة الواقع وتفكيك أزماته، أن يفتح مسارات جديدة نحو السلام في السودان؟ أم أننا سنظل أسرى توازنات القوة العسكرية وصفقات السياسة الضيقة، نكرر ذات الأخطاء التي أطاحت بكل فرص الاستقرار منذ الاستقلال؟
سلام بلا فكرة.. وطن بلا مشروع:
أولاً :الأزمة السودانية كأزمة فكر قبل أن تكون أزمة سلطة منذ الاستقلال، ظل السودان يعيش أزمة هوية ورؤية قبل أن يعيش أزمة سلطة. فالصراع بين المركز والهامش لم يكن مجرد خلاف إداري حول توزيع الموارد، بل انعكاساً لأزمة فكرية حول معنى الدولة السودانية وحدود انتمائها: هل هي عربية خالصة أم أفريقية الجذور؟ هل هي دولة دينية أم مدنية؟ هذه الأسئلة الجوهرية، بدلاً من أن تُناقش في فضاءات فكرية مفتوحة، جرى اختزالها في صراعات سياسية ومساومات مؤقتة، ثم تحولت إلى وقود لحروب أهلية، وغياب المشروع الوطني الجامع جعل الانقسام القائم على الهوية والثقافة والدين يتغلغل في مؤسسات الدولة نفسها، فإن النتيجة كانت دولة عاجزة عن تمثيل تنوعها، وسلطة متنازعة بين قوى متضادة فكرياً وأيديولوجياً. لذلك يمكن القول إن الحرب التي يعيشها السودان اليوم ليست سوى تجلٍّ عنيف لفشل فكري ممتد عبر عقود.
ثانياً: غياب المشروع الوطني الجامع منذ لحظة الاستقلال حين ورثت النخبة السياسية دولة لم تُبنَ على تعاقد اجتماعي حقيقي. فبدلاً من مشروع قومي يُعلي قيم المواطنة والعدالة، استندت السلطة إلى أدوات الإقصاء والهيمنة، فكان طبيعياً أن تتجدد النزاعات كلما تغيّر النظام أو تبدلت التحالفات، لقد أُجهضت فرص عديدة كان يمكن أن تؤسس لمشروع وطني، مثل مؤتمر المائدة المستديرة في ستينيات القرن الماضي، أو اتفاقية نيفاشا في مطلع الألفية. غير أن غياب الرؤية الفكرية العميقة جعل هذه المحطات تتحول إلى اتفاقيات سياسية قصيرة العمر، تُرضي أطرافاً محدودة لكنها تعجز عن بناء توافق وطني شامل.(يتبع)
“سلام السودان.. حلم مؤجل ومعركة لا تُحسم بالسلاح بل بالإرادة والعدالة”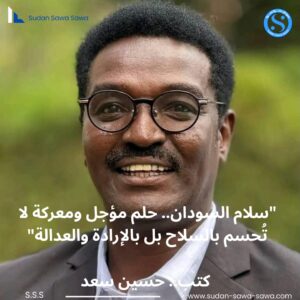
كتب.. حسين سعد
سودان سوا سوا 21 سبتمبر 2025
مع حلول اليوم العالمي للسلام،
في كل عام، يتجدد الحديث في العالم عن قيمة السلام وأهميته حيث تتوقف الشعوب والحكومات عند معاني التعايش، المصالحة، ووقف الحروب باعتبارها حجر الأساس للتنمية والعدالة والكرامة الإنسانية غير أن هذه القيم تبدو بعيدة المنال في السودان، البلد الذي أنهكته الحروب الأهلية والصراعات المسلحة والانقسامات السياسية لعقود طويلة. فبينما يرفع العالم شعارات التسامح والأمن، يعيش السودانيون واقعا مغايرا؛ واقع يتسم بغياب السلام وبتفاقم النزاعات التي امتدت من العاصمة الخرطوم إلى دارفور وكردفان والجزيرة، مهددة وحدة الدولة ومستقبلها.
واقع مثخن بالجراح..
السلام في السودان ظل طوال تاريخه الحديث أقرب إلى حلم مؤجل منه إلى واقع ملموس، حيث أُبرمت العديد من الاتفاقيات بدءاً من أديس أبابا 1972، مروراً باتفاقية السلام الشامل 2005، و اتفاقيات ابوجا والدوحة وسلام الشرق وصولا الي اتفاق جوبا 2020، لكن جميعها تعثرت أو انهارت أمام جدار الانقسامات الداخلية، وانعدام الإرادة السياسية، وضعف المؤسسات، وتدخلات القوى الإقليمية والدولية. ومع اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل 2023، دخل السودان مرحلة جديدة أكثر مأساوية، إذ تحولت الخرطوم ومدن أخرى إلى ساحات قتال مفتوحة، وانهار النسيج الاجتماعي، وتضاعفت معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا للتشريد والمجاعة والعنف.
نداء عاجل..
من جهته وجه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نداء عاجلا لوقف الحروب حول العالم، وذلك في كلمته بمناسبة إحياء اليوم الدولي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، ويحمل هذا العام شعار: “اعملوا الآن من أجل عالم يسوده السلام”.
وأكد غوتيريش أن “السلام هو ما ينشده الجميع، وهو الطريق الوحيد لإنهاء المعاناة وتحقيق التنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن الحروب المتفاقمة تمزق المجتمعات، وتزهق الأرواح، وتحرم الطفولة من براءتها، وتنتهك كرامة الإنسان”.
انتهاكات متزايدة..
وقال الأمين العام إن العالم يشهد انتهاكات متزايدة للقانون الدولي، وأعدادا غير مسبوقة من النازحين الذين لا يطلبون سوى العيش في سلام، محذرا من أن آثار الصراعات تتجاوز حدود الدول لتطال الأمن والاستقرار العالميين، داعيا الى إسكات أصوات الأسلحة، وبناء الجسور، وتحقيق الاستقرار والازدهار.
كما شدد على أهمية الترابط الوثيق بين السلام والتنمية المستدامة، موضحا أن تسعة من أصل عشرة بلدان تعاني من أكبر التحديات التنموية ترزح تحت وطأة النزاعات.
تحديات عديدة..
ونرى ان التحديات التي تواجه السلام في السودان تتمثل في;
1. استمرار الحرب وتمدد خطاب الكراهية والعنصرية وانقسام القوى السياسية والنقابات وتكاثر المجموعات المسلحة . حيث أدى غياب رؤية وطنية موحدة إلى إطالة أمد الحرب، حيث تتنازع قوى متعددة على الشرعية والسلطة، بينما يغيب مشروع جامع يمكن أن يوحد السودانيين حول قيم الحرية والسلام والعدالة.
2. تسييس العملية السلمية:
كل محاولات الوساطة، سواء الإقليمية أو الدولية، اصطدمت بأجندات ضيقة ومصالح متناقضة، ما جعل السلام رهينة للتوازنات السياسية والعسكرية بدلاً من أن يكون استجابة لمعاناة الشعب.
3. تفاقم الأوضاع الإنسانية:
ملايين النازحين واللاجئين في الداخل والخارج يشكلون تحدياً أمام أي عملية سلمية، لأن إعادة إعمار ما دمرته الحرب يتطلب استقراراً أمنياً وإرادة سياسية قوية، وهو ما لا يتوفر حتى الآن.
4. الإفلات من العقاب وغياب العدالة الانتقالية:
استمرار ارتكاب الانتهاكات دون مساءلة يضعف فرص المصالحة ويكرس ثقافة العنف، حيث لا يمكن بناء سلام دائم من دون عدالة شاملة تعيد للضحايا حقوقهم وتمنع تكرار المآسي.
5. التدخلات الإقليمية والدولية:
السودان أصبح ساحة صراع بالوكالة، حيث تلعب قوى خارجية أدواراً متناقضة تزيد من تعقيد الأزمة، وتجعل مسار السلام أكثر هشاشة.
6. التدهور الاقتصادي وانهيار الدولة:
غياب الخدمات الأساسية وانتشار الفقر والمجاعة يعمّقان من مشاعر الغضب والاحتقان، ما يصعّب مهمة تثبيت أي اتفاق سلام دون معالجة جذرية للأوضاع المعيشية. وانهيار المشاريع الزراعية ونهب الثروة الحيوانية والصمغ العربي وتهريب الذهب واستخدامه في الحرب
الخاتمة:
في اليوم العالمي للسلام، يقف السودان في مفترق طرق تاريخي: إما أن يواصل الانحدار نحو التفكك والفوضى، أو أن يلتقط قادته ومجتمعه المدني اللحظة ليضعوا أسس سلام حقيقي ومستدام. التحديات جسيمة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة، ووضعت معاناة المدنيين فوق المصالح الضيقة. فالسلام في السودان لن يُفرض من الخارج، بل ينبع من الداخل عبر مصالحة وطنية شاملة، وعدالة انتقالية، ورؤية جديدة لبناء الدولة تقوم على المواطنة لا على الانتماءات الضيقة.
إن غياب السلام في السودان ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة لصراعات يمكن تجاوزها إذا اجتمعت الإرادة والرغبة في التغيير. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج السودانيون إلى أن يجعلوا من قيم اليوم العالمي للسلام واقعاً ملموساً على أرضهم، حتى تتحول دماء الحرب إلى بذور حياة، وأنين النزوح إلى أناشيد أمل لمستقبل مختلف.
“كارثة الانهيار الأرضي في ترسين بجبل مرة: بين الطبيعة والتاريخ المنسي”
بقلم : سيف الدين ادم احمد (ديفيد)
سودان سوا سوا – 5 سبتمبر 2025
شهدت قرية ترسين الواقعة في منطقة دار أوموا الإدارية – شرتاوية إبراهيم سليمان حسب الله، غرب منطقة سوني والمجاورة لقرى دولينق روا، تركو، رانق روا، ومن الناحية الغربية لوقي، كارثة طبيعية مروعة تمثلت في انهيار أرضي جبلي أدى إلى اختفاء قرية بكاملها تحت الركام. كما جرفت السيول المنحدرة من المرتفعات العديد من السكان إلى مناطق بعيدة، مخلفةً ضحايا في المناطق المنكوبة عند منحدرات الأراضي الجبلية .
جبل مرة ، جغرافيا محفوفة بالمخاطر حيث تقع منطقة ترسين ضمن سلسلة جبال مرة ، وهي أرض بركانية التكوين ، ما يجعلها أكثر عرضة للإنهيارات الأرضية والإنجرافات خلال مواسم الأمطار الغزيرة ، هذه الطبيعة الجغرافية القاسية تتقاطع مع هشاشة البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية ، ما يزيد من حجم الكارثة كلما وقعت .
عزيزي القارء دعوني اعود بك الي الوراء حيث ذاكرة الحرب والكوارث البشرية في المنطقة ، ان المأساة الحالية تأتي في سياق تاريخ طويل من المعاناة التي شهدها جبل مرة رقعه جغرافية خصبة لأنشاء ثورة مسلحة ، تحت مسمى حركة جيش تحرير السودان في العام ٢٠٠٢م و في عام 2016، تعرضت المنطقة للإستهداف مباشر من حكومة المؤتمر الوطني، عبر ضربات جوية وقصف بالأسلحة الكيماوية، ما أسفر عن خسائر بشرية وبيئية جسيمة .
طوال تاريخها، عانت المنطقة من تهميش وعزلة خدمية سواء في فترة الاستعمار أو الحكومات الوطنية التي أعقبته، حيث افتقرت إلى الطرق، والمرافق الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية الأخرى .
يعود بنا أبعاد الكارثة الراهنة ، ما حدث في ترسين لا يمكن اعتباره مجرد كارثة طبيعية معزولة، بل هو نتيجة تضافر عوامل طبيعية وبشرية مثل البراكين والانحدارات الحادة مع غياب البنية التحتية ووسائل الإنقاذ ، إرث الصراع المسلح الذي ترك المنطقة معزولة ومنهكة .
يحتاج الواقع الي استجابة شاملة في هذه المأساة التي فرضها الحاجة إلى :
1. تدخل إنساني عاجل لإنقاذ الناجين وتقديم الغذاء والمأوى والخدمات الطبية.
2. إعادة تقييم المخاطر البيئية في جبل مرة، مع وضع خطط وقائية للكوارث الطبيعية.
3. مساءلة سياسية وتاريخية حول التهميش المتواصل الذي جعل سكان جبل مرة الأكثر عرضة للهشاشة .
عزيزي القارء اعلم جيدًا بان كارثة ترسين تجسد تقاطع غضب الطبيعة مع الإهمال السياسي والتاريخي ، فهي تذكير صارخ بأن سكان جبل مرة يعيشون بين فكي الكوارث الطبيعية والحروب، وأن إنقاذ حياتهم يتطلب أكثر من استجابة طارئة؛ بل رؤية شاملة تعترف بتاريخ التهميش وتعيد الاعتبار لهذه المنطقة المنسية.
المأساة التي هزّت جبل مرة
ترسين :تحت الركام: كارثة تكشف إهمالاً سياسياً وحقوقياً
سودان سوا سوا – 5 سبتمبر 2025م
كتب:حسين سعد
استيقظ سكان قرية ترسين الواقعة في سفوح جبل مرة بدارفور على فاجعة مروعة؛ إذ أدى انزلاق أرضي ضخم إلى طمر معظم القرية، وأسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص وفق تقديرات محلية أولية، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين تحت الركام والطمي المأساة لم تكن مجرد حادث طبيعي عابر، بل كشفت عن عمق الإهمال والتهميش الذي يعيشه سكان الهامش في السودان، حادثة الانزلاق الأرضي في قرية ترسين ، لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد كارثة طبيعية. بل هي تجسيد عميق لواقع الإهمال المزمن والتهميش السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه مناطق دارفور وجبال مرة منذ عقود طويلة، الحادثة المآسوية لم ينج منها سوى رجل واحد، ليصبح الشاهد الوحيد على رحيل أسرته وجيرانه وأبناء قريته، ووجدت الحادثة تضامنا وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن صدمتهم وحزنهم الشديد، مشيرين إلى أن ما حصل في قرية ترسين بطمرها بالكامل يعتبر من أندر وأسوأ الكوارث في تاريخ السودان الحديث.
الحق في الحياة والمساواة والتنمية:
الدولة ملزمة بحماية حياة مواطنيها من المخاطر، لكن غياب خطط الطوارئ والبنية التحتية للإنقاذ يمثل إخلالاً فادحاً، وكذلك الحق في المساواة: التباين بين تعامل السلطات مع الكوارث في المركز والهامش يعكس تمييزاً واضحاً ضد سكان دارفور، والحق في التنمية: استمرار غياب مشاريع التنمية المستدامة يزيد من هشاشة هذه المناطق ويجعلها عرضة للموت الجماعي عند وقوع الكوارث، أما البعد السياسي: التهميش والإهمال المتراكم: منذ الاستقلال، ظلت دارفور ومناطق الهامش خارج دائرة الأولويات التنموية، بينما تركزت الموارد في الخرطوم. الاستجابة البطيئة في كارثة ترسين تكشف غياب الإرادة السياسية لوضع معاناة سكان الهامش ضمن الأولويات الوطنية، وهذا يوضح غياب الدولة وضعف الاستجابة الرسمية، حيث لم تصل السلطات بفرق إنقاذ أو مساعدات عاجلة في الساعات الأولى، ما زاد من حجم المأساة. وبدلاً من أن تكون الدولة في موقع حماية المواطنين، بدت غائبة تماماً، ما يعكس منظومة الحكم في إدارة الأزمات.
أبعاد إنسانية وحقوقية:
تُظهر الحادثة هشاشة البنية التحتية في مناطق جبل مرة، وانعدام أنظمة الإنذار المبكر ووسائل الحماية المدنية، ما يجعل حياة آلاف المواطنين عرضة للخطر عند وقوع الكوارث الطبيعية، كما أن غياب الدولة وضعف تدخلها مؤشر الي ان الاهمال الرسمي وسوء التخطيط يزيد من حجم الكوارث الطبيعية ويحولها مآسٍ إنسانية شاملة، فالحق في الحياة والأمن وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الدولة ملزمة بضمان حق مواطنيها في الحياة، وحمايتهم من المخاطر، بما في ذلك الكوارث الطبيعية. غياب خطط الطوارئ، وانعدام البنية التحتية للإنقاذ، يعكس إخلالاً واضحاً بمسؤولية الدولة في حماية المدنيين، وكذلك الحق في المساواة وعدم التمييز ما حدث في ترسين يعكس تمييزاً جغرافياً ومناطقياً صارخاً.، فبينما تحظى العاصمة الخرطوم والمدن المركزية بخدمات طوارئ أسرع نسبياً، تبقى مناطق جبل مرة معزولة، دون طرق معبدة، أو مراكز إنذار مبكر، أو بنية صحية كافية، ما يرسّخ إحساس السكان بأنهم مواطنون من درجة ثانية، الحق في التنمية استمرار حرمان سكان دارفور من التنمية المستدامة – سواء في البنية التحتية أو الخدمات الأساسية – يجعلهم أكثر عرضة للكوارث. غياب المشاريع البيئية لإدارة المياه والأراضي، وترك القرى في سفوح الجبال دون حماية، هو انتهاك لحقهم في التنمية الذي تكفله المواثيق الدولية والإفريقية لحقوق الإنسان.
البعد السياسي:
إرث التهميش التاريخي منذ الاستقلال، عانت دارفور من سياسات مركزية جعلت الأولوية للاستثمار والخدمات في الخرطوم والمدن الكبرى، بينما ظلت الأقاليم الهامشية، ومنها جبل مرة، في حالة عزلة وفقر، هذا التهميش البنيوي خلق هشاشة مضاعفة أمام الكوارث، غياب الإرادة السياسية بطء استجابة السلطات في الكارثة، وغياب زيارات رسمية أو خطط عاجلة في الساعات الأولى، يكشف ضعف الإرادة السياسية للاعتراف بمعاناة سكان الهامش. وهو امتداد لنهج اعتاد التعامل مع هذه المناطق كأطراف مهمشة لا تشكّل أولوية وطنية، أما البعد الأمني مقابل الإنساني بينما تُصرف المليارات على تسليح الجيوش والمليشيات في الصراع الدائر بالبلاد، لا تخصص موارد كافية لإنشاء وحدات دفاع مدني أو مراكز صحية أو شبكات طرق في المناطق المنكوبة. المفارقة المؤلمة أن الدولة قادرة على الحرب، عاجزة عن حماية الحياة
المجتمع المدني بين الرصد والنجدة:
منظمات المجتمع المدني بعضها كانت حاضرة عبر إطلاق نداءات استغاثة، وتقديم مساعدات محدودة رغم ضعف إمكاناتها، كما عملت على توثيق الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن الإهمال الرسمي، فالمنظمات الدولية مدعوة للنظر إلى الكارثة باعتبارها جزءاً من أزمة حقوق إنسان مزمنة في السودان، لا مجرد حادث طبيعي. الدعم الإنساني العاجل مطلوب، لكن الأهم هو الضغط لضمان التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه سكان الهامش، الانزلاق الأرضي قد يكون نتاج الطبيعة، لكن تحوله إلى مأساة جماعية بهذا الحجم يعكس أزمة سياسية وحقوقية عميقة. الطبيعة كشفت هشاشة البنية التحتية، والسياسة عرّت غياب العدالة والمساواة، هذا يدفعنا الي تقديم توصيات عملية للحكومة والمجتمع المدني والداعمين الدوليين بالنسبة للحكومة: يجب وضع خطة وطنية لإدارة الكوارث، إنشاء مراكز إنذار مبكر وإيواء، تحقيق شفاف ومحاسبة المقصرين، اما للمجتمع المدني: يجب تعزيز شبكات الإنذار المجتمعي، تدريب السكان على خطط الطوارئ، وتوثيق الإهمال والتمييز، أخيرا للمجتمع الدولي: دعم عاجل للناجين، تمويل برامج طويلة الأجل للتكيف مع الكوارث، والضغط على الحكومة لتوزيع الموارد بعدالة.
ترسين جرس إنذار لوطن يواجه الهشاشة:
ما حدث يتطلب من الحكومة وضع خطة وطنية عاجلة لإدارة الكوارث تعتمد على معايير حقوق الإنسان
إنشاء مراكز إنذار مبكر ومراكز إيواء في مناطق الهشاشة البيئية مثل جبل مرة.
توفير البنية التحتية الأساسية (طرق، جسور، شبكات مياه وصحة) لتمكين التدخل السريع في أوقات الكوارث.
إجراء تحقيق شفاف ومستقل حول أوجه القصور في الاستجابة الرسمية للكارثة، وضمان محاسبة الجهات المقصرة.
دمج قضايا البيئة وحماية السكان من المخاطر الطبيعية في الخطط التنموية الوطنية، أما التوصيات الخاصة بالمجتمع المدني فهي تشمل
تعزيز شبكات الرصد المجتمعي والإنذار المبكر عبر المجتمعات المحلية.
تدريب المواطنين على خطط الطوارئ والإخلاء المجتمعي في حالات الانزلاقات والسيول
توثيق الانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالإهمال والتهميش ورفعها للجهات الوطنية والدولية، وأخير توصيات المجتمع الدولي يجب
تقديم دعم إنساني عاجل للناجين، يشمل الغذاء والدواء والمأوى.
الضغط على الحكومة السودانية للوفاء بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين وتوزيع الموارد بعدالة.
تمويل برامج طويلة الأجل لبناء القدرة على التكيف مع الكوارث الطبيعية في دارفور والمناطق الهامشية
الخاتمة:
كارثة ترسين بجبل مرة ليست حادثة طبيعية فقط، بل مرآة لسياسات الإهمال والتهميش التي يدفع ثمنها الأبرياء. إذا لم تتحرك الدولة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بخطوات جادة، فإن ترسين لن تكون الأخيرة، بل مجرد فصل جديد في مسلسل المآسي التي تهدد حياة المواطنين في السودان، هذه الحادثة ليست مجرد حادثة طبيعية، بل هي جرس إنذار جديد يذكّر بضرورة وضع خطة وطنية لإدارة الكوارث قائمة على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، تضمن حق المواطنين في الحياة الآمنة والحماية من المخاطر، وتضع حداً لسياسات الإهمال والتجاهل التي تدفع المدنيين دائماً ثمنه
قرارات الإحالة للتقاعد بين الروتين والتضليل
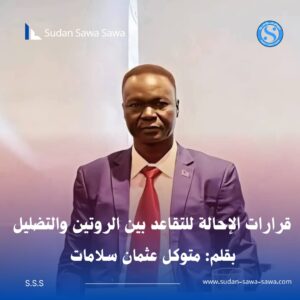
سودان سوا سوا-30 أغسطس 2025م
بقلم : متوكل عثمان سلامات
أصدرقائد الإنقلاب الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان، قرارات عسكرية بتاريخ 17 أغسطس 2025م بترقية وإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد وإخضاع القوات المساندة لقانون القوات المسلحة. وقد لقيت هذه الخطوة إشادة من بعض القوى التي تدعي المعارضة والمرتبطة بالدولة القديمة وجيشها الإسلاموي الذي ظل حارساً لإمتيازات النخب في السودان، بينما وصفها معظم المحللين بأنها محاولة لإبعاد الإسلاميين من الجيش. وسارع آخرون إلى ربط القرارات بمواقف إقليمية ودولية، فإستدل بعضهم بوهمة إعتراض كتائب البراء بن مالك وتشكيلها متحركاً عسكرياً بقيادة الفريق معاش/ نصر الدين عبدالفتاح محمد سليم أحد الضباط المحالين، وربط آخرون القرارات بلقاء البرهان مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيد/ مسعد بولس في سويسرا، فيما ذهب فريق ثالث إلى قراءتها في سياق الموقف المصري من جماعة الإخوان المسلمين. وهناك من أوغل أكثر في التفسير فرأى أن الخطوة تعكس صراعات شخصية بين البرهان وكل من ياسر العطا وشمس الدين كباشي، إلى جانب تصفية حسابات مع بعض أجنحة الإسلاميين.
في ظلهذا المشهد السياسي والعسكري المعقد، تظل قرارات الترقي والإحالة للتقاعد في الجيش السوداني موضع تفسيرات وتحليلات متباينة، تتراوح بين إعتبارها إجراءات روتينية وبين تصويرها على أنها معارك مصيرية ضد الإسلاميين أو لصالحهم. القرارات الأخيرة لقائد الإنقلاب الفريق أول ركن/ عبدالفتاح البرهان لم تكن إستثناء من هذه الديناميكية المعتادة.
ما لفت إنتباهي في التعليقات على قرارات البرهان الأخيرة هو كيف يتم إستغلالها من قبل مختلف الأطراف لتخدم روايات مضللة. فمن يصفها بأنها ضربة للإسلاميين يتجاهل حقيقة أساسية، وهي أن البنية المؤسسية للجيش السوداني تشكلت على مدى عقود تحت سيطرة التيار الإسلاموعروبي، ولا يمكن تغيير هذه الحقيقة بقرارات فردية لترقية أو إحالة بعض الضباط للتقاعد، خاصة إذا كانت هذه القرارات تقنن لمزيد من الإسلاميين المتطرفين داخل القوات المسلحة بمسمى (القوات المساندة)، (وليس هناك ما يمنع هؤلاء الضباط المعاشيين من العودة للقوات المسلحة من بوابة القوات المساندة؟)، او خلط الأوراق بحماية هذه المليشيات الإرهابية بمظلة القوات المسلحة حتى لا تتساقط عليها العقوبات الدولية.
كما أن الربط التلقائي بين هذه القرارات واللقاءات الدولية أو المواقف الإقليمية يفتقر إلى الحجة والدليل ويعكس نظرة إختزالية لتعقيدات المشهد السوداني. فالعملية السياسية والعسكرية في السودان لها ديناميكياتها الداخلية التي لا يمكن تفسيرها فقط من خلال تأثيرات خارجية غير معلنة.
غير أن هذه التفسيرات على إختلاف إتجاهاتها تعكس في جوهرها إعادة إنتاج للوهم وتضليل للرأي العام السوداني. فالواقع يشير بوضوح إلى أن الجيش السوداني، بمؤسساته ومليشياته وإمتداداته السياسية، ظل ولا يزال خاضعاً لهيمنة الإسلاميين منذ عقود، وأن أي قرارات إحالة للتقاعد ليست سوى إجراءات روتينية تُستخدم من حين لآخر كأداة لتجميل صورة المؤسسة العسكرية وإيهام الشعوب السودانية والمجتمع الإقليمي والدولي بأنها في طريقها لتطهير صفوفها. الحقيقة أن تصوير الجيش وكأنه مزيج من إسلاميين وشرفاء ليس سوى خدعة سياسية تُراد بها المراوغة وإبقاء بنية الدولة الأمنية والعسكرية كما هي.
ممارسة إحالة الضباط للتقاعد لأسباب سياسية او روتينية بنكهة تصفية الإسلاميين ليست جديدة في السودان. فقد سبق أن إتخذ الرئيس المخلوع عمر البشير ومن سبقه قرارات مشابهة بنفس الأسلوب لإدارة التوازنات داخل المؤسسة العسكرية تحت مبررات تجديد الدماء أو إبعاد الإسلاميين. ما يحدث اليوم من قبل البرهان هو إستمرار لنفس النهج في إدارة المؤسسة العسكرية وبذات التبريرات ، مما يؤكد أن الأمر لا يعدو أن يكون إستمرارية للنهج القديم في إستخدام القرارات العسكرية كغطاء سياسي، وليس تغييراً جذرياً في المنهجية. أما الإدعاءات بوجود صراعات داخلية بين البرهان وأطراف أخرى، فغالباً ما تخدم أغراضاً سياسية لتقديم صورة مشوهة عن المشهد الحقيقي. فالمؤسسة العسكرية في السودان، مثل غيرها من المؤسسات العميقة، تحافظ على تماسكها الداخلي أمام الرأي العام، حتى عندما تكون هناك خلافات داخلية.
الحقيقة الجوهرية التي يتم تجاهلها عمداً في هذه التحليلات والقراءات هي أن التغيير الحقيقي في المؤسسة العسكرية والخلاص من هيمنة الإسلاميين على المنظومة العسكرية والأمنية لا يتحقق عبر إحالات شكلية او قرارات فردية لترقية أو إحالة ضباط للتقاعد، بل من خلال مشروع تأسيسي لجيش مهني جديد، يؤسس على عقيدة عسكرية جديدة، مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو إنتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي التعددي اللامركزي، وضمان إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري المرتكز على المبادئ فوق الدستورية، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الإقتصادي او حماية إمتيازات النخب.
إن الإنسياق وإستمرار الترويج لرواية تصفية الإسلاميين عبر قرارات روتينية يشكل إهانة للوعي المتراكم للشعوب السودانية، ويفضح ويعري محاولات إستمرار إستخدام نفس أدوات التضليل السياسي والإستخباراتي التي إستخدمتها الأنظمة السابقة.
فما يجري الآن، فهو مجرد إعادة تدوير لنظام متهالك يحاول أن يبرر وجوده عبر خلق سرديات زائفة عن الإصلاح والتطهير، بينما الحقيقة أن البنية العسكرية والأمنية برمتها لا تزال قائمة على ذات الأسس التي زرعها الإسلاموعروبيين منذ خروج المستعمر.
الشعوب السودانية تستحق تحليلاً أكثر مصداقية ووعياً أعميق لتعقيدات واقعها، بعيداً عن التفسيرات المبسطة والروايات المضللة. فالتغيير الحقيقي يحتاج إلى أكثر من مجرد ترقيات أو إحالات للتقاعد، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية ووطنية تخدم مصلحة جميع السودانيات والسودانيين.
“أزمة الإرادة السياسية : تكمن في مواجهة أسئلة جذور الأزمة السودانية ”
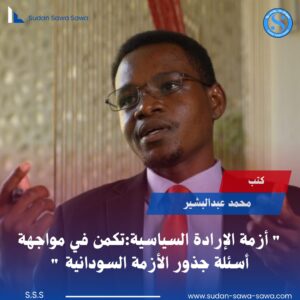
كتب : محمد عبدالبشير
سودان سوا سوا – 27يوليو 2025م
منذ عام 1956م ، ظل سؤال “بناء الدولة الوطنية” معلقًا دون إجابة حقيقية واقعية ، يتعثر في مسارات صراعات الساسة السودانية، وحركات الكفاح المسلحة، وغيرها من الأجسام، وانعدام التوافق حول مشروع وطني جامع يُنهي حالة الهشاشة المزمنة في بنية الدولة منذ تاريخ السودان. واليوم، وسط الانقسام الحاد بين القوى المتنازعة على الشرعية، تظهر الأزمة السياسية بشكل أكثر وضوحًا، مع غياب رؤية موحدة لمستقبل البلاد.
في هذا السياق، تقف البلاد أمام مشهد سياسي معقّد يتمثل في صراع بين جهتين تدّعي كل منهما حق “الشرعية”. ومن جهة أخرى ،هناك قوى ترى في نفسها أداة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي السوداني، ومن جهة أخرى، تُصر جهة على أحقيتها بإدارة الدولة كسلطة أمر واقع. وبين هذين المشروعين، يتوارى المشروع الوطني الحقيقي، وتحول السودان إلى ساحة تجاذب محلية ، وإقليمية ، ودولية، لا ساحة بناء.
ما هو مشروع بناء الدولة في السودان؟
مشروع بناء الدولة الوطنية، في السياق السوداني، لا يعني فقط استعادة مؤسسات الدولة، بل يتطلب عملية شاملة لإعادة تعريف العقد الاجتماعي، التي تتسق مع السياق السوداني ،الإجتماعي، والسياسي، والإقتصادي تشمل:
1. صياغة عقد اجتماعي جديد يعترف بتنوع السودان الثقافي والعرقي والديني ويؤسس لوحدة قائمة على دولة المواطنة المتساوية.
2. بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة تعبّر عن تطلعات المواطنين وتخضع للمساءلة الشعبية.
3. تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية ومحاكمة مرتكبي الجرائم ،لضمان عدم الإفلات من العقاب .
4. الانتقال من حالة اللادولة إلى دولة الشعب، حيث تكون الإرادة الشعبية محور القرار السياسي.
إلا أن هذه المرتكزات ظلت غائبة عن خطاب وممارسات العمل السياسي طيلت الفترات السابقة ، التي أدارت البلاد غالبًا بمنطق الغنائم وتوزيع السلطة، لا بمنطق البناء والتأسيس:
مأزق السياسية السودانية:هي غياب الإرادة والرؤية الوطنية تكمن المعضلة السودانية في عدم توفر إرادة سياسية حقيقية لدى معظم الساسة السودانية ، وجزءاً من حركات الكفاح المسلحة– سواء كانت مدنية أو عسكرية – لصياغة مشروع وطني يتجاوز الحسابات الآنية. إذ غالبًا ما:
تُدار الدولة بمنطق الغنائم وليس بمنطق المواطنة المتساوية على أساس الحقوق والواجبات.
تُقدّم الانتماءات الأيديولوجية أو الجهوية على المصلحة العامة.
تُعاد إنتاج نفس أدوات الفشل، من تحالفات هشة إلى ارتهان إقليمي ودولي.
في الوقت الذي يتوق فيه المواطن السوداني إلى الحد الأدنى من الأمن والخدمات، تستمر النخب في خوض صراعات سلطوية لا تقدم حلولًا حقيقية، بل تعمق الانقسامات القائمة.
الطريق نحو مشروع وطني جامع:
للخروج من هذا المأزق، لا بد من خطوات حاسمة تضع السودان على مسار جديد، أبرزها:
1. وقف الحرب فورًا وبدء حوار سوداني سوداني، عبر مخاطبة جذور الأزمة السودانية عبر مشاركة شامل يضم كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والمسلحين، بمعايير تتفق عليها.
2. تكوين آلية وطنية مستقلة لإدارة المرحلة الانتقالية، لا تخضع للهيمنة العسكرية أو التدخلات الخارجية.
3. وضع أسس جديدة للمواطنة تقوم على الحقوق الدستورية لا على الانتماءات الجهوية أو العرقية.
4. تمكين الشباب والنساء والمجتمعات المحلية للمشاركة في صنع القرار وصياغة المستقبل.
خاتمة: الدولة لا تُبنى بالشعارات بل بالمؤسسات والرؤية:
إن أزمة السودان الحالية تتجاوز الحرب والصراع على السلطة؛ فهي أزمة مشروع، ورؤية، وإرادة. فلا جدوى من رفع شعارات “الشرعية” أو “التأسيس” ما لم تُقرن بإجراءات عملية تُعيد بناء الدولة من القاعدة، عبر إشراك الشعب السوداني نفسه، الذي دفع ثمن الانقسامات والحروب لعقود، لكنه لا يزال يمتلك القدرة على تجاوزها إذا ما أُتيحت له الفرصة.
أطفال مناطق العمليات الحربية في السودان … ضحايا القهر المنسيون

سودان سواسوا – 22يوليو 2025م
كتب : متوكل عثمان سلامات
تناقلت وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية مؤخراً نبأ إعتقال السلطات الأمنية والمخابراتية السودانية للطفلة والتلميذة إمتثال سامي، بمدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة، بتاريخ 17 يوليو 2025م، على خلفية قيامها بتوثيق مشهد صفوف المواطنين المتراصين للحصول على “الخبز/ رغيف”. حادثة كهذه، رغم بساطتها في الظاهر، تشكل إمتداداً لسلسلة طويلة من الإنتهاكات الجسيمة التي مارستها الدولة السودانية، تاريخياً وحديثاً، بحق الأطفال في مناطق النزاع المسلح، خصوصاً في الهامش السوداني.
لقد أولى المجتمع الدولي أهمية قصوى لحماية حقوق الطفل، منذ إعلان جنيف لعام 1924، مروراً بإعلان حقوق الطفل عام 1959، ووصولاً إلى إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م، وما تبعها من بروتوكولات واتفاقيات ملحقة، مثل الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والنزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وغيرها من الأدوات القانونية التي شكلت إطاراً ملزماً لحماية الطفل وحقوقه الأساسية في الحياة والكرامة والتعليم والصحة والغذاء والمأوى والأمن.
تنص المادة الأولى من إتفاقية حقوق الطفل على أن “الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”، ما يمنح الاتفاقية قدراً من المرونة القانونية لمراعاة السياقات المختلفة. ومع ذلك، فإن أطفال مناطق النزاع في السودان – وهم بالملايين – لم تشملهم الحماية المقررة في هذه الإتفاقيات، وظلوا خارج إحصاءات وإهتمامات المؤسسات الرسمية والدولية.
طفل مناطق الحروب في السودان … الوجه القاسي للكارثة المستمرة:
عقب إندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تفاقمت معاناة الأطفال في السودان إلى مستويات كارثية، حيث بات ملايين منهم في حالة نزوح دائم، بلا تعليم، وبلا رعاية صحية، وبلا أمن غذائي بفعل المعوقات التي تضعها سلطات بورتسودان. وفي تصريح خطير لرئيسة منظمة اليونيسف في السودان، السيدة/ مانديب أوبراين، حذّرت من أنّ إستمرار الحرب سيؤدي إلى “كارثة جيل كامل”، مؤكدة أن (24) مليون طفل سوداني في خطر، فيما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن (3.4) مليون طفل دون سن الخامسة معرضون للإصابة بالأمراض الوبائية.
لكن هذه الأزمة ليست بنت الحرب الأخيرة فقط، بل تعكس إستمرارية لنهج الدولة السودانية تجاه أطفال المناطق المهمشة منذ إندلاع الحرب في سنة 1983م. الأطفال في جبال النوبة، والنيل الأزرق، ودارفور، كانوا وما زالوا وقوداً لحروب لم يصنعوها، وضحايا لتجاهل رسمي وإقليمي ودولي متواصل.
في الوقت الذي رفضت فيه السلطة غير الشرعية في بورتسودان إعلان حالة المجاعة، أعلن السكرتير الأول للسلطة المدنية للسودان الجديد، الرفيق/ أرنو نقوتلو لودي بتاريخ 13 أغسطس 2024م، حالة المجاعة رسمياً في إقليمي جنوب كردفان/ جبال النوبة والفونج الجديدة، مؤكداً في تعميم صحفي بتاريخ 26 سبتمبر 2024م أن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، من ضمنهم (768,306) نازح، يواجهون خطر الموت نتيجة إنعدام الإمدادات الأساسية. كما أشار إلى أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في إقليم جنوب كردفان/ جبال النوبة بلغ (52,479) حالة، ووفاة (416) شخصاً بسبب الجوع في فترة وجيزة.
وفي السياق ذاته، أورد الحاج عوض أحمد، المدير العام للصحة بإقليم الفونج الجديدة، أن الإقليم يشهد تفشياً لأمراض الملاريا وفقر الدم والإجهاض وسط النساء، مع تسجيل أكثر من خمس حالات سوء تغذية يومياً، غالبيتهم من الأطفال، وإرتفاع عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة إلى ثماني حالات يومياً.
إبادة ممنهجة وتغييب عدالة:
لا تقتصر الإنتهاكات على التقصير في الحماية، بل تتعداها إلى إستهداف مباشر للأطفال في مناطق الحروب، سواء في أوطانهم الأصلية أو في مخيمات النزوح داخل المدن السودانية. ففي حادثة مفجعة، أقدمت القوات النظامية ومليشياتها على إحراق طفلين في ولاية الجزيرة، على خلفية عرقهما وإثنيتهما، وهو ما يؤكد البعد العنصري والإقصائي العميق الذي يحكم نظرة المركز إلى أبناء الهامش.
أطفال مناطق الحرب في السودان محرومون من حقهم في الرعاية، لا لذنب إرتكبوه، بل لأنهم ينتمون إلى مجتمعات ترى فيها الدولة تهديداً وجودياً لهويتها الثقافية والدينية والإثنية. هم ضحايا الاستبداد المزدوج المتمثل في قهر الدولة المركزي، وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها المحكمة الإفريقية لحقوق الطفل، التي وعدت منذ 2018م بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى جبال النوبة ولم تفِ بذلك الوعد حتى اللحظة.
الجوهر السياسي للصراع وحقوق الأطفال:
إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها أطفال السودان، خصوصاً في مناطق الحرب، ليست محض مآسي عارضة أو إنتهاكات فردية، بل هي نتاج لصراع بنيوي وجذري، يرتبط بطبيعة الدولة السودانية منذ خروج المستعمر، التي تشكّلت على أسس مركزية إسلاموعروبية، أقصت الأغلبية الإفريقية في الهامش ثقافياً واقتصادياً وسياسياً. أطفال مناطق الحرب هم “الآخر” الذي ظل النظام المركزي يخشاه ويعمل على تهميشه وإبادته، بدءاً بالإبادة الثقافية، وانتهاءً بالإبادة الحسية.
ولعلّ إستمرار مطالبة المحكمة الجنائية الدولية برموز النظام السابق، الهاربين من العدالة، دليل حي على أن جرائم الحرب وإنتهاكات حقوق الإنسان بحق الأطفال والمواطنين في السودان، لم تكن عشوائية بل منهجية ومدروسة.
نحو حل سياسي شامل يضع الأطفال أولاً:
إن التعامل مع أوضاع الأطفال في مناطق العمليات الحربية لا يمكن أن يختزل في إدخال بعض المساعدات الطارئة أو إقامة مخيمات تغذية مؤقتة، بل يتطلب الاعتراف بأن الحل الجذري يكمن في التحول السياسي العادل. وعلى المؤسسات الإقليمية والدولية أن تدرك أن المسألة سياسية بامتياز، وأن الإنصاف الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال معالجة جذور الأزمة، وإنهاء التمييز والإقصاء، وبناء دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تحترم التنوع وتضمن الحقوق لجميع أطفال السودان بلا استثناء.
إننا أمام لحظة تاريخية تقتضي الإنحياز للضحايا، والضغط نحو تأسيس جديد وحقيقي لدولة سودانية علمانية ديمقراطية حديثة عادلة، تحترم حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق الطفل، فالأطفال ليسوا فقط ضحايا للصراع، بل هم عنوان مستقبل ذلك الصراع.
عندما تصبح السلطة غنيمة ؟
من يُدير الدولة؟ ومن يملك السلطة والثروة؟
سودان سواسوا – 16 يوليو 2025م
تحليل:حسين سعد
تعتبر المحاصصة السياسية من أبرز الآليات التي ظهرت في البلدان ذات البنية الإجتماعية المعقدة، خاصة في الدول الخارجة من نزاعات أو مراحل إنتقالية، حيث تُعتمد كوسيلة لتوزيع السلطة والثروة بين مكوّنات مجتمعية مختلفة بهدف تحقيق التوازن والإستقرار السياسي، في الحالة السودانية، برزت المحاصصة كأداة رئيسية في إدارة المرحلة الانتقالية وما بعدها، لكنها سرعان ما تحوّلت من آلية (توافق وطني) إلى وسيلة لإعادة إنتاج السلطة على أسس جهوية، قبلية وطائفية، تُغذّيها مصالح ضيقة وتوازنات هشة، لقد لعبت النخب المثقفة – أو من يُفترض أن تكون كذلك – دورًا معقّدًا في هذا السياق، حيث إنقسمت بين من ساهم في ترسيخ هذا النمط كجزء من صفقة سياسية أو نفوذ شخصي، وبين من إلتزم الصمت أو مارس خطابًا نقديًّا لم يرقَ إلى مستوى الفعل السياسي المقاوم، في المقابل، مثّلت الطائفية – بشقيها السياسي والديني – رافعة خطيرة لتكريس ثقافة الولاء دون الكفاءة، وإعادة إنتاج بنية الدولة على أساس إنقسامي يُضعف المؤسسات ، من خلال هذه السلسلة نحاول تحليل العلاقة بين المحاصصة كنظام لتقاسم السلطة والثروة في السودان،؟ وكيف ساهمت النخب والطائفية في تعزيزها بدلًا من تفكيكها ؟، مع محاولة إستكشاف التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا النمط على مستقبل الدولة السودانية.؟
إعادة إنتاج الأزمة:
تُعد المحاصصة السياسية واحدة من السمات البارزة التي طبعت المسار السياسي السوداني منذ عقود، وخصوصًا بعد فترات الإنتقال المتكررة عقب النزاعات والإنقلابات والإنقسامات الحادة في البلاد، فقد تحوّلت المحاصصة من كونها آلية مؤقتة لتقاسم السلطة وضمان تمثيل القوى المختلفة، إلى نمط مستدام من الحكم يعيد إنتاج أوجه التهميش ويكرّس غياب العدالة، وبالرغم من الطموحات الثورية التي طرحتها الحركات الإحتجاجية السودانية، فإن منظومة النخب السياسية، بما في ذلك شريحة من المثقفين، لعبت دورًا في إدامة هذا النهج من خلال الانخراط في شبكات الولاء الطائفي والجهوي، وتبرير ممارسات تعزز منطق التوازنات الهشة بدلًا من بناء دولة المواطنة والمؤسسات، السؤال الرئيسي كيف تحوّلت المحاصصة إلى أداة لإعادة إنتاج النفوذ بدلًا من إعادة توزيع السلطة بشكل عادل، وكيف ساهمت الطائفية السياسية والنخب الثقافية في تقوية هذا المسار، إن تحليل هذا الإشكال يتطلب تفكيك العلاقة المعقدة بين البنى التقليدية والحديثة في السياسة السودانية، ومدى تأثيرها على بناء الدولة وتشكيل الوعي الجماهيري، فبين إستحقاقات العدالة الإنتقالية ومتطلبات الإستقرار، يبقى التحدي الحقيقي في تجاوز المحاصصة كحل سياسي إلى بناء نظام ديمقراطي قائم على الكفاءة والمساءلة والعدالة الاجتماعية.
أولاً: المحاصصة كآلية لتقاسم السلطة والثروة:
برزت المحاصصة السياسية في السودان كرد فعل على صراعات مسلحة، وحروب أهلية، وتهميش طويل الأمد لأقاليم واسعة مثل دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومع توقيع إتفاقيات السلام، خصوصًا اتفاقية نيفاشا (2005) وإتفاقية جوبا (2020)، أصبحت المحاصصة أداة رئيسية لتوزيع المناصب والموارد بين الحركات المسلحة والقوى السياسية، لكنها في ذات الوقت عمّقت منطق الاستحقاق السياسي مقابل السلاح أو التمثيل الجغرافي بدلًا من منطق المواطنة المتساوية، وتجسدت هذه المحاصصات في توزيع المناصب السيادية والوزارية وفقًا لمعايير إثنية وجهوية، وهو ما جعل الولاء للقبيلة أو الإقليم يتفوق على الكفاءة الوطنية، كما أدى ذلك إلى تركيز الثروة في أيدي نخب محلية أو حركات مسلحة تحوّلت من قوى ثورية إلى شركاء في السلطة، من دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة الاقتصادية والتنموية.
ثانيًا: دور النخب المثقفة :
لعبت النخب المثقفة في السودان، منذ الإستقلال وحتى اليوم، دورًا مزدوجًا: فمن جهة، تبنّت خطابات وطنية تنادي بالديمقراطية وبناء الدولة المدنية، ومن جهة أخرى، إنخرط عدد كبير من هذه النخب في التحالفات السياسية التي تستند إلى التوازنات الطائفية والجهوية، إما حفاظًا على مصالحها أو تحت غطاء الواقعية السياسية، وفي كثير من المحطات، ساهم بعض المثقفين في تبرير النظام القائم للمحاصصة، بوصفه السبيل الواقعي لتحقيق السلام أو إدارة التنوع، متجاهلين أن هذه السياسات تؤسس لحالة دائمة من التجزئة السياسية والانقسام المجتمعي، وتُقصي المواطن العادي الذي لا ينتمي إلى أي نخبة أو طائفة سياسية.
ثالثًا: الطائفية السياسية:
شكّلت الطائفية السياسية – متمثلة في الأحزاب ذات الخلفية الدينية والطائفية مثل حزب الأمة (الأنصار) والحزب الاتحادي (الختمية) – ولاحقاً الحركة الإسلامية عقب إستلامها للسلطة عبر إنقلابها علي الحكومة الديمقراطية شكلت بنية أساسية للسيطرة على القرار السياسي في السودان، هذه الطائفية لم تكن مجرّد ظاهرة إجتماعية، بل أداة فعالة لإدامة السلطة من خلال ولاءات غير سياسية، ما عزز من هشاشة مؤسسات الدولة وضعف الوعي المدني، ومع تكرار التجارب الإنتقالية والإنقلابات العسكرية، أعادت الطائفية إنتاج نفسها بأشكال جديدة، من خلال تحالفات تكتيكية مع العسكر أو الحركات المسلحة، بما في ذلك ما نشهده اليوم من صفقات سياسية تقوم على أساس الجهة والعرق لا على أساس الكفاءة والبرامج
رابعًا: النتائج المترتبة :
تؤدي المحاصصة إلى تسييس الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية، مما يقوّض كفاءتها وإستقلاليتها، وإعادة إنتاج التهميش بدلاً من معالجة مظالم الأطراف، تُعيد المحاصصة إنتاج التهميش من خلال تمكين نخب محدودة على حساب القواعد المجتمعية الواسعة، وتفتيت النسيج الوطني، الذي يعمّق منطق المحاصصة، والإنقسامات الإثنية والجهوية، ويغذي الصراعات الأهلية بدلًا من معالجتها، فضلاً عن إنعدام العدالة الإقتصادية، حيث تتحول الثروة الوطنية إلى غنيمة سياسية، تُوزع حسب موازين القوى وليس وفق خطط تنموية عادلة لكل ذلك نري بأن مستقبل السودان مرهون بتجاوز منطق المحاصصة إلى مشروع وطني جامع يعيد تعريف السياسة باعتبارها خدمة عامة لا غنيمة، وهذا يتطلب دورًا نقديًا ومتقدّمًا من النخب المثقفة، لا في تبرير الواقع أو الانخراط فيه، بل في تفكيكه وبناء بدائل تستند إلى دولة القانون، والعدالة الاجتماعية، والتمثيل العادل ضمن مؤسسات ديمقراطية مستقرة.
الخاتمة:
في عمق المأساة السودانية المتجددة، تبرز معضلة المحاصصة السياسية بوصفها عرضًا لأزمة أعمق في بنية الدولة والمجتمع، أزمة تتجاوز مجرد تقاسم المناصب أو توزيع الثروات إلى أزمة في مفهوم المواطنة ذاته، وفي الكيفية التي يُدار بها التنوع في بلد شديد التعقيد كالسودان، فبدلًا من أن تكون السياسة أداة للتقريب بين المكونات المختلفة، تحوّلت إلى ميدان للابتزاز السياسي والمساومات النفعية، حيث تُختزل قضايا العدالة والتنمية والتمثيل في صيغ حسابية باردة لتقاسم (كيكة السلطة)، تُمنح فيها الحصص لا على أساس الكفاءة أو الالتزام الوطني، بل بحسب مَن يملك السلاح ، إن أخطر ما في المحاصصة أنها لا تُقصي فقط الأفراد الذين لا ينتمون إلى نُخب طائفية أو عسكرية، بل تقصي كذلك فكرة المشروع الوطني ذاته، وقد تحول الوطن إلى جزر معزولة، وتحوّل الإنتماء من الوطن إلى الولاء، ومن المصلحة العامة إلى المصالح الفئوية، وما يزيد الأمر تعقيدًا هو إنخراط جزء كبير من النخبة المثقفة في هذا المسار، إما عبر الصمت، أو التبرير، أو المساهمة المباشرة في هندسة صفقات سياسية تُعيد تدوير نفس الأزمات تحت مسميات (انتقالية) و(توافقية) و(سلام شامل)، بينما الواقع يزداد هشاشة والهوّة بين المواطن البسيط وصاحب القرار تتّسع كل يوم، لكن رغم هذا المشهد القاتم، يظل الأمل ممكنًا في بروز قوى إجتماعية جديدة لا ترى في المحاصصة خلاصًا، بل ترى في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الطريق الوحيد نحو سودان عادل ومتوازن؟ الأمل في جيل جديد من المثقفين والسياسيين يتجرأ على نقد البُنى التقليدية، ويعيد تعريف السياسة كأخلاق ومسؤولية لا كحرفة نفوذ وغنائم؟ الأمل في تجاوز وهم (التمثيل بالتوزيع) إلى حقيقة (العدالة بالتنمية)، وفي الإنتقال من تسويات فوقية إلى تعاقد إجتماعي شامل يعيد الإعتبار للمواطن كركيزة أساسية في صناعة القرار؟ في نهاية المطاف، ليس المطلوب أن نرفض التنوع أو نطمس الخصوصيات، بل أن ندير هذا التنوع في إطار دولة عادلة وفاعلة، لا أن نحوله إلى وقود لصراعات لا تنتهي.؟لإن كلفة إستمرار المحاصصة ليست سياسية فقط، بل وجودية؛ فهي تُهدد بفقدان ما تبقّى من لحمة وطنية، ونري إن الخلاص لا يكون بترقيع النظام، بل بإعادة تأسيسه من الجذور، على أساس مبادئ المساواة، والمواطنة، والشفافية، والمحاسبة. وحده هذا الطريق، رغم صعوبته، هو ما يصنع سودانًا يستحق أن يُسمى وطنًا لكل أبنائه، لا دولة حصص ونصيبٍ بين المنتفعين؟( يتبع).
السودان والتنوّع: مورد قوة مهدور بسبب فشل الإدارة السياسية
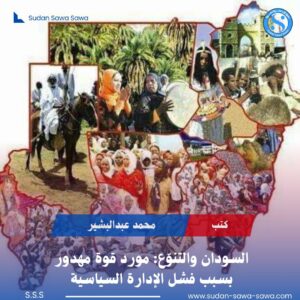
كتب : محمد عبدالبشير
سودان سوا سوا – 10 يوليو 2025م
على الرغم السودان يُعدّ من أكثر دول القارة الإفريقية تنوعًا من حيث العِرقيات والثقافات واللغات والمعتقدات، إلا أن هذا التعدد ظلّ لعقودٍ طويلة مصدرًا للنزاعات المتجددة والاضطرابات، بدلًا من أن يتحوّل إلى قاعدة راسخة لبناء الدولة الوطنية الجامعة على اساس الحقوق والواجبات والتي تكمن في بناء مشروع دولة المواطنة المتساوية . فشل الحكومات السودانية المتعاقبة في إدارة هذا التنوّع ساهموا بصورة مباشرة في تفكيك النسيج الاجتماعي، وإضعاف الاستقرار السياسي، وتعطيل البنية والتنمية، واندلاع الحروب الأهلية الممنهجة .
تعددية غنية… لكنها غير مُدارة
يقطن السودان أكثر من 40 مليون نسمة، ينتمون إلى أكثر من 500 قبيلة، ويتحدثون ما يزيد على 70 لغة ولهجة محلية. هذه التعددية الثقافية والعرقية والدينية كان من الممكن أن تشكّل ركيزة لقوةبناء وتشكيل الدولة السودانية، عبر خلق نموذج ديمقراطي يعكس هذا التنوّع، ويمنحه مكانته السياسية والدستورية.غير أن السياسات المركزية التي تبنتها الأنظمة المتعاقبة،على مر تاريخ السودان ، ساهمت في تهميش الأقاليم، وفرض هوية أحادية، غالبًا ما ارتبطت بالمركز النيلي واللغة العربية، مع تجاهل متعمّد للهويات الأخرى، لا سيما في الهامش الغربي والشرقي وجبال النوبة والنيل الأزرق.
التهميش وفرض الهوية الأحادية سبب جوهري للصراع :
الحروب في جنوب السودان (قبل الانفصال)، وفي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كلها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفشل الدولة في تحقيق العقد الاجتماعية وتوزيع السلطة والثروة، بل وفي الاعتراف المتساوي بالهويات المختلفة. ومن المفارقة أن كثيرًا من هذه المناطق تزخر بالموارد الطبيعية الغنية (كالذهب، الزراعة، المياه)، لكن سكانها هم الأكثر فقرًا وتهميشًا.
ما بعد الثورة… استمرار الفشل:
بعد ثورة ديسمبر 2018 التي أسقطت نظام عمر البشير، تعلّق السودانيون بآمال جديدة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تُنهي عقود التمييز والتهميش. إلا أن التجاذبات السياسية، والانقسامات الأيديولوجية، وضعف الإيرادةوالإرادة السياسية، عطّلت مشروع الانتقال، وأعادت إنتاج الصراعات بصورة أعنف، كما نشهد اليوم في الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي زادت المشهد تعقيدًا وأعادت خلط الأوراق.
التعدد كفرصة لا كتهديد:
يرى اغلبية الفاعلين والمفكرون السودانيون ومعظم المجتمع السوداني أن مفتاح الحل الجذري يكمن في الاعتراف الصريح بأن السودان دولة متعددة، ويجب أن يُبنى نظامها السياسي والدستوري على هذا الأساس، لا على محاولات الصهر القسري أو الهيمنة المركزية. فالتنوع إذا ما أُحسن إدارته، يمكن أن يكون مصدر قوة واستقرار، كما أثبتت تجارب دول كثيرة واجهت تحديات مشابهة.
ارى أن مشكلة السودان ليس في وفرة التعدد، بل من سوء إدارته. وما لم تتشكل رؤية وطنية شاملة تعترف بالجميع على قدم المساواة، وتضمن تمثيلهم العادل في مؤسسات الدولة، فستظل البلاد تدور في حلقة مفرغة من الحروب والهشاشة، وسيفوّت السودانيون مرةً تلو الأخرى فرصة بناء وطن يتّسع للجميع.
السودان بين الثروات والثورات: تاريخ من الأطماع الاستعمارية والحروبات المتجددة
كتب : محمدعبدالبشير
سودان سوا سوا – 30 يونيو 2025م

السودان، ذلك البلد الشاسع في قلب إفريقيا، مركز جذبٍ للأطماع الاستعمارية، ليس فقط لموقعه الجيوسياسي الحساس ، بل أيضاً لغناه بالموارد الطبيعية والثقافات المتنوعة ليس فقد ذلك بل فشل المشاريع السياسية لإدارة البلاد فمنذ عام 1956، لم يعرف السودان الاستقرار طويلاً، بل ظل يعيش في دوامة من الثورات والانقلابات، والحروب أهلية والصراعات السياسية والإقتصادية المتجددة التي تكمن في سوء ادارة التنوع الثقافي في السودان .
جاذبية الموقع والثروات: أطماع استعمارية مستمرة:
يقع السودان في منطقة استراتيجية بين القرن الإفريقي وشمال إفريقيا، ويمتلك حدوداً مع سبع دول، إضافة إلى منفذ بحري مهم على البحر الأحمر. هذا الموقع جعله هدفاً دائماً للتنافس الإقليمي والدولي.وفي سياق ، يعتبر السودان من أغنى الدول الإفريقية من حيث الموارد الطبيعية، إذ يمتلك احتياطيات ضخمة من الذهب، والنفط، والمعادن، والأراضي الزراعية الخصبة ومياه النيل. كل هذه العوامل جعلته مطمعاً للقوى الاستعمارية االبريطانيين والمصريين في حقبة الاستعمار الثنائي (1899-1956)، ثم لاحقاً ساحة نفوذ للصراعات الإقليمية والدولية.
الثورات كأدوات تغيير… ولكن بلا استقرار دائم
شهد السودان منذ استقلاله عدة ثورات شعبية أطاحت بأنظمة عسكرية أو شمولية، أبرزها:
ثورة أكتوبر 1964 ضد الحكم العسكري الأول.
انتفاضة أبريل 1985 ضد حكم جعفر نميري.
ثورة ديسمبر 2018 التي أنهت حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاماً.
لكن رغم هذه التحولات الثورية، فشل السودان في بناء نظام ديمقراطي مستقر ودائم. وغالباً ما كانت الثورات تجهض إما بواسطة انقلابات عسكرية أو بتحالفات سياسية هشة لا تصمد أمام التحديات البنيوية.
الحروب الأهلية: نتاج لصنيعة الأنظمة السياسية في السودان :
من أبرز ملامح تاريخ السودان الحديث الحروب والصراعات الداخلية، وعلى رأسها:
الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1955-1972 ثم 1983-2005)، والتي انتهت بانفصال جنوب السودان عام 2011م.
أزمة دارفور منذ عام 2003، والتي لا تزال تبعاتها قائمة حتى اليوم، رغم ما شهدته من اتفاقيات سلام مؤقتة.
النزاعات الاهلية في جنوب كردفان، النيل الأزرق، وشرق السودان.
يرجع كثير من المحللين جذور هذه الحروب إلى سياسات التهميش والإقصاء التي مارستها الحكومات المركزية المتعاقبة، وفشل الدولة في إدارة التنوع الثقافي والعرقي والديني.
الدور الإقليمي والدولي: تدخلات ومصالح متقاطعة:
لا يمكن فهم حالة عدم الاستقرار في السودان دون النظر إلى التدخلات الإقليمية والدولية لنتجة هشاشة البنية السياسية في السودان . فمعظم الدول ، لها مصالح متباينة في السودان، تتعلق بالأمن المائي، التوسع الاقتصادي، أو حتى التوازنات الجيوسياسية في البحر الأحمر.كما أن صراعات القوى العالمية ألقت بظلالها على السودان، خاصة بعد الثورة الأخيرة، حيث أصبح ساحة تنافس على النفوذ العسكري والاقتصادي.
الواقع الحالي: ثورة جديدة أم فوضى متجددة؟
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15أبريل 2023م، دخل السودان في واحدة من أخطر مراحل تاريخه. هذه الحرب ليست مجرد خلاف بين جنرالين، بل تعكس هشاشة بنية الدولة وانفجار التناقضات التي لم تُحل منذ عقود. وتشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص ماتوا نازحين وكم حالات الاعتداءات الجنسية ، في واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم حالياً.
هل من أفق للسلام والاستقرار؟
يبقى السودان نموذجاً معقداً لبلد تلازمه الثروات والثورات، لكن لم يتمكن من تحويل موارده وطاقاته إلى تنمية واستقرار دائمين. ضرورة مخاطبة جذور المشكلة السودانية عن طريق الآتي :
إعادة بناء الدولة على أسس مدنية ديمقراطية.
إدارة التنوع بطرق عادلة وشاملة.
لكن كل هذا مرهون بإرادة سياسية وطنية حقيقية، وبدعم دولي غير انتهازي، يراعي مصلحة الشعب السوداني قبل أي اعتبارات جيوسياسية.
إستهبال النخب وإعادة إنتاج الأزمة السودانية في عباءة الدولة المدنية
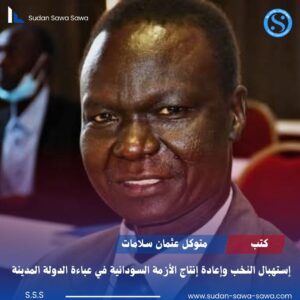
سودان سوا سوا – 26 يونيو 2025م
كتب : متوكل عثمان سلامات
منذ خروج المستعمر، ظل السودان يتأرجح بين الحروب والأنظمة السلطوية المتعاقبة، في ظل غياب مشروع وطني جامع يعترف بالتنوع والتعدد ويقر بعلمانية الدولة ويؤسس لعقد اجتماعي جديد. وقد أتت ثورة ديسمبر 2018م كتتويج لنضالات الشعوب السودانية المهمشة والتضحيات الجسام لحركات الكفاح المسلح لتفتح أفقاً جديداً، لكن مسارات الإنتقال تعثرت كعادتها بفعل تدخلات النخب وتواطؤها مع بنية الدولة الإسلاموعروبية العميقة. في هذا السياق، جاء البيان الختامي الصادر عن “الملتقى التفاكري حول الخروج من الحرب وقضايا الدولة المدنية الجديدة” (كمبالا، يونيو 2025م)، تحت شعار (بالمعرفة والحوار نوقف الحرب ونبني السلام) باعتباره نموذجاً خطابياً يعكس الأزمة البنيوية التي تعاني منها النخبة السياسية السودانية في التشخيص والمعالجة، كما يشكل أحد محاولات هذه النخب لإعادة تأطير الأزمة السودانية ضمن قوالبها التقليدية الفاشلة.
يأتي هذا المقال كمواصلة للحوار السوداني التأسيسي، وسأحاول فيه تفكيك هذا البيان الختامي، للكشف عن أوجه القصور المفاهيمي والسياسي التي تجعله يمثل إعادة إنتاج لخطاب الهيمنة التقليدي في السودان، وعاجزًا عن تمثيل لحظة تحوّل حقيقية، وتقديم بديل ثوري تحرري في هذه المرحلة الحرجة.
فشل التشخيص، التهرب المستمر من جذور الأزمة السودانية
بينما يشير البيان إلى “الفشل في إدارة التعدد والتنوع” كأحد أسباب الأزمة السودانية وهو موقف إيجابي يحسب للملتقى، فإنه يتعمد تجاهل الأسباب البنيوية الأخرى الأكثر عمقاً وخطورة، مثل الأسلمة القسرية، التعريب الإجباري، هيمنة النخبة المركزية، الدولة الدينية/ دولة التفويض الإلهي، والعنصرية المؤسسية والوحدة القسرية وآثار ممارسة العبودية والإسترقاق وعلاقة الدين والدولة وقضايا الأرض وتسيس الدين والإستبداد السياسي المحمي بالسلاح والإستعمار الإنجليزي المصري وغيرها، إن هذا الإغفال ليس بريئاً، بل يعكس عجزاً أخلاقياً وسياسياً للنخب التقليدية عن مواجهة جذور الأزمة بجرأة، ويعيد إنتاج سرديات قديمة ما بعد الاستعمار تبرر الإقصاء باسم الوحدة والسيادة الوطنية.
هذه ليست مجرد فجوة في الخطاب، بل هي إستمرار للإستهبال السياسي المتعمد الذي مارسته النخب منذ خروج المستعمر وحتى هذا الملتقى، مما يجعل الحديث عن “إجماع وطني” مجرد وهم سلطوي يكرّس الإقصاء التاريخي بدل معالجته.
الدولة المدنية، الغموض المقصود والتواطؤ مع مشروع الهيمنة
الملتقى في بيانه يروّج لما يسميه “الدولة المدنية الديمقراطية”، متجاهلاً عن عمد أن هذا المفهوم ملتبس ولا يعالج بشكل جذري إشكال خلط الدين بالدولة والأسلمة والتعريب والوحدة القسرية، والعنصرية والمواطنة غير المتساوية. الدولة المدنية تبقي على التشريعات الدينية والعرقية العنصرية وتسمح بتسرب الدولة الدينية مرة أخرى كما في الوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الإنتقالية بعد ثورة ديسمبر وهذا البيان ماهو إلا إعادة إنتاج لمشاكل الوثيقة الدستورية من ذات النخب التي أفرغت ثورة ديسمبر من مضمونها ، فالدولة المدنية كما طُبق في فترات الوثيقة الدستورية بعد ثورة ديسمبر، سمحت بتمرير وتسرب الدولة الدينية من خلال الإبقاء على التشريعات المستندة على الشريعة الإسلامية، وإبقاء الإمتيازات الإثنية والدينية، واستمرار الإسلام والعروبة كهوية مركزية للدولة.
الدولة المدنية بهذا المعنى هي قناع جديد للدولة الدينية، دولة الإقصاء باسم الحياد. إنها ليست حلاً بل إعادة إنتاج للأزمة، كما تجلت في البيان بتجاهل حتمية علمانية الدولة، وتفكيك بنية الأسلمة والتعريب، وإلغاء الإمتيازات القبلية والعرقية والدينية.
إصلاح الأجهزة الأمنية، ترميم لبنية الخراب وليس قطيعة معها
يتحدث البيان عن “الإصلاح الأمني والعسكري”، لكنه يغفل أن بنية الجيش والأجهزة الأمنية السودانية تأسست على عقيدة استعمارية ومركزية وإقصائية، مارست القتل والإغتصاب والعبودية والإبادة بحق شعوب بأكملها، لا سيما في الهامش.
الشعوب السودانية لا تطلب “إصلاحاً” لهذه المنظومة، بل تأسيس جيش وطني موحد ذو طابع مهني وقومي، يخضع من أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، وصون النظام الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدستوري، دون أي تدخل في الشأن السياسي أو الاقتصادي. كما أن المطلوب هو تأسيس جهاز أمن ومخابرات وطني مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وبذلك تتخلى المؤسسة العسكرية والأمنية عن كل تاريخها البشع في القتل والقمع الأيديولوجي والديني والعرقي. وأي حديث عن “إصلاح تدريجي” ماهو إلا إستهبال وسعي جاد من الملتقي للإبقاء على جوهر المؤسسة القمعية، وتطويل أمد بقائها.
الفدرالية، إعادة تدوير الوهم
بينما يحتفي البيان بالفدرالية كصيغة مثالية للحكم، يغفل عن عمد أن الفدرالية مطبقة منذ عهد الدكتور/ حسن عبدالله الترابي مروراً بفترة حكم نخب هذا البيان بعد ثورة ديسمبر وحتى الآن، فأين المشاركة الأصيلة للشعوب المهمشة الذي حققته او ستحققه الدولة المدنية الفدرالية كما أشار البيان؟. لم تجن الشعوب السودانية وخاصة الشعوب المهمشة من الدولة الفدرالية غير المزيد من الإقصاء والتهميش والقتل بإسم الدين (فتاوي إعلان الجهاد) وإعادة ممارسة العبودية والرق والإبادة الجماعية على أساس العرق اوالدين اواللون اوالنوع او الفكر وغيره. إذن بحكم التجربة والممارسة قضايا وحقوق الشعوب المهمشة يصعب معالجتها من خلال دولة مدنية فدرالية، فالمشاركة الأصيلة والفعلية لهذه الشعوب لن تتحقق إلا بتحقيق المواطنة المتساوية، ولن تتحقق المواطنة المتساوية إلا في ظل دولة علمانية ديمقراطية لامركزية، وهنا اللامركزية المقصودة هي السياسية والإدارية والمالية والقانونية.
العدالة الانتقالية، خطاب نخبوي لا يعالج المظالم التاريخية
البيان يدعو إلى “عدالة انتقالية” مستوحاة من تجارب المصالحة، لكنه يفشل في الاعتراف بأن الانتهاكات في السودان لم تبدأ من سنة 1989م، بل تعود إلى ما قبل خروج المستعمر وحتى الآن. فالعدالة الإنتقالية كما تُطرح في هذا البيان لا تلبي تطلعات الشعوب السودانية التي تطالب بـالعدالة والمحاسبة التاريخية نتيجة للمظالم التاريخية والإنتهاكات الحديثة، لابد من محاسبة بنيوية لكل من إرتكب الإنتهاكات المادية والمعنوية بحق الشعوب السودانية، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن العبودية والأسترقاق، والإبادة الجماعية في دارفور، والتطهير العرقي في جبال النوبة والنيل الأزرق، والمناصير وكجبار والخرطوم وغيرها.
العدالة المطلوبة لا تتعلق بممارسات نظام سياسي معين، بل بكل أنظمة الحكم التي حولت الدولة إلى أداة قمع إستعماري داخلي، ويجب أن تشمل المحاسبة النخب السياسية والفكرية والدينية التي شرعنت هذه الانتهاكات.
الحل الحقيقي، الدولة العلمانية كخيار تحرري جذري
لم يجرؤ الـ(40) دكتور/ة وبروف وأستاذ/ة في بيانهم على ذكر العلمانية رغم مركزيتها في مشروع الخروج من الحرب، وهذا دليل على استبطان هذه النخب لخطاب الهيمنة الدينية وخوفها من مواجهته.
الدولة العلمانية الصريحة التي تفصل الدين عن الدولة، وتعيد الاعتبار للتنوع الحقيقي وتضمن المساواة القانونية والسياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية، هي المخرج الوحيد من نفق الحروب والمدخل الصحيح للسلام العادل والدائم والتنمية المستدامة.
هذه القضايا المصيرية وأسئلة التأسيس الصحيح للدولة السودانية والتي تتهرب منها النخب السودانية بإستمرار، جاوبت عليها الشعوب السودانية التي إنتظمت في تحالف السودان التأسيسي – تأسيس، بكل صدق وشجاعة في وثيقتين، تشكل أحداهما المشروع الوطني التأسيسي المفقود منذ خروج المستعمر، وهو (ميثاق السودان التأسيسي) والآخر يشكل عقد إجتماعي جديد، وهو (الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م)، واللذين أقرا ولأول مرة، بحق الشعوب السودانية في ممارسة حق تقرير المصير كضامن للمرتكزات الأساسية لوحدة الدولة السودانية من إستهبال العسكر والنخب البيروقراطية والإنتهازيين المحليين.
ختاماً، هذا البيان يعكس تحركاً شكلياً لنخبة عاجزة عن مساءلة نفسها، يعيد إنتاج مفاهيم ثبت فشلها، ويتبنى خطاباً عاطفياً دون أدوات تفكيك حقيقية لبنية الأزمة، وبالتالي لا ئشكل اختراقاً سياسياً او معرفياً، بل إعادة تدوير لهزائم الماضي في عباءة جديدة.
آخر حاجة، إذا كانت النخب السياسية والفكرية السودانية لا تزال عاجزة عن تسمية الأشياء بأسمائها، العبودية، العنصرية، الأسلمة، التعريب، المركزية الإسلاموعروبية، الهيمنة الثقافية، الدولة الدينية، الإستبداد السياسي المحمي بالسلاح، اللامركزية فإن الملتقيات والبيانات، مهما حسنت نواياها، لن تُخرج السودان من الحرب، بل ستُبقي عليه داخلها باسم الحوار والمعرفة والسلام والوحدة.
بيان:حركة/جيش تحرير السودان: نرفض شرعية الأمر الواقع وندعو لحوار سوداني سوداني شامل ينهي الحرب ويؤسس لدولة ديمقراطية

سودان سواسوا – 21 يونيو 2025م
منذ فجر الثورة الأعظم ، ظلت حركة/ جيش تحرير السودان بفعلها الثوري تناضل وتعمل من أجل الحرية والعدالة والسلام الإجتماعي وبناء دولة ديمقراطية، ساعية إلى إزالة جميع مظاهر الظلم والقهر، وبناء دولة مؤسسات تحقق أسس المساواة والعدالة، وتحافظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً، بعيداً عن مشاريع التفكيك والتقسيم التي ما زالت تهدد وحدة الدولة السودانية.
لقد عمق نظام 30 يونيو 1989 الأزمة الوطنية حينما حول الدولة إلى مشروع أيديولوجي يستند إلى الإسلام السياسي، مستخدماً أدوات القمع، وخطابات الكراهية، وتقسيم المجتمع، ونهب الموارد، مما أدى إلى انهيار إقتصادي شامل وتفكك مؤسسات الدولة.
وقد أدى الإختلال البنيوي في مؤسسات الحكم وهيمنة الصفوة السياسية إلى إشعال حروب عبثية أنهكت البلاد وأسفرت عن تهميش واسع، خاصة في أقاليم السودان الثائر ، مع الغياب التام وعدم الرغبة في بناء مشروع وطني يتراضي عليه بنات وأبناء الشعب السوداني.
إن أزمة السودان لم تبدأ في 15 أبريل 2023م، بل هي إمتداد لأزمة تراكمية تأريخية مزمنة منذ خروج المستعمر في 1956، ظل يدار بعقلية الإقصاء وإنعدام الرؤية السياسية.
اليوم، يمر السودان بإحدى أسوأ أزماته في التاريخ، إذ خلفت الحرب كارثة إنسانية مروعة، تشرد بسببها الملايين، واستمرت الإنتهاكات الجسيمة دون مساءلة، مما أوقف مسار التغيير الديمقراطي وجر البلاد إلى حافة الإنهيار.
نحن في حركة/جيش تحرير السودان، نؤكد ما يلي:
لا حل عسكري للأزمة، ونرفض شرعية الأمر الواقع. نؤمن بأن الحل يكمن في حوار وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالتغيير و الحل الشامل للأزمة بإستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته ومن يرفض ذلك.
رفضنا كافة الإتفاقيات السابقة (أبوجا، الدوحة، جوبا)، لأنها لم تخاطب جذور الأزمة التاريخية السودانية الممتدة منذ الإستقلال.
نتبنى موقف الحياد تجاه الحرب الدائرة، ونركز جهودنا على المبادرات السياسية والإنسانية لوقف الحرب وإنهائها.
نطالب باعادة هيكلة الدولة على أسس وطنية جديدة ترسخ حكم سيادة القانون، وتعالج الإختلالات التأريخية، بمشاركة أبناء وبنات الشعب السوداني على أساس عقد إجتماعي جديد يكفل فيه الحقوق والواجبات الوطنية علي مبدأ المواطنة المتساوية والتعدد والتنوع الثقافي في السودان.
نسعى لتشكيل جبهة مدنية عريضة توحد جهود السلام والإستقرار وإنهاء الحرب، عبر رؤية سياسية واضحة تضم كافة القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح والمؤمنين بالحل الشامل، باستثناء حزب المؤتمر الوطني وواجهاته ومن يرفض هذا المشروع.
إننا ندرك حجم التحديات والفوضى التي تسبب فيها تمدد المليشيات الإسلامية، ومحاولات تقويض التحول المدني الديمقراطي. فقد تعرض ملايين المواطنين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وجبال النوبة، ومدن السودان كافة، إلى عنف منهجي وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والإغتصاب والإعتقال القسري.
نؤكد ضرورة محاسبة مرتكبو جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وتسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إن مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تحتم علينا حماية المواطنين والنازحين رغم محدودية إمكانياتنا، وسنواصل العمل على حماية المدنيين واستقبال النازحين في المناطق المحررة.
نجدد نداءنا لكافة المنظمات الإنسانية والعاملين في هذا المجال، وللقوى الوطنية الصادقة، بالانخراط في مشروع وطني سوداني ينهي الحرب إلى الأبد، ويؤسس لدولة علمانية، فدرالية ، ليبرالية، ديمقراطية ، حرة وموحدة، تقوم على المواطنة المتساوية، من خلال حوار سوداني–سوداني حقيقي.
سارة آدم محمد عبد الكريم
مسؤول القطاع السياسي
حركة/ جيش تحرير السودان
خلوة “العلم نور”.. مبادرة تعليمية تعيد الأمل لأطفال فقدوا مدارسهم بسبب الحرب في السودان
سودان سواسوا – 18 يونيو 2025م

بمدينة زالنجي ـ ولاية وسط وفي زاوية متواضعة من حيّ ضربته الحرب، وتوقفت فيه المدارس، يسعى الشيخ عبد اللطيف عيسى آدم حامد، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى زرع الأمل في نفوس أكثر من 155 طفلًا، عبر مبادرة شخصية افتتح بها خلوة أطلق عليها اسم “العلم نور”.
منذ عامين، بدأ الشيخ عبد اللطيف مشروعه هذا، ساعيًا لإعادة ما انقطع من تعليم الأطفال بعد إغلاق المؤسسات التعليمية في 15 أبريل، بسبب تصاعد النزاع المسلح. ويقول في إفادته: ل ( سودان سوا سوا )
“افتتحت الخلوة قبل سنتين بعد توقف المدارس، والهدف منها تعليم الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن، وأيضًا ترسيخ الأخلاق والسلوك، بعدما أثرت الحرب حتى على طريقة تعامل الأطفال في حياتهم اليومية.”
وفي سياق آخر الخلوة تستقبل الأطفال من أعمار تتراوح بين 7 إلى 14 عامًا، وتعمل في فترتين: صباحية من 6:30 حتى 12 ظهرًا، ومسائية من 2:30 إلى 5 مساءً. يدفع كل طالب رسومًا رمزية تُقدر بـ 2000 جنيه سوداني، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. فالشيخ عبد اللطيف يشير إلى أن المكان ليس مخصصًا أو دائمًا، بل استضافه مسجد الحي، فيما يفتقر إلى أبسط البنى التحتية، بما في ذلك الظل الذي يقي الأطفال من الأمطار خلال موسم الخريف، ما يدفعه أحيانًا إلى إغلاق الخلوة مؤقتًا.
ورغم ضيق الإمكانيات، يحقق بعض الطلاب تقدمًا لافتًا. فمنهم من وصل إلى منتصف المصحف عند سورة الكهف، وآخرون أكملوا الأجزاء الأولية، بينما ما زال بعضهم في مرحلة تعلم الحروف.
من بين هؤلاء الأطفال، يبرز صوت عبد الناصر أحمد حمزة آدم أحمد، قصته لمراسل ( سودان سواسوا) طفل في الثانية عشرة من عمره، يروي تجربته ببراءة مؤلمة:
“دخلت الخلوة قبل سنتين، لأنه لم يكن هناك مكان آخر للتعليم. بعد الدوام الصباحي، أذهب للعب مع أصدقائي في الشارع. كنت أتمنى العودة إلى المدرسة، وإذا فتحت من جديد فسأرجع فورًا، لأني أريد أن أصبح مهندسًا. لكن مرّ عامان، ولا أرى أملًا في ذلك.”
قصة الشيخ عبد اللطيف وخلوة “العلم نور” تجسد معاناة آلاف الأطفال السودانيين الذين حُرموا من حق التعليم، وتسرد واقعًا أكثر مرارة حين يتحول التعلم من نظام مؤسسي إلى مبادرات فردية، تعاني من غياب الدعم وضعف الموارد، لكنها رغم ذلك، لا تزال تصر على زرع الأمل في زمن الحرب.
نازحون في دارفور يواجهون الجوع والمرض في مركز إيواء دار السلام وسط غياب الدعم الإنساني
سودان سواسوا | 17 يونيو 2025م

تروي فاطمة احمد قصتها لمراسل ( سودان سوا سوا) مع اقتراب دخول فصل الخريف الذي يحمل المطر والأمل، تسكن فاطمة احمد محمد الذي تبلغ من عمرها (47) على بيت تتكون من القش وقطعة قماش مهترئة أمام فصل دراسي تحوّل إلى مأوى بمركز إيواء مدرسة دار السلام بمدينة زالنجي ـ بولاية وسط دارفور، تمسك بطفلها المصاب بالملاريا، وتحدّق في الأفق دون رجاء. فاطمة، أرملة وأم لثمانية أطفال، تروي قصة مأساتها التي بدأت منذ أن أجبرها النزاع المسلح في دارفور على الفرار من معسكر “كركرا” بمحلية كبكابية، بولاية شمال دارفور لتجد نفسها نازحة للمرة الثانية خلال أقل من عام.
معاناة يومية مع الجوع وانعدام الغذاء

“نجمع بقايا الطعام من الأسواق أو نطرق أبواب البيوت طلبًا للصدقة”، تقول فاطمة وهي تشير إلى ابنتها الكبرى التي تخرج كل صباح بحثًا عن لقمة تسد الرمق. أزمة الغذاء في مركز إيواء دار السلام لا تلوح لها نهاية، فالأسر النازحة لا تتلقى دعمًا غذائيًا منتظمًا، وتعيش في ظروف اقتصادية لا تسمح لها بشراء أبسط الاحتياجات.
خريف دارفور يجلب معه المرض والمآسي
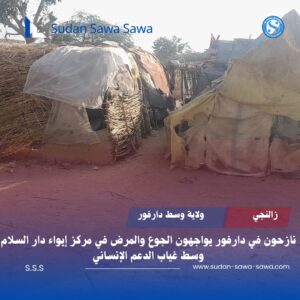
ومع بداية موسم الأمطار، تزداد المعاناة في مركز الإيواء، حيث تعيش الأسر داخل فصول مدرسية بلا نوافذ أو أسقف آمنة. غياب الأدوية، وندرة الكوادر الطبية، أديا إلى تفشي الملاريا والالتهابات، خاصة بين الأطفال. “في كل ليلة نسهر بجانب أبنائنا نحاول تخفيف الحمى عنهم، لكن لا دواء ولا طبيب”، تضيف فاطمة بأسى.
لا أرض تُزرع ولا عون يُمنح

رغم حلول موسم الزراعة، إلا أن معظم النازحين في دارفور، مثل فاطمة، لا يملكون أرضًا لزراعتها ولا مالًا لاستئجارها. كما أن أدوات الزراعة والمعينات الغذائية نادرة أو معدومة. “كيف نزرع ونحن لا نجد طعام اليوم؟ الإنسان لا يستطيع العمل وهو جائع”، تقولها وهي تشير إلى حفنة من الدخن القاسي في كيس صغير بجوارها.
مساعدات إنسانية محدودة لا تسد الرمق
رغم جهود بعض المنظمات الإنسانية، إلا أن الدعم المقدم لا يفي بالحاجة. فاطمة توضح أن الوجبات التي قُدمت خلال الأسبوع الماضي اقتصرت على وجبتي إفطار، في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين واحتياجاتهم.
الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة في مركز دار السلام:
مأوى مقاوم للأمطار ومستلزمات الإيواء
غذاء يومي يكفي الأطفال والنساء
أدوية وعلاجات للأمراض المنتشرة
ملابس ومواد نظافة شخصية
الحرب دمّرت الأرواح قبل البيوت
“فقدت زوجي في قصف جوي أثناء محاولتنا الفرار”، تروي فاطمة، ودمعتها تخنق صوتها، وتضيف: “أطفالي يعانون من أمراض مزمنة، وبعضهم يعاني من اضطرابات نفسية. الحرب دمّرتنا من الداخل قبل أن تسرق منا بيوتنا.” وتختم حديثها بنداء إنساني: “نريد فقط أن نعيش بكرامة… وأن نجد من يرانا.”
الإعتداءات تتصاعد … مقتل فتاة في نزهة .. والأمن غائب
سودان سوا سوا 15 يونيو 2025م
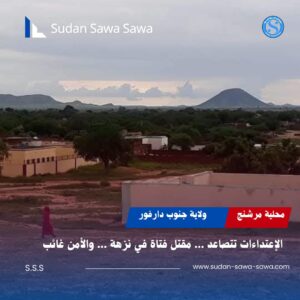
وقعت جريمة قتل مأساوية يوم 14 يونيو 2025م ، راح ضحيتها الفتاة الشابة / تهاني محمد خالد أثناء تواجدها في نزهة في محلية مرشنج – بولاية جنوب دارفور برفقة مجموعة من الفتيات، وذلك بعد أن تعرضت المجموعة لاعتداء من قبل عناصر مسلحة تتبع لقوات الدعم السريع .
ووفقًا لمصادر محلية وشهود عيان تحدثوا ،ل( سودان سوا سوا ) فقد قامت هذه العناصر بإيقاف الفتيات في وادي محلية مرشنج ، ووجّه أحد أفرادها تهديدًا مباشرًا إلى الضحية مطالبًا إياها بتسليم هاتفها المحمول. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الفتاة حاولت مقاومة الطلب أو الهروب، ما دفع أحد المعتدين إلى استخدام العنف المفرط ضدها، مما أدى إلى مقتلها في الحال.

وبحسب إفادات الشهود، فرّ الجناة من موقع الحادثة قبل وصول أي دعم أمني، في وقت ظلّت فيه صديقات الضحية في حالة صدمة وذعر شديدين.
وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة في أوساط السكان، الذين عبّروا عن قلقهم المتزايد من تكرار مثل هذه الحوادث، إضافة ان محلية مرشنج تسيطر عليها قوات الدعم السريع التي تفتقر إلى الحضور الأمني المنتظم. كما طالب نشطاء ومهتمون بالشأن المحلي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الحماية المجتمعية، خاصة للفتيات والنساء.
يُشار إلى أن الحادثة تأتي في ظل تصاعد ملحوظ في حالات الاعتداءات والجرائم المنظمة في محلية مرشنج .
تحالف المزراعين:إرتفاع مدخلات الإنتاج يهدد الموسم الزراعي الصيفي
سودان سوا سوا 7 يونيو 2025م
كتب:حسين سعد
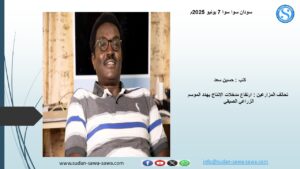
أكد تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل إن إرتفاع مدخلات الأنتاج الزراعي يهدد العروة الصيفية بالفشل لافتاً إلي إن سعر جوال السماد اليوريا بلغ (90) ألف جنيه بدلاً من (30) ألف جنيه في العام الماضي ، وجوال السماد الداب إرتفعت قيمته من (40) ألف جنيه في العام الماضي إلي (120) ألف جنيه ،في وقت أوصدت البنوك أبوابها أمام المزارع الذي نهبت أمواله وممتلكاته ومدخراته وأصبح لا يستطيع تحضير أرضه ، وأشار التحالف إلي عدم وجود كراكات كافية، لأزالت الأطماء من القنوات الكبيرة والمواجر والترع، وعدم وجود حفارات أبوعشرين في كثير من أقسام المشروع، ومكاتبه على الرغم من التصريحات المتكررة من السيد محافظ المشروع وحديثه عن التعاقد مع أصحاب الحفارات،مؤكداً وجود كسور في الترع تفوق ألف كسر لم يتم ردمها إلا القليل منها ،وهو مايقود إلي إهدار المياه وإغراق بعض القري وإنتشار الأمراض المنقولة مائياً، فضلاً عن إنتشار كمائن الطوب في الترع والمواجر الذي يهدد بإنهيار حركة الكراكات .
ولفتت التحالف في بيان له أطلعت عليه:إنه تلقي وعود من قبل محافظ المشروع بتوفير تقاوي مجانية للمزارعين لكن ذلك لم يتم حتي الاول من يونيو 2025م ،الأمر الذي أدي إلي تأخير الموسم الزراعي عن الزمن الموصى به من قبل إدارة البحوث الزراعية مثلاً مواعيد زراعة الفول السوداني تبدأ في 25 مايو والقطن في الأول من يونيو، ومحصول الذرة في الخامس عشر من يونيو الحالي ، وتابع البيان (معلوم إن إي زراعة تخرج من ميقاتها تقل إنتاجيتها ، كما أن هطول الأمطار يعوق نظافتها)
وناشد التحالف الجهات المختصة، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية بدعم المشروع ومزارعيه، مشيراً إلي وجود تقارير من هيئة الأمم المتحدة تتحدث عن فجوة غذائية ،وتعرض الملايين من سكان السودان للمجاعة الأمر الذي يجعل الاهتمام بالزراعة أمر مهم لاسيما وإن مشروع الجزيرة يعتبر من أكبر المشاريع الزراعية في السودان حيث يتمدد في مساحة تفوق إثنين مليون فدان، ويوفر الغذاء لكل السودان وبشكل خاص لأكثر من ستة ملايين بولاية الجزيرة.
“أنشودة الموت بين سلام جوبا وحكومة كامل إدريس: اتفاقية تتحلل تحت نيران الحرب”
كتب: محي الدين محمد
سودان سواسوا 5يونيو 2025
في 31 أغسطس 2020، شهدت عاصمة جنوب السودان، جوبا، توقيع اتفاقية سلام تاريخية بين الحكومة الانتقالية السودانية، ممثلة برئيس الوزراء آنذاك، وعدد من الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء “الجبهة الثورية”. حمل الاتفاق آمالاً عريضة للشعب السوداني بإنهاء الحروب الطويلة وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي شامل، لكنه سرعان ما تعثّر في فخاخ الحسابات السياسية والصراعات العسكرية.
بنود الاتفاق وأحلام ما بعد الحرب
شملت اتفاقية جوبا ثمانية بروتوكولات رئيسية، من أبرزها:
– دمج الحركات المسلحة في القوات النظامية وحل الميليشيات.
– تطبيق العدالة الانتقالية في جميع أقاليم السودان.
– التعويضات وجبر الضرر للمتضررين من النزاعات.
– تنمية المجتمعات المهمّشة كالبدو الرحل والرعاة.
– إعادة توزيع الثروات والحقوق الاقتصادية بشكل عادل.
– حل قضايا النازحين واللاجئين.
– معالجة نزاعات الأراضي والحواكير.
– تقاسم السلطة، عبر تمثيل الحركات المسلحة في مؤسسات الحكم الانتقالي.
وبناءً على هذه البنود، دخل قادة الحركات المسلحة إلى المشهد السياسي، وتولوا مناصب رفيعة؛ فتم تعيين مني أركو مناوي حاكمًا لإقليم دارفور، وجبريل إبراهيم وزيرًا للمالية، إلى جانب أعضاء في مجلس السيادة مثل الهادي إدريس والطاهر حجر.
اتفاق يتحول إلى أداة حرب
لكن ما بدا وكأنه فتحٌ جديد في مسار السودان، سرعان ما تحوّل إلى مسرح لتضارب الولاءات وتكريس السلطة. انحاز معظم قادة الحركات المسلحة إلى طرف قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مواجهة الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان. هذا الانقسام أفضى إلى تأسيس حكومة موازية في الخرطوم بقيادة الدعم السريع، مقابل حكومة “أمر واقع” في بورتسودان.
كامل إدريس: رئيس وزراء بلا شرعية؟
في خضم هذه الفوضى، برز اسم البروفيسور كامل إدريس، الذي عُيّن مؤخرًا رئيسًا للوزراء من قبل حكومة بورتسودان، وسط تشكيك واسع في شرعيته القانونية. فغياب المجلس التشريعي وعدم توافق القوى السياسية على الأرض يجعل من تعيينه خطوة محل نزاع، يراها كثيرون أنها أداة لتجميل وجه السلطة العسكرية، وليس مدخلًا حقيقيًا لإيقاف الحرب.
تصريحات إدريس لم تحمل مؤشرات إيجابية تجاه وقف الحرب أو تقديم رؤية اقتصادية واضحة، بل ظهر في نظر المراقبين كصوت إضافي في جوقة العسكر، لا يملك قاعدة سياسية أو شرعية جماهيرية تُمكّنه من لعب دور فعّال في هذه المرحلة الحرجة.
الحركات المسلحة بين خيارين مرّين
باتت الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاق جوبا، أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانصياع الكامل لحكومة بورتسودان لتنال ما يُقدَّم لها من فتات السلطة، أو المجازفة بفقدان مواقعها الحالية في مؤسسات الدولة. الأمر الذي أفقد الاتفاقية معناها الأصلي، وجعل من تمثيل الحركات وسيلة لشرعنة حرب جديدة، وليس جسراً للسلام.
الجرائم مستمرة والإنسان يدفع الثمن
الحرب الدائرة حاليًا في دارفور وكردفان وغيرها، خلفت آلاف القتلى، لا سيما في مدينة الجنينة التي شهدت مذابح بحق النازحين، ونزوح جماعي نحو جبل مرة، معقل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. كما تحوّلت معسكرات النازحين إلى قواعد عسكرية، واستُخدم المدنيون كدروع بشرية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وسط صمت مريب من المجتمع الدولي.
هل من مخرج؟
في الوقت الذي اعتبر فيه الاتحاد الإفريقي تعيين كامل إدريس خطوة نحو مدنية ممكنة، احتفظت الأمم المتحدة بموقفها الحذر، ودعت فقط إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات. أما الداخل السوداني، فهو يشهد تطورات ميدانية حاسمة في كردفان، قد تحدد مصير الحرب ومصير الحكومة نفسها، إذ أن النزاع العسكري يُهدد حتى توازنات السلطة داخل بورتسودان.
خلاصة
اتفاقية جوبا، التي ولدت بوصفها مشروعًا وطنيًا للسلام، تحولت اليوم إلى وثيقة ميتة تُستخدم لتبرير القتال وتقسيم النفوذ. تعيين كامل إدريس ليس سوى محاولة لإعادة تدوير سلطة العسكر بثوب مدني، فيما لا يزال الشعب السوداني يدفع ثمن صراع لا مصلحة له فيه.
اللحظة تقتضي العودة إلى مشروع وطني جامع، لا يُقصي أحدًا، وينطلق من إرادة مدنية حقيقية تضع مصلحة الوطن فوق حسابات السلطة. وإلا، فإن الحرب ستبقى تدور في حلقة مفرغة، عنوانها: أنشودة الموت… باسم السلام.
السودان أرض البطولات والثورات(10)
سودان سواسوا 30 مايو 2025م
كتب:حسين سعد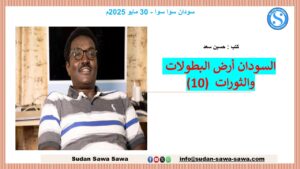
نواصل معرفة أوجه الشبه بين ثورتي مارس أبريل 1985م، وثورة ديسمبر 2018م ، نعيد مختطفات من مقال الأستاذ تاج السر عثمان في مقال له بعنوان ( في ذكراها الأربعين ما هي دروس إنتفاضة مارس – أبريل ١٩٨٥؟) لم تكن إنتفاضة أبريل حدثا عفوياً، بل كانت نتاج تراكم نضالي طويل خاضه شعب السودان ضد ديكتاتورية نظام النميري ، والذي إتخذ الأشكال الآتية:المقاومة المسلحة في الجزيرة أبا والتي قمعها النظام عسكرياً بوحشية ودموية، عبرت عن هلع وضعف الديكتاتورية العسكرية،ومقاومة ضباط إنقلاب 19 يوليو 1971م الذين أطاحوا بحكم الفرد ، وبعد الفشل ، إستشهد العسكريون: الرائد هاشم العطا و المقدم بابكر النور والرائد فاروق عثمان حمدالله وغيرهم من العسكريين البواسل ، وقادة الحزب الشيوعي: عبد الخالق محجوب والشفيع احمد الشيخ وجوزيف قرنق، واعتقال وتشريد الالاف من الشيوعيين والديمقراطيين بعد يوليو 1971م،وبعد إنقلاب 22 يوليو 1971م الدموي، تواصلت المقاومة الجماهيرية، وكانت مظاهرات واعتصامات طلاب المدارس الصناعية عام 1972، والمظاهرات ضد زيادات السكر في مايو 1973م ، والتي أجبرت النظام علي التراجع عنها، كما انفجرت انتفاضة اغسطس 1973م، والتي قادها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وبعض النقابات، وفي العام 1974م كانت هناك مظاهرات طلاب كلية الطب في الإحتفال باليوبيل الفضي للكلية ضد السفاح نميري، وإعتصام طلاب جامعة الخرطوم في ديسمبر 1973م، من أجل عودة الإتحاد الذي تم حله، وإطلاق سراح المعتقلين، وحرية النشاط السياسي والفكري في الجامعة، والمظاهرات التي إندلعت ضد الزيادات في السكر والأسعار، وإضرابات ومظاهرات طلاب المدارس الثانوية في العاصمة والأقاليم عام 1974م من اجل انتزاع اتحاداتهم وضد اللوائح المدرسية التي تصادر حقهم في النشاط السياسي والفكري المستقل عن السلطة والإدارات المدرسية حتي نجحوا في انتزاع اتحاداتهم.
ماهو البديل:
ويواصل السر :في دورة يناير 1974م، أجابت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني علي سؤال ما هو البديل؟: وأصدرت وثيقة بعنوان ” مع الجماهير في قضاياها وتساؤلاتها حول : البديل – القيادة – الأداة ” طرحت فيها شعار الإضراب السياسي العام والانتفاضة الشعبية كأداة للاطاحة بالسلطة، وفي سبتمبر 1975م، وقعت المحاولة الانقلابية التي قام بها المقدم حسن حسين، وتم اغلاق جامعة الخرطوم، وتقديم قادة الانقلاب لمحاكمات واستشهادهم في “وادي الحمار” بالقرب من مدينة عطبرة،وفي2 يوليو 1976م، كانت المقاومة المسلحة من الخارج التي نظمتها الجبهة الوطنية (الأمة ، الاتحادي، الإخوان المسلمون) ، وبعد فشل المحاولة تم اعدام قادتها العسكريين والمدنيين (العميد محمد نور سعد، ..الخ)، وتم التنكيل بالمعتقلين بوحشية، وتم وصف سودانيين معارضين( بالمرتزقة)
وفي أغسطس 1977م، تمت المصالحة الوطنية والتي شارك بموجبها في السلطة التنفيذية والتشريعية أحزاب الأمة (الصادق المهدي) والاتحادي الديمقراطي (محمد عثمان الميرغني) والإخوان المسلمون (مجموعة د. حسن الترابي) ، ورفضت أحزاب الشيوعي والاتحادي (مجموعة الشريف الهندي) و البعث. الخ، المشاركة في السلطة، وتحت هيمنة نظام الحزب الواحد و”اجندة” نميري، وحكم الفرد الشمولي، والذي كان يهدف من المصالحة لشق صفوف المعارضة واطالة عمره والتقاط انفاسه التي انهكتها ضربات المعارضة المتواصلة.
مابعد المصالحة الوطنية:
وبعد المصالحة الوطنية تواصلت الحركة الجماهيرية ، وكانت اضرابات المعلمين والفنيين وعمال السكة الحديد، وانتفاضات المدن (الفاشر، سنجة، سنار، الأبيض. الخ)، وانتفاضات الطلاب، واضرابات الأطباء والمهندسين والقضاء، والمزارعين، ومعارك المحامين من أجل الحقوق والحريات الديمقراطية، وندواتهم المتواصلة التي كانت في دار نقابة المحامين ضد القوانين المقيدة للحريات،وفي مايو 1983م وبعد خرق النميري لاتفاقية اديس ابابا بعد قرار تقسيم الجنوب، إنفجر التمرد مرة اخري بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تزعمها جون قرنق، وزادت النيران اشتعالا بعد إعلان حالة الطوارئ وقوانين سبتمبر 1983م، والتي كان الهدف منها وقف مقاومة المعارضة الجماهيرية المتزايدة، ولكن المقاومة زادت تصاعدا بعد تطبيق تلك القوانين في ظروف ضربت فيها المجاعة البلاد، وتفاقم الفقر والبؤس بعد تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي منذ العام 1978 التي أدت لتخفيض العملة وانهيار الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، والزيادات المتوالية في الأسعار وشح المواد البترولية، اضافة لفقدان البلاد لسيادتها الوطنية بعد اشتراك السودان في مناورات قوات النجم الصاعد ، ترحيل الفلاشا إلى اسرائيل، ديون السودان الخارجية التي بلغت 9 مليار دولار، تفاقم الفساد الذي كان يزكم الأنوف، تدهور مؤسسات السكة الحديد والنقل النهري ومشروع الجزيرة والتدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني. وتواصلت المقاومة ضد قوانين سبتمبر ، وتم الاستنكار الجماهيري الواسع لإعدام الشهيد الأستاذ محمود محمد طه في 18 يناير 1985م. وبعد ذلك بدأت المقاومة تأخذ اشكالا اكثر اتساعا وتنظيما وتوحدا، وتم تكوين التجمع النقابي والقوي السياسية الذي قاد انتفاضة مارس – ابريل 1985م، بعد الزيادات في الأسعار التي أعلنها النظام في أول مارس 1985م، وتواصلت المظاهرات ضد الزيادات في بعض المدن مثل: عطبرة من أول مارس وحتى 6 ابريل، عندما أعلن التجمع النقابي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي اوقف الإنتاج وشل جهاز الدولة وأخيرا انحياز المجلس العسكري والذي اعلن الاطاحة بالنظام.
المقاومة الجماهيرية:
من السرد أعلاه يتضح عمق وشمول المقاومة الجماهيرية والعسكرية للنظام التي كانت تتراكم يوميا حتي لحظة الإنفجار الشامل ضد النظام، وان مظاهرات طلاب الجامعة الإسلامية الأخيرة كانت الشرارة التي فجرت الغضب المكنون ضد النظام، فقبل مظاهرة طلاب الجامعة الإسلامية قامت مظاهرات وانتفاضات جماهيرية كالتي أشرنا لها سابقا، فلماذا لم تقم الانتفاضة الشاملة ضد النظام؟ وتوضح تجربة الثورة المهدية وثورة اكتوبر 1964م وتجربة انتفاضة مارس – ابريل 1985م، وثورة ديسمبر2018 م في السودان أن الانتفاضة تقوم عندما تتوفر ظروفها الموضوعية والذاتية والتي تتلخص في:الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم،بجانب أزمة عميقة أخري تشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير(يتبع).
أثر التكتلات السياسية على استقرار السودان
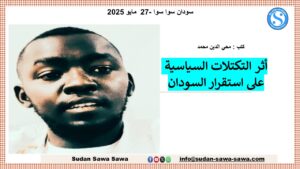
كتب : محي الدين محمد
سودان سواسوا 27 مايو 2025
الملخص:
تتناول هذه الورقة دور التكتلات السياسية في السودان منذ عام 1956 حتى ثورة ديسمبر 2018، مع التركيز على كيفية تأثير هذه التكتلات على استقرار السودان. وتشير الورقة إلى أن التكتلات الحزبية كانت في كثير من الأحيان مدفوعة بمصالح ضيقة، سواء أيديولوجية أو جهوية أو قبلية، مما أدى إلى تعميق الأزمات السياسية والاجتماعية، وزاد من هشاشة الدولة وتفكك نسيجها الوطني.
مقدمة:
شهد السودان منذ 1956 مسيرة سياسية مضطربة، تميزت بالصراعات بين القوى السياسية، والانقلابات العسكرية، والنزاعات المسلحة. وقد ساهمت التكتلات السياسية في تشكيل هذه الحالة، بدءاً من القوى التي ورثت السلطة من المستعمر، وصولاً إلى الحركات الثورية والمسلحة.
أولاً: التكتلات السياسية وميراث الاستعمار
كان الاستعمار البريطاني يستخدم سياسة “فرق تسد”، التي أدت إلى تقسيم المجتمع السوداني على أسس إثنية وجهوية. وبعد الاستقلال، استمرت هذه السياسات بشكل غير مباشر، حيث ورثت النخب الحاكمة أدوات السلطة دون مشروع وطني جامع، مما أدى إلى إقصاء مناطق واسعة من البلاد.
ثانياً: ضعف المشروع الوطني وغياب التوافق
غابت الرؤية القومية الجامعة في ظل صراع مستمر بين اليمين واليسار، ومع غياب دستور دائم يمثل جميع المكونات، تفاقمت الأزمات، خاصة في الجنوب، حيث بدأت المطالبات بالفيدرالية مبكراً. أدى ذلك إلى اندلاع الحروب الأهلية التي أثّرت على وحدة واستقرار الدولة.
ثالثاً: عسكرة السياسة وتسييس الجيش
لعب الجيش السوداني دوراً محورياً في الحياة السياسية منذ الاستقلال، حيث وقعت عدة انقلابات كان آخرها انقلاب النميري في 1969. وانخرط الجيش في تنفيذ أجندات حزبية، مما حوله إلى أداة في يد النخب السياسية المتصارعة، بدلاً من أن يكون مؤسسة وطنية محايدة.
رابعاً: النزاعات المسلحة والهويات المهمشة
ساهم التهميش السياسي والثقافي والاقتصادي في تصاعد النزاعات في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وتمردت قيادات بارزة من أبناء هذه المناطق، ممن كانوا ينتمون للحركة الإسلامية، مطالبين بحقوق شعوبهم. وقد كشف هذا عن عمق أزمة التعدد الثقافي والهوية في السودان، والتي لم يتم التعامل معها بجدية.
خامساً: ضعف الحركات والتنظيمات المسلحة
على الرغم من كثرة الحركات المطالبة بالتغيير، فإن معظمها يفتقر إلى رؤى قومية شاملة، بل تتبنى أجندات قبلية أو شخصية، مما أضعف من فرص تحقيق تحول حقيقي. وغالباً ما تنتهي الاتفاقيات السياسية بتقاسم السلطة والثروة دون إحداث إصلاح مؤسسي حقيقي.
سادساً: ثورة ديسمبر 2018 وتحول الوعي السياسي
مثلت ثورة ديسمبر 2018 محطة فارقة في التاريخ السياسي السوداني، حيث عبّرت عن رفض شعبي عارم لنظام الإنقاذ العسكري الذي استمر ثلاثين عاماً. وقد أعادت هذه الثورة النقاش حول مفهوم الدولة المدنية والعدالة والحرية والمساواة.
أسس الأنظمة السابقة ، مليشيات قبلية مارست أبشع الانتهاكات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، خاصة في دارفور وجبال النوبة. وبعد رحيل البشير، ترك النظام تركة ثقيلة تمثلت في مليشيا “قوات الدعم السريع” وكتائب إسلامية داخل الجيش، إضافة إلى بقاء قادة عسكريين في الصف الأول يدينون بالولاء لتنظيم الإخوان المسلمين.
وبعد الثورة السودانية المجيدة في ديسمبر، برزت قوى إعلان الحرية والتغيير كتنظيم سياسي، إلى جانب قيادات من الحركات المسلحة التي وقّعت لاحقاً على اتفاقية “جوبا للسلام” مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي). جاءت هذه الاتفاقية في سياق تحولات سياسية كبيرة أعقبت الثورة، والتي بدأت جذورها عام 2015 بحملة “يسقط بس” التي أطلقتها حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، وتبناها لاحقاً “تجمع المهنيين السودانيين”، قبل أن تتوسع في 2018 لتشمل معظم مدن السودان مطالبة بإسقاط الحكم العسكري، وإنهاء هيمنة الإسلاميين، وحل المليشيات، وإنقاذ الاقتصاد، وتأسيس حكومة مدنية مستقلة.
اعتُبر نظام الإنقاذ أسوأ نموذج حكم مرّ على الشعب السوداني؛ فمعظم قادته مطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم البشير، وعلي كوشيب، وأحمد هارون، وموسى هلال -ابن عم حميدتي-. وعلى الرغم من سقوط البشير، ظل الشارع السوداني يطالب برحيل جميع رموز النظام السابق، ذلك النظام الذي أدخل البلاد في عزلة دولية، ودعم الإرهاب، واستضاف رموزاً مثل أسامة بن لادن، وتسبب في فرض حصار اقتصادي خانق، وانتهى بانفصال جنوب السودان عام 2011.
في 2019، وبعد سقوط النظام، أعلن الفريق ابن عوف حالة الطوارئ، لكنه لم يدم طويلاً، لتنتقل السلطة إلى المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه حميدتي. وفي الثالث من يوليو من نفس العام، اقتحمت قوة عسكرية مقر اعتصام القيادة العامة، وارتُكبت مجازر بحق متظاهرين سلميين، في جريمة اعترف بها عضو المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي بقوله: “كل الوحدات شاركت… وحدث ما حدث”.
مثل هذا الاقتحام بداية محاولة لإجهاض الثورة، خاصة بعد توقيع قوى إعلان الحرية والتغيير اتفاقاً مع المجلس العسكري، أدى إلى تشكيل حكومة مدنية برئاسة عبدالله حمدوك، رغم أن المحاصصات الحزبية وقوى سياسية موالية للنظام السابق تآمرت لإفشال الحكومة، بمساعدة عناصر داخل الجيش. ومع تصاعد الأزمات، قدم حمدوك استقالته، ما أدى إلى انقسام حاد داخل المؤسسة العسكرية، وقوات الدعم السريع، والحركات المسلحة، وقوى الثورة، لينتهي المشهد باشتعال الحرب في 15 أبريل.
الخاتمة:
يتطلب استقرار السودان مشروعاً وطنياً حقيقياً يعترف بالتعدد ويؤسس لدولة القانون والمواطنة. كما يجب إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية لتكون ضامنة للديمقراطية، بعيداً عن التسييس. ولا يمكن تحقيق ذلك دون تفكيك التكتلات الضيقة وتشكيل قوى سياسية حديثة تؤمن بالوطن أولاً.
السودان أرض البطولات والثورات(9)
سودان سواسوا 26 مايو 2025
كتب :حسين سعد
لمعرفة التشابهات والفروقات الرئيسة لدور الحركةالنقابية في ا لإنتقالين السابقين في أكتوبر 1964 ومارس/أبريل 1985، من جهة، والإنتقال في أعقاب ثورة ديسمبر 2018، من جهةٍ أخرى،نشير إلى مداخلة للدكتور الواثق كمير بعنوان (الناقبة والسياسية :دور الحركة النقابية في الإنتقال) قدمها في ندوة نظمها فرع الحزب الشيوعي في تورنتو، وأوضح كمير أنه سيركز على إنتقال 1985، لسببين، السبب الأول لأنه كان شاهداً وناشطاً في العمل النقابي، بحكم موضعي في اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم آنذاك، وثاني الأسباب أن الإنتقالين متشابهين في كثير من الجوانب (مثلاً: من حيث طبيعة الأحزاب السياسية والعلاقة بينها وبين النقابات، وأيضاً في مؤسسات الفترة الإنتقالية، وفي مدة الحكم الإنتقالي الذي لم يتجاوز العام الواحد في كلتا الحالتين (الحالتين). ولكن، تظل هذه المقارنة محكومة بنقطة منهجية ينبغي وضعها في الإعتبار، فالفترة الإنتقالية الراهنة، التي أعقبت سقوط نظام الإنقاذ، لم تكتمل بعد حتى يمكن مقارنتها مع الإنتقالين السابقين اللذين وصلا لنهايتهما المنطقية، وعلى رأسها الوصول إلى محطة الانتخابات، الحلقة الأولى في سيرورة التحول للديمقراطي، لذلك من الصعب معرفة التداعيات والمالآت لفترة الإنتقال الراهنة، وتكمنُ الدالة الوحيدة في قراءة المؤشرات المُتاحة.
قوة النقابات:
وأضاف الواثق :بالرغم من أن كل من الدولة والمجتمع المدنى بالسودان عموما قد اتسما تاريخياً بالضعف، إلا أن الحركة النقابية استطاعت أن تحتفظ بقدر من القوة و الحيوية حتى عام 1989، بالرغم من 16 عاماً من حكم نميري الشمولي، إذ ظلت تتمتع بنفوذ نسبي مقارنة بمنظمات المجتمع المدنى الأخرى،وأدخل نظام مايو (1969-1985) مفهوماً سياسياً جديداً على الحركة العماليه، (شركاء وليس أُجراء)، تحت مظلة شعار اتحاد القوى العاملة ووفق (قانون النقابات الموحد لعام 1971)، والذي ترك أثراً بالغاً على نقابات العمال مما قاد إلى إحجام بعض النقابات عن المشاركة في انتفاضة مارس/أبريل، (فقد برزت قيادات عمالية من داخل النقابات بعد انقسام الحزب الشيوعي في 1971). وهذا الوضع بدوره أفضى إلى تصدر النقابات والاتحادات المهنية للمشهد النقابي وإلى المساهمة المباشرة في إسقاط نظام نميري. مقارنة بسيطة بين دور اتحادات العمال والمزارعين (خاصة اتحاد مزارعي الجزيرة) في ثورة أكتوبر ودورهم في انتفاضة مارس/أبريل توضح تناقص وتقلص هذا الدور، فعلى سبيل المثال، كان نصيب العمال والمزارعين مقعدان وزاريان في حكومة سر الختم الانتقالية الأولى، بينما لم يكن هناك تمثيلا يُذكر للحركة العمالية واتحادات المزارعين في حكومة الجزولي دفع الله الانتقالية، ولا حتى في الحكومتين الانتقالين لثورة ديسمبر
إنقلاب 1989م:
شكلَّ انقلاب 30 يونيو 1989 نقطة تحول أساسية فى تطور الحركة النقابية السودانية، فبعد أن قامت سلطة الإنقاذ الإنقلابية في أول مراسيمها بحل كل النقابات، وإعتقال وفصل الآلآف من العاملين والقيادات النقابية، فرض النظام قانون النقابات لعام 1991، والذي إنحرف بشكل جذري عن تاريخ الحركة العمالية السودانية المتجذر في التقاليد الديمقراطية فيما يتعلق بتنظيم وتنظيم أنشطة النقابات العمالية. فالقانون عمل على تقييد الحرية النقابية والديمقراطية الداخلية بفرض العديد من القيود على النشاط النقابي، خاصة عدم التمييز بين نقابات العمال والمهنيين والفنيين والمعلمين. وبدلاً من ذلك، أصبحت النقابة تُعرّف ب “المَنشأة” التي تُخلط كل هذه المهن، واعتبارها مهنة واحدة، ف “العامل” هو أي شخص يؤدي أي نوع من العمل طالما أنه يكافأ في المقابل بأجرٍ أو راتب. وبهذا التعريف تم التغييب الكامل لمفهوم المصالح المشتركة للعاملين في مهنة واحدة. وهذا التطور بدوره أضاف عاملاً جديداً لإضعاف الحركة النقابية خلال حكم الإنقاذ خاصة في ظل التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وهو تحولٌ يتناقض مع مفهوم نقابة المنشأة.
أول الفروقات:
قامت التنظيمات النقابية فى السودان منذ نشأتها الأولى على أسس ديمقراطية. فالتنظيم الداخلى للنقابات يحكمه مبدأ الانتخاب الحر، من القواعد إلى الجمعية العمومية إلى المكتب التنفيذي، وتتميز بتعدد منابر اتخاذ القرار ونظامٍ للتفويض يُخضِعُ القيادات للمساءلة أمام قواعد العضوية، والتى تحتفظ بالحق فى استدعاء ومحاسبة أىٍ من القيادات. (وحتى قانون النقابات الذي صدر في عهد نظام الحزب الواحد، الاتحاد الاشتراكي، إلا انه سمح للنقابات بانتخابات حرة نزيهه، كما اسهم التجمع نفسه بفعالية، بعد إسقاط النظام، في إعداد مسودة قانون النقابات الذي أجازته الحكومة المنتخبة في 1987، والذي عطلته سلطة الإنقاذ، بينما ما زال الجدل محتدماً منذ سقوط النظام في أبريل 2019م إلى الآن حول قانون النقابات الذي تتم على أساسه إعادة هيكلة النقابات، وحتى مسودة القانون التي أعدتها وزارة العمل لم يتم التوافق عليها حتى هذه اللحظة. في رأيي، أن أي قانوني يحكم العمل النقابي ينبغي أن يخضع لنقاش واسع تشارك فيه قواعد النقابات، فهم أصحاب المصلحة الحقيقية.
الفرق الثاني
في مارس/أبريل 1985، كان هناك توافقٌ بين كل التيارات السياسية التي تنتمي إليها عضوية النقابة، وغالب القواعد والقيادات النقابية غير المسيسة (وهي الغالبية العظمى)، وكذلك على مستوى التجمع النقابي الذي ظل مُتماسكاً ومُوحداً حتى نهاية الفترة الانتقالية، بالعكس لما وقع من انشقاق في تجمع المهنيين إبان انتقال ديسمبر، حيث أصبح قسماً منه في مجلس شركاء الحكم، بينما اختار قسمٌ آخر أن يكون في موقع المعارضة. وكذلك، مكنت الطبيعة الديمقراطية للمؤسسة النقابية مشاركة كافة التيارات التي تنتسب لها العضوية في أجهزة النقابة بقدر ما تناله من أصوات. (مثال الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم + رئاسة النقابة العامة لأطباء السودان والنقابة العامة للمهندسين). إن انقسام تجمع المهنيين أمرٌ مؤسف ومُضر بوحدة ومستقبل الحركة النقابية المهنية، وهو نوع ٌمن الانقسام لم تشهده الحركة من قبل مع عدم وجود آليات ديمقراطيه لمخاطبته، مما يوجب التصدي له من القواعد والقيادات النقابية.
الفرق الثالث:
المجتمع السياسي الذي كان سائداً في 1985 (وقبلها في 1964) يختلف تماماً عن المشهد السياسي الذي أعقب ثورة ديسمبر، فقد كان هناك توافق بين التجمع النقابي والأحزاب السياسية على مؤسسات الإنتقال بعد التوقيع على ميثاق الانتفاضة، وفي العلاقة بين العسكريين في المجلس العسكري الانتقالي (ما عدا بعض الملاسنات خاصة حول قانون الانتخابات فيما يلي دوائر القوى الحديثة أو الخريجين)، وذلك في مقابل التشاكس والتوتر الذي يسم هذه العلاقة خلال فترة الانتقال الحالية،وأشار كمير الي الحزبين الكبيرين تبدلت وضعيتهما كما كانا في أكتوبر أو أبريل بل انقسم كُل منهما على نفسه إلى أكثر من فصيل، إضافة إلى تعدد الأحزاب وتناسلها، وظهور الحركات المسلحة في المشهد السياسي بعد توقيع اتفاق سلام جوبا. ومن ناحية، أخري، تعقدت مؤسسات الانتقال، إذ لم يكن هنالك مجلس سيادة ولا مجرد التفكير في مجلس تشريعي، ولم يكن هناك مجلس لشركاء الحكم (غير تحالف جبهة الهيئات مع الأحزاب في أكتوبر، وتحالف التجمع النقابي معها في التجمع الوطني لإنقاذ الوطن، وهي تحالفات سياسية وليست دستورية)، أما تجمع المهنيين، بالرغم من دوره التنسيقي المشهود، إلا أن قوى الحرية والتغيير مظلة واسعه وفضفاضة بين تكتلات تحالفية مختلفة ومتعددة، لم تترك له مساحة ليكون له نفوذاً مُستقلاً في الحكومة (الترشيحات لمجلس الوزراء الانتقالي في 1985، كانت بيد التجمع النقابي بالتشاور مع الأحزاب، وذلك بغض النظر عن النتيجة النهائية التي خيبت التوقعات).
الفرق الرابع: العامل الحاسم الذى ساعد النقابات فى تعزيز سطوتها الاقتصادية والسياسية يكمُنُ فى الموقع العضوى والاستراتيجى الذى كانت تحتله فى قلب المؤسسات الانتاجية والخدمية، التي كانت تملكها وتديرها الدولة. فقد نشأت الحركة العمالية واشتد عودها في ظل عهد هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، حتى أقدمَّ نظام الإنقاذ على إحداثِ تحولات رئيسة على صعيد البنيات والتوجهات الاقتصادية وسياسات ممنهجة، ولها دوافع سياسية ضيقة لصالح القطاع الخاص، خاصة القطاع الطُفيلي. فلم يعد هناك وجودٌ لسكك حديد السودان والنقل الميكانيكي والمخازن والمهمات، ومشروع الجزيرة ومشاريع النيلين الأزرق والأبيض والشمالية، فجفت مصادر سطوة اتحادات العمال والمزارعين. وهذا تحولٌ جدير بأن ينظم حواراً جاداً حول مآلاته على مستقبل الحركة العمالية(يتبع).
الأبناء… ضحايا الحلم المؤجل
سودان سواسوا 25 مايو 2025
كتب : صالح يحي
في عمق كل أبٍ حلمٌ لم يتحقق، أمنيةٌ أُجهضت على عتبة الفقر، أو سقطت في وادٍ من الاضطرار، أو ذبلت تحت سلطة العادات. يحمل الأب هذا الحلم، كحملٍ خفي، يضعه جانبًا حينًا، ثم يتذكره حين يرى ابنه يكبر… فيُسقطه عليه دون وعي، كأنه تركة شرعية، أو ميراث لا يجوز التنازل عنه.
لكن… هل الإنسان يُورّث الحلم؟
هل يمكن أن تُزرع شجرة في غير تربتها، وتُطلب منها الثمار؟
في مجتمعاتنا، كثيرًا ما يُعامل الابن كظلٍ لوالده، لا ككائن مستقل. يُجرُّ إلى مهنة لم يخترها، إلى نمط حياة لم يخطط له، إلى شريك لم يرَه بقلبه، فقط لأن “الأب يريد”. يتحول الابن إلى امتداد لإرادة غيره، لا إرادته.
وهنا يبدأ الصراع:
هل يكون الابن “مطيعًا” ويعيش عمرًا كاملاً على هامش الحياة؟
أم “متمردًا” يسير عكس التيار، ليُتهم بالعقوق والجحود؟
المفارقة الفلسفية هنا أن المجتمع يخلط بين البرّ والطاعة العمياء.
البرّ لا يعني أن تُلغي ذاتك، أن تُدفن في قبرٍ من التقاليد.
البرّ الحقيقي أن تكون صادقًا مع نفسك، أن تصنع حياة تليق بك، ثم تُهديها لمن تحب، لا أن تعيش حياتهم هم، وتخسر نفسك.
في عالم تتغير فيه القيم والمعايير، يصبح الإصرار على وراثة المهنة أو تكرار التجربة أمرًا عبثيًا. مهنة كانت عظيمة في زمن، قد تكون عبئًا في زمن آخر. وزواج مبني على تصوّر قديم للحب، قد يصبح سجنًا في حاضرنا المختلف.
فهل من العدل أن يتحمّل الابن وزر أحلام غيره؟
أليس من الظلم أن يُحاسب لأنه أراد أن يكون نفسه؟
إن التمرد في مثل هذه الحالة ليس تمردًا، بل صحوة.
هو استرداد للحق في أن نعيش بشروطنا، لا بشروط أُملِيت علينا.
دعونا نقولها بوضوح:
لسنا انعكاسًا لما لم يتحقق في حياة آبائنا.
نحن مشاريع مكتملة بحد ذاتنا، من حقنا أن نحلم كما نريد، لا كما أُريد لنا.
وفاة العشرات من السودانيين ، بعد 15 يوماً من العزلة في الصحراء
سودان سوا سوا 23 مايو 2025
كتب:حسين سعد
لقي (11) شخص مصرعهم بسبب العطش، بينهم نساء وأطفال، بعد أن نفد الماء والغذاء في ظل ظروف صحراوية قاسية. بينما نجا الآخرون بأعجوبة، حيث وصلت فرق الإنقاذ إليهم في اللحظات الأخيرة، مما يسلط الضوء على أهمية الإستجابة السريعة في مثل هذه الحالات الحرجة. هذه الحادثة تعكس مدى القسوة التي يواجهها النازحون، وتؤكد على ضرورة توفير الدعم الإنساني لهم. وإستطاع جهاز الإسعاف في مدينة الكفرة الليبية من إنقاذ (15) مواطناً سودانياً بعد أن عانوا من العزلة في الصحراء الكبرى لمدة (15) يوماً، نتيجة تعطل مركبتهم أثناء رحلة نزوح محفوفة بالمخاطر. هذه الحادثة تبرز التحديات الكبيرة التي يواجهها النازحون في سعيهم للهرب من الأوضاع الصعبة في بلادهم، حيث تزداد المخاطر في ظل الظروف القاسية التي تفرضها البيئة الصحراوية، تجدد هذه الحادثة الدعوات لتعزيز الإستجابة الإنسانية وضمان حماية المهاجرين والنازحين على طول طرق الهروب الصحراوية. فمع تزايد أعداد النازحين بسبب النزاعات، يصبح من الضروري تكثيف الجهود الدولية والمحلية لتوفير المساعدة اللازمة، وضمان سلامة هؤلاء الأشخاص الذين يواجهون مخاطر جسيمة في سعيهم للبحث عن حياة أفضل.
السودان أرض البطولات والثورات(8)
سودان سوا سوا 21 مايو 2025
كتب :حسين سعد
أكد خبراء نقابيون علي الدور الكبير الذي قامت به النقابات في الثورات في السودان قبل ، وبعد الإستقلال ،وأشاروا إلى إبعاد العمال والمزارعين في المشاركة في الحكومات الإنتقالية والرقابة عليها ،والإسراع في تنفيذ إصلاحات قانونية لصالح العمال والنقابات ،وتنظيم العمال والمزارعين ،والدفاع عن حقوقهم، والمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور، وتوفير الخدمات الاجتماعية لأعضائها، مثل الدعم الصحي والتعليم والإسكان. وقالوا ان إنشغال تجمعالمهنيين بالصراع السياسيأضاع فرصة كبيرة لوضع قانون للنقابات والإهتمام بإجراء انتخابات بالأجسام المهنية،ووصف صديق في ملف السودان أرض البطولات والثورات الذي يناقش عبر سلسلة من الحلقات نضالات العمال والنقابات ضد الانظمة المستبدة ،ووصف التجمع بأنه، لم يهتم بإجراء انتخابات او الاستعجال في تغيير القانون وانخراط في الصراع السياسي الذي أدي لإنقسامه وخفوت صوته، وأوضح الزيلعي ان تجمع المهنيين لعب دورا كبيرا في ثورة ديسمبر، ولكن بعد إنتصار الثورة، ضاعت فرصة قيام نقابات منتخبة خلال الفترة الإنتقالية وتابع( نحن نعاني من آثارها الآن) وأوضح ان الإنقسام الحالي سببه عدم خبرة من يعملون في النقابات حالياً وأشار الي ان إتحاد العمال تاريخياً تعرض لعدة محاولات للإنقسام لكنه عالجها بالخبرة النقابية.
وأشار صديق إلى نظام مايو عقب فشل إنقلاب يوليو 1971 عدلت السلطة قانون النقابات وأصدرت لائحة البنيان النقابي لسنة 1972 التي عدلت كل الهياكل النقابية. اثر ذلك على موقف النقابات ولكن ابتداء من 1973 بدأت المقاومة النقابية تشتد ووصلت قمتها بعد 1977 ( رغم صدر قانون جديد للنقابات يتبعها للاتحاد الاشتراكي) وصارت النقابات ( خاصة المهنية) تتمرد على سلطة الدولة والاتحاد الاشتراكي. لافتا إلى ان النقابات كانت تابعة لمكتب في الاتحاد الاشتراكي. ولم تتوقف الإضرابات والصدمات مع السلطة. وقال صديق ان النقابات رأت في تلك الفترة ان الوقت مناسب لعمل كبير لذلك أسستالتجمع النقابي من ستة نقابات وصار مركزا للمقاومة. وأوضح الزيلعي ان النقابات كانت منتخبة ديمقراطيا والقيادات موثوق بها من قواعدها. وهكذا دخلت معركة الانتفاضة بكل قوة وبعد سقوط نميري تم اسقاط كل النقابيين السدنة ديمقراطيا.
قيادة بلا قواعد:
ومن جهته قال الخبير النقابي محجوب كناري فان تجمع المهنيين الذي قاد الحراكالثوري لم يفتح الباب أمام العمال والمزارعين واقتصر الأمر على الأجسام المهنية فقط ،وهو ذات الحال حدث في ثورة مارس أبريل حيث أبعد التجمع النقابي، النقابات التي ساهمت في الثورة من المشاركة في الحكومة بعكس جبهة الهيئات التي أشركت النقابات والمزارعين في الحكومة الانتقالية، وأضاف حاولنا إقناع تجمع المهنيين بإدخال العمال والمزارعين لكنه رفض وأتهم الخبير النقابي كناري تجمع المهنيين بالانشغال في الصراع السياسي والابتعاد عن بناء التنظيمات النقابية جاهلاً البناء النقابي لذلك صار قيادة بلا قواعد،وأوضح كناري في ملف السودان ارض البطولات والثورات الذي يناقش عبر سلسلة من الحلقات نضالات العمال والنقابات ضد الأنظمة المستبدة ،قال ان الثورات الثلاثة التي ساهمت فيها النقابات لم تهتم بالرقابة علي الجهاز التنفيذي لذلك اصبح هنالك تناقض بين القيادات والقواعد الجماهيرية التي كانت لها مطالب محددة وتابع(هذا أضعف المكون الثوري وساهم في ردة الثورة المضادة)
رأس الرمح في التغيير:
وفي الأثناء قال عضو لجنة المعلمين عمار يوسف ان النقابات كانت لها إسهامات واضحة في كل الثورات والتغييرات التي حدثت بالسودان منذ تأسيس نقابة هيئة شؤون العاملين بالسكة حديد في العام 1947م،كما ساهمت في إخراج الإستعمار من البلاد والمساهمة الكبيرة في مناهضة الانظمة المستبدة وأضاف بالرغم من مساههمة النقابات في الاطاحة بالانظمة لكن ما ينتج من تغييرات لا يرتقي لطموحات العمال والنقابات،الذين يعتبروا أكثر شريحة منظمة لديهم مصلحة في إستدامة نظام ديمقراطي وحراسته،وأشار يوسف إلى وجود أوجة شبه بين دور النقابات في عامي 1985م و2019م حيث كانت النقابات رأس الرمح ،ورمانة التغيير.
دور تاريخي:
وفي المقابل قال الصحفي خالد فضل بالنسبة لأدوار النقابات في العمل السياسي في السودان ، هذه أدوار مؤكدة عبرالتاريخ ،ومصطلح الإضراب السياسي كان واحدا من تلك الأدبيات الثورية طيلة عهود الأنظمة الديكتاتورية في بلادنا، في الواقع تاريخ الحكم في السودان هو تاريخ المؤسسة العسكرية، وليس العمل السلمي والجماهيري الذي ظل لحوالي 60سنةفي خنادق المقاومة ، وتلك من المفارقات بالطبع، فالنقابات أسهمت بفعالية في تلك لمقاومة المستمرة، جبهة الهيئات لها القدح المعلى في إسقاط ديكتاتورية عبود في 1964م، بل شكلت حكومة الفترة الإنتقالية عقب سقوط الديكتاتور ، وفي عهد تسلط الجيش بقيادة النميري في حقبة مايو ظلت النقابات نشطة على جبهة الموالاة لأول عهد مايو ثم تحولت إلى خانة المقاومة بعد العام 1971م ،فالسمة الأبرز في نشأة وتطور النقابات السودانية هي إتجاهاتها اليسارية، وهذا أمر طبيعي في سياق القيم والأهداف التي تناضل من أجلها وهي نيل الحقوق للطبقات العاملة، كان التجمع النقابي بارزا في إسقاط مايو 1985م ورئيس الوزراء في الفترة الإنتقالية جاء على خلفية نقابية د. الجزولي ، عندما سطي الجيش علي السلطة الديمقراطية بإنقلاب الإنقاذ كان الإسلاميون قد فطنوا تماما لدور النقابات في المقاومة السياسية ،باعتبار ها تمثل الفئات الإجتماعية الأكثر وعيا، وهي منظمات حديثة كما معلوم لذلك كان الإستهداف الأول والرئيس منذ البداية للنقابيين والغمل النقابي نفسه، وبالفعل تم تدجين النقابات وجعلها واحدة من أذرع النظام للتسلط على العاملين بما يتنافى وطبيعة دورها.
إنقسام المهنيين:
إستمر هذا الواقع حتى ظهور تجمع المهنيين السودانيين إستمرارا لنسق المقاومة ، مع الأسف لم يستمر التجمع في لعب دوره كمنظمة تحفظ التوازن بين مختلف المكونات السياسية وتعبر عن الكتلة الثورية غير الحزبية فانقسم ، وكان هذا أحد أبرز الإحباطات في ثورة ديسمبر ، بالطبع الحديث عن النقابات اليوم يعيدنا إلى حقبة الإنقاذ مباشرة ، الآن يتم العودة الكاملة لجميع لافتات العهد المباد بمن فيهم الأشخاص على مستوى النقابات والمسميات وبالتالي لا يتوقع المرء أن يتجاوز دورها في هذه المرحلة تحديدا موالاة التيار المشعل والداعم للحرب ،كما ظلت طيلة فترة الإنقاذ، لقد تراجعت أولويات الحقوق في هذه الحرب المدمرة بعد النزوح واللجوء والتصنيف البغيض للمواطنين، وبات النقابيون الذين برزوا خلال فترة الانتقال القصيرة أهدافا للتخوين والملاحقة والفصل التعسفي ، فالشعار السائد لا صوت يعلو على صوت المعركة تلك حقيقة . ونذر الإنقسام الجهوي والإداري تسير على خطى متسارعة لذلك تبدو فرصة الدور النقابي ضئيلة في المجالات المطلوبة من وقف الحرب او نيل الحقوق للعاملين والمواطنين ، ولا نسى حالة الإستقطاب الحاد وسط القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومن ضمنها النقابات المهنية نفسها وهذا يعطل من نفوذها واسهامها
تجارب دولية:
ومن الأمثلة الباهرة على دور النقابات في المساهمة لإنجاح الانتقال السياسي،لعبت النقابات العمالية دورًا رئيسيًا في الكفاح ضد نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) وفي دعم التحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا، فكانت كونفدرالية نقابات جنوب أفريقيا أحد الأعضاء الرئيسيين في تحالف المعارضة الذي أدى إلى إنهاء الفصل العنصري، وفي بولندا، كانت النقابة العمالية (التضامن )بقيادة ليخ فاوينسا حافزًا رئيسيًا في التحول من نظام الحكم الشيوعي إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات،كما لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورًا كبيرًا في الانتقال السياسي بعد الثورة التونسية في 2011، حيث كان الاتحاد جزءًا من الرباعي الراعي للحوار الوطني الذي حصل على جائزة نوبل للسلام في 2015 لدوره في تحقيق الحوار الوطني والدفع باتجاه الاستقرار والديمقراطية.(يتبع)
السودان أرض البطولات والثورات(7)
سودان سواسوا: 20 مايو 2025
كتب :حسين سعد
في العام 2020م إنخرط مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية،في عقد مشاورات مطولة مع الأجسام النقابية بهدف التوافق علي قانون موحد للنقابات،وكنت في تلك الفترة ضمن الفريق العامل في الأيام حيث أجرينا مشاورات موسعة مع الخبراء في مجال النقابات،وكذلك الأجسام المهنية المكونة لتحالف المهنيين والقانونيين،ومكاتب النقابات في الأحزاب السياسية والمزارعين ،وبادرت تلك الكيانات النقابية والسياسية بطرح مسودة قانون للنقابات ،فعمل مركز الأيام علي جمع تلك القوانين لجهة وضعها في قانون موحد للنقابات،وفي ذات العام سلم وفد رفيع المستوي ضم ممثليين للأحزاب السياسية والنقابات وتجمع المهنيين ومركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية الذي كنت وقتها مديراً للاعلام بالمركز وضمن الوفد سلم الوفد وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في الحكومة الانتقالية الأولي لينا الشيخ مشروع قانون نقابات العاملين2020 م ،وبادر مركز الأيام بجمع كل المشاريع القانونية التي دفعت بها تلك الجهات وعقدت سلسلة من الاجتماعات والمشاورات حتي تم التوصل الي الصيغة القانونية،لمشروع القانون الذي يضم سبعة فصول حيث تناول الفصل الأول أسم القانون وبد العمل به بينما ناقش الفصل الثاني أهداف التنظيمات ومشروعية نشاطها،أما الفصل الثالث فقد تناول البنيان النقابي،وخصص الفصل الرابع لإدارة التنظيمات، والنظام الأساسي للنقابات والاتحادات في وقت ناقش الفصل الخامس التفرغ النقابي وضمانات أعضاء اللجان بينما ناقش الفصل السادس المسجل ونائبه وإجراءات إنشاء التنظيمات،تعيين المسجل وسلطاته واستئناف قراراته وأخيرا خصص الفصل السابع للعقوبات،بينما قالت المذكرة التي تم تسليمها مع القانون للوزيرة ان الذين شاركوا في الإجتماعات والمشاورات إهتدوا بالمبادي والمرجعيات الفكرية المتمثلة في تاريخ الحركة النقابية السودانية وما طرأ عليها من تأثيرات بأحداث سياسية واجتماعية واقتصادية فضلا عن الاهتداء باتفاقية الحرية النقابية وكفالة حق تنظيم النقابي واتفاقية (98) التي أصدرتها منظمة العمل الدولية التي حرمت تدخل المخدم في شئون النقابة، وعلي وجه التحديد إغراء العاملين بالإمتناع عن الإنضمام الي النقابة اوالتدخل في إدارتها،يذكر ان الجهات التي بادرت بمشروعات قوانيين هي :تجمع المهنيين -الحزب الشيوعي-الجبهة الديمقراطية للمحاميين-حزب الامة القومي-حزب البعث العربي الاصل -الحزب الوطني الاتحادي الموحد -تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية -النقابات الشرعية-المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان.
دعوة للنقاش والتوافق:
وفي نوفمبر 2020م،نظم مركز الأيام وبالتعاون مع مكتب النقابات بتجمع المهنيين السودانيين، ندوة (الحركة النقابية – الفرص والتحديات) بالقاعة الكبرى بوزارة التعليم العالي بالخرطوم ،وأبتدر محجوب محمد صالح الندوة، ودعا للمزيد من النقاش للتوفيق بين مشروعي القانونين، اللذين أعدتهما وزارة العمل، وتجمع المهنيين السودانيين بالتعاون مع مركز الأيام، وقال محجوب في ورقة قدمها في الندوة بعنوان: (الراهن النقابي بين الفرص والتحديات) أن المسألة لا تحتمل الانقسامات، لأن أغلب الأسس المتعلقة بتأسيس العمل النقابي، أصبحت متفقاً عليها وواردة في إتفاقيات ومواثيق دولية،وأشار محجوب، إلى أن مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية اهتم بمسألة النقابات في الفترة الانتقالية، ذلك حينما لاحظ تعدد مسودات قوانين النقابات التي بلغت (11) مسودات، ونجح في توحيدها في مشروع قانون واحد موحد لقي قبولاً من كل المشاركين في المناقشات، وقال إنه بعد أن تم تقديم مشروع القانون الموحد، اتضح أن هناك قانوناً آخر أعدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،ودعا محجوب، لبذل مزيد من الجهد للإسراع في توحيد مشروعي القانونين في قانون واحد، لتتسنى إعادة تأسيس الحركة النقابية على أسس متفق عليها من الجميع، وخاصة حسبما ذكر (أنه ليس هناك خلاف كبير بين القانونين)
النقابات والاتفاقيات الدولية:
ومن جانبه انتقد القانوني عمر الفاروق شمينا في ورقته (الحركة النقابية، القانون، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية)، انتقد قانون (المنشأة) الذي قال إنه ظهر لأول مرة في عام 1971 ووصفه بأنه استثناء، وبعد أن سرد شرحاً له، قال إن النقابة تقوم على الصنعة، الحرفة، المهنة والقطاعات وليس المنشأة،وشدد شمينا، على أن القانون الموحد الذي دفع به تجمع المهنيين للحكومة هو أكثر قانون عمالي ناضج، وأبان أنه نتاج جهد أكاديمي وفني ضخم مصحوب بتجربة عملية ثرة، وأشار إلى أنه لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث يتح الاستقلالية والوحدة والديمقراطية،وأبدى شمينا، استغرابه من دفوعات وزارة التنمية الاجتماعية والعمل بأن القانون الموحد هو قانون أحزاب سياسية، واعتبرها حجة واهية وضعيفة تؤكد المحاولات التي تود إبعاد الحركة النقابية من الساحة السياسية واستبدالها بمنظمات المجتمع المدني،كما انتقد شمينا، جمع العامل لعضوية نقابتين، وقال إن قوانين العمل الدولية تقول إنه لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة واحدة للعمال، ولفت إلى أن قانون الوزارة يجرد النقابات من أهم مميزاتها وهي الاستقلالية عبر تضمينها للسلطات الواسعة لمسجل العمل، وقال إن القانون الموحد الذي شارك هو في إعداده يعطي حق التسجيل لمسجل قضائي، وذكر أن الاتفاقيات الدولية تقوم على ثلاثة أضلاع هي (الحكومة، المخدمين، العمال)، وأن القانون الدولي يمنع تدخل تلك الجهات في حقوق وشؤون العمال..
مقاومة ومصادمة
ومن جهته شارك الخبير القانوني والنقابي صديق الزيلعي، بتسجيل صوتي من العاصمة البريطانية لندن، وتحدث عن السمات والمميزات التي تميزت بها الحركة النقابية في السودان، وأكد أنها بدأت واستمرت ديمقراطية تعمل على انتخابات القيادات من القواعد، إلا أن الفترات العسكرية والشمولية عملت على تدجين الحركة النقابية وجعلها خادماً للسلطة وليس العمال،وقطع الزيلعي، بأن النقابات ظلت مقاومة ومصادمة وتدافع بشراسة عن حقوقها وتعمل على صون الممارسة الديمقراطية، وتكافح الانقسامات التي تعتريها، بجانب دعمها وتأسيسها للحركات النقابية في الوطن العربي وأفريقيا،واعتبر الزيلعي، أن التحدي الذي تواجهه الحركة النقابية حالياً هو المحاولات المستميتة لإبعادها من السياسية، ودعا لإبعاد الأحزاب السياسية من النقابات، وليس إبعاد النقابات عن السياسة باعتباره حقها المشروع ويمثل دورها الوطني الرائد، وطالب بالمحافظة على التاريخ الناصع للحركة النقابية التي تميزت بالصدام والوطنية والوحدة والديمقراطية،وذكر الزيلعي، أن هنالك انقطاع أجيال وانقطاع معرفي نتيجة للتغييب المتعمد للنقابات طوال الـ(30) عاماً الماضية، ودعا لتأهيل وتدريب النقابيين المستقبليين، ونبه إلى أن النقابات قامت في السودان قبل إصدار القانون الذي ينظمها في عام 1948م، وامتدح التوحد الذي قام بها الأطباء وانضمامهم في جسم واحد، بالإضافة لدور رائد الصحافة محجوب محمد صالح، بقيامه بتوحيد الوسط الصحفي حول النقابة.
هجوم على العمل
وهاجم نقابيون وأعضاء في اتحاد عمال السودان (الشرعي) الذي قامت حكومة النظام المخلوع بحله بمجرد وصولها للسلطة، هاجموا محاولة النظام المخلوع قتل الحركة النقابية السودانية، وأبدوا استغرابهم من سلوك حكومة الثورة التي تعمل على السير في ذات نهج النظام المخلوع،وقال عضو اتحاد النقابات الشرعي عكاشة عبد الرحمن، إن من أبرز تحديات الحركة النقابية في الوقت الراهن هو قانون وزارة التنمية الاجتماعية والعمل التي تعمل على إجازته، ورأى أن هذا القانون يحتوي على مغالطات فنية واستراتيجية ضخمة، تقوض استقلالية وحيادية وديمقراطية الحركة النقابية،وأضاف أن حديث الوزارة عن مواءمة قوانينها مع منظمة العمل الدولية هو عبارة عن تغبيش للوعي، ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية تهدف لكسر شوكة الحركة النقابية،وفي ذات الوقت قال النقابي محجوب كناري، إن العمل النقابي في الأساس هو عمل سياسي مطلبي احتجاجي، وأكد على أن الفراغ النقابي الحالي هو عمل مقصود ومدبر له، وتابع: (هنالك جهات سياسية دولية ومحلية تهدف لإفراغ الحياة السياسية في البلاد من النقابات حتى يتسنى لها تمرير مشروعها السياسي والسيطرة على مفاصل البلاد) واعتبر كناري، أن هناك استهداف ممنهج للقيادات النقابية المستقبلية في الوقت الراهن، بهدف تحجم دورهم وتخويفهم وجبرهم عن التراجع عن مشاريعهم(يتبع).
السودان أرض البطولات والثورات(5)
سودان سوا سوا 3 مايو 2025
كتب :حسين سعد
يوم 30 مارس 2020م دفع عدد من الحادبين علي مصلحة البلاد بمذكرة للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير خاصة بالراهن السياسي ،والأداء العام لمنظومة قوى إعلان الحرية والتغيير،وركزت المذكرة علي قضايا تحديات الفترة الإنتقالية والبناء التشريعي والمنظومة الأمنية والسلام والوحدة الوطنية والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي المؤتمر القومي الدستوري، الاقتصاد ومعاش الناس، ووحدة قوى الثورة وإصلاح وتطوير منظومة إعلان الحرية والتغيير،وحذرت المذكرة من خطورة التدخلات الدولية والإقليمية باستخدام سلاح المال والاقتصاد على مستقبل الديمقراطية في البلاد ووجود اللوبي الاقتصادي المتحالف مع بقايا السلطة السابقة بحيث لا يسمح بالتفكيك الكامل للدولة العميقة لأنه يضر بمصالحها، سلبيات الإتفاق السياسي الذي نتجت عنه الوثيقة الدستورية المليئة بالثغرات والقنابل الموقوتة، نتيجة لتساهل الحرية والتغيير أنتج المنظومة الأمنية المسيطرة حاليا وكيانها الاقتصادي خارج السيطرة.
مخاطر حقيقية:
وقالت المذكرة هنالك مخاطر حقيقية تهدد النظام الديمقراطي في البلاد تتطلب منا جميعا اليقظة وتطوير الياتنا التنظيمية في قيادة الحرية والتغيير وجميع كتلها المشكلة لها إضافة لحشد كل قوى الثورة والتي أهمها لجان المقاومة وحركات الكفاح المسلح ، وأوضحت ان تمدد الأزمة الاقتصادية أدى إلى انحسار التأييد الجماهيري لحكومة الثورة ،وحاضنتها السياسية الحرية والتغيير ،ورددت (هذا مؤشر خطيريجب تداركه) وقالت ان عدم قيام المجلس التشريعي إلى الآن يشكل مؤشرا خطيرا، كون أن المجلس هو الجهة المنوط بها أن تقوم بتقييم وإقالة الحكومة و أفرادها وإجازات الإتفاقيات الدولية وإتفاقيات السلام ويحاسب ويوقف تجاوزات مجلسي السيادة والوزراء ، خاصة المكون العسكري، الى آخرمهامه المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
أخطاء التكييف الدستوري
ووصفت المذكرة مفاوضات السلام في جوبا بأنها تكتنفها أخطاء التكييف الدستوري لها وتغول مجلس السيادة على السلطات التنفيذية لمجلس الوزراء وتغييب مفوضية السلام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وغياب المجلس التشريعي ونقاش مواضيع مختلف عليها حتى داخل الحرية والتغيير مثل الهوية و العلمانية وعلاقة الدين بالدولة وهي مواضيع أتفق من قبل قيام الثورة على نقاشها في المؤتمر القومي الدستوري،قوى إعلان الحرية والتغيير مواجهة بمطالب الشارع والذي كان يتوقع سرعة إيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاح معاش الناس وإرجاع المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية وإزالة دولة التمكين والمحاسبة وتطبيق العدالة على جرائم النظام منذ يونيو 1989 وحتى مجزرتي القيادة العامة، فضلا عن إخفاق قوى إعلان الحرية والتغيير في إحتضان جميع القوى الحية التي ساهمت في إنجاح ثورة ديسمبر، خاصة لجان المقاومة والمرأة وتيار الإنتفاضة وتجمع القضايا المطلبية.
الواجبات والمسئوليات المتوقعة
عليه، فإن مجمل الواجبات والمسئوليات الملحة التي كانت ملقاة على عاتق حكومة الثورة و مؤسسات السلطلة الإنتقالية وقوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية ، كانت تتلخص في إدارة الثورة بشكل موحد لقواها حتى بلوغ مرحلة الحكم الراشد،ومواجهة مخاطر الدولة العميقة والقضاء على بقايا النظام الساقط،ومواجهة الحملة الدولية التي تديرها بعض الجهات الدولية الساعية لإفشال التجربة الديمقراطية في بلادنا وإحلال البديل الذي يخدم مصالحها، والقضاء علي الاثار السالبة التي خلفها النظام البائد،والبدء مبكرا في التحضير لعقد المؤتمر القومي الدستوري وعدم النتظار حتى اللحظات الأخيرة.
الأداء التنظيمي للحرية والتغيير
قالت المذكرة ان أجندة المجلس المركزي مزدحمة،وهذا نتاج مركزيته القابضة ، والتي نرى أن حلها يكون في إعطاء الأجهزة الأخرى الفرعية قدر من سلطة اصدار القرار بشكل لا مركزي وحرية تكوين التنظيمات الجماهيرية المختلفة،وإقترحت المذكرة تقسيم أعضاء المجلس المركزي اي قطاعات مثل (ادارة الثورة-وادارة الفترة الانتقالية-الدستور والقانون) ودعت المذكرة الي تفعيل المجلس الاستشاري باجتماعات دورية وإعتباره بمثابة جمعية عمومية أو مؤتمر عام وإعطائه صلاحيات واضحة وأن تكون توصياته وقراراته ملزمة، ويجب تعيين مقرر خاص له،وطالبت بإعادة النظر في الهيكلة الحالية ومراجعة تمثيل الكيانات، وفتح اللائحة (النظام العام) للمراجعة والتعديل حتى تواكب كل المستجدات والوضع الراهن،وشددت المذكرة هنالك مواضيع هي الأخطر وتتطلب سرعة البت حولها ضمانا لسلامة الثورة وحددتها في تكوين المجلس التشريعي مع الإحتفاظ بعدد من المقاعد لحركات الكفاح المسلح متى ما تم التوقيع النهائي على اتفاق سلام شامل..
إنشطارات أميبية:
وكان الأستاذ الجامعي الدكتور جمعة كندة قد لخص في ورقة قدمها في ورشة عقدها مركز الآيام للدراسات الثقافية والتنمية ،جذور الصراعات داخل القوي السياسية ومثل لها
(أ) إستمرار الدورة الخبيثة لأزمة الحكم، وعدم الأستقرار السياسى، وغياب ثقافة التداول السلمى للسلطة في السودان.
(ب) إحتكار شخصيات سياسية محددة داخل كل حزب لفرص الإستوزار، وتتحرك مثل هذه الشخصيات المحظوظة، من وزارة إلى أخرى.
(ج) ظهور إنشطارات أميبية داخل الاحزاب، تلك الأنقسامات ليس لخلافات جوهرية فى المبادئ والفكر أو المنهج،ولكن بسبب الضيق من الرأى والرأى الأخر.
(د) الفجوة بين النظرية والتطبيق وبين القيم والشعارات والسلوك والممارسة السياسية للأحزاب وقياداتها.
(ح) عدم قومية الأحزاب والحركات المسلحة (جغرافيا – جهويا- إقاليميا – دينيا – طبقيا – فئوياً – إجيالاً).
(خ) ضعف الأحزاب إقتصاديا ما لم تكن مشاركة في السلطة حيث يتم إستغلال المال العام ومؤسسات الدولة في تمويل وتنفيذ برامج الحزب.
التباين داخل مكونات الحرية والتغيير والحركات المسلحة
(أ) رغبة البعض في إعادة هيكلة الدولة السودانية قبل إجراء الانتخابات ورغبة الأخر في إجراء إنتخابات في فترة قصيرة.
(ب) مدى قدرة مكونات قوى الحرية والتغيير في مواصلة العمل المشترك لتفكيك نظام الحكم البائد وبين ترويج كل حزب لبرنامجه السياسية وبمرجعياته الحزبية تمهيدا للإنتخابات.
(ج)كيفية ضمان عدم التأثير السياسي الحزبي فيما ترشحه أي من مكونات قوي إعلان الحرية (محاصصة غير مباشرة).
(د) دور تجمع المهنيين في مرحلة الإنتقال كقوي مدنية غير حزبية هدفها التأثير الإيجابي في الممارسة السياسية والتداول السلمي والديقراطي للسلطة وليس السعي نحو المشاركة في السلطة نفسها ليس فقط في الفترة الإنتقالية بل ما بعدها. وفي بناء نقابات ومنظمات مجتمع مدني قوية ومستقلة وواعية بدورها في السلام والتنمية والحكم الراشد.
الحرية والتغيير وصياغة مشروع سياسي ثوري لإحداث ثورة حقيقية؟
(أ) التعامل مع الثورة المضادة دون الانجرار تجاه أساليبها القائمة علي العنف
(ب) تقديم ممارسة وسلوك سياسي جديد تحول الشعارات إلى واقع معاش (عدم الإقصاء – الديمقراطية – إدارة التنوع – النزاهة والامانة – الشفاهية – المحاسبة – سيادة حكم القانون – تحمل النقد ونكران الذات – أدب الأستقالة لتحمل مسؤلية ما تجاه فعل سياسي يستحق المحاسبة.
(ج) تحول شامل لبنية الدولة والمجتمع سياسيا وإقتصاديا وأجتماعيا وثقافيا
(د) قدرة أحزاب قوي التغيير والحرية علي الصمود موحدة لقيادة التغيير وتحقيق التحول الديمقراطي.
(ح) كيفية ضمان عدم التأثير السياسي الحزبي من مكونات قوى إعلان الحرية وغيرها من القوى السياسية على الذين يرشحونهم من شخصيات مستقلة لتولي المناصب الوزارية أثناء تأدية واجباتهم التنفيذية؟
(خ) مقدرة الحرية والتغيير في التعامل مع المؤثرات الخارجية الإقليمية والدولية مثل (محور-السعودية-الامارات) مقابل محور(قطر-ايران-تركيا) المحور الافريقي (الإتحاد الإفريقي والإيقاد والمؤيدة للتغيير وإقامة حكومة مدنية) مقابل المحور العربي (جامعة الدول العربية وموقفها البين بين) –المحور الأفريقي-العربي والأفريقي-الأفريقي)
مطلوبات الإنتقال الناجح:
(أ) البحث عن القاسم المشترك الاعظم الذي يسمح بمواصلة قوى إعلان الحرية والتغيير متماسكة بالرغم من تباين مرجعياتها الفكرية الحزبية طيلة الفترة الإنتقالية
(ب) توحيد الممارسة والسلوك والخطاب السياسي من مختلف الاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني، وقوى الحراك الثوري في بعض القضايا المحورية أهمها إصلاح المؤسسة العسكرية – قضية السلام – الديموقراطية – العدالة – الحرية – والسياسة الخارجية لإعادة السودان إلي وضعه الطبيعي بعيدا من سياسة المحاور والمحاور المضادة.
(ج) تعظيم دور الشباب وخلق ظروف سياسية ومدنية لإستغلال طاقات الشباب الثورية من أجل تثبيت الثورة وأهدافها المعبر عنها في قوى إعلان الحرية والتغيير وما ينتج عنها من وثائق ومؤسسات.
(د) إستمرار تجمع المهنيين في لعب دور المحرك للشارع ضد أى محاولات الثورة المضادة (لكننا نري ان تجمع المهنيين يعاني من مصاعب عديدة ونرجح تزايدها مستقبلا).
(ح) تعزيز أليات بناء الثقة من خلال العمل المشترك وبناء تحالفات إستراتيجية أو مرحلية بين مكونات قوي إعلان الحرية والتغيير تفاديا للإستقطابات لضمان فترة إنتقالية سلسلة تضع السودان في منصة الإنطلاق بلا عودة لفترة إنتقالية أخرى(يتبع).
العمال أصحاب الحق
سودان سوا سوا 1مايو 2025
كتب :حسين سعد
بحلول الأول من مايو من كل عام، تتجه أنظار العالم نحو عيد العمال، تلك المناسبة السنوية التي نستلهم منها قيم العمل والنضال، و نستذكر فيها تضحيات الطبقة العاملة ونضالها من أجل حقوقها ومكتسباتها، وفي هذا اليوم العالمي لعمال وعاملات السودان، نسوق لهم التهاني والتبريكات تقديراً لنضالاتهم ونقول لهم كما قال الشاعر محمد الحسن سالم حميد:العمال أصحاب الحق..هي البتقرر والتتولى..هي البتحدد سير المصنع..أيد العامل هي العد تنتج مو المكنات الامريكية..ودرن الأيدي العمالية انضف من لسنات الفجرة..ودين الدقن الشيطانية..ومن كرفت البنك الدولي..وكل وجوه الرأسمالية، جسارة عمال السودان، في مواجهة التسلط يحفظها تاريخ بلادنا ،فقد كانت للعمال والعاملات نضالات صلبة وإيمان راسخ بقيمة العمل ،وكانوا ومازالوا يقفون في ميادين الإنتاج المختلفة، من الزراعة إلى الصناعة، ومن الخدمات إلى الإبداع، يواجهون التحديات والصعاب بتصميم لا يلين، مؤمنين بأن الكرامة الحقيقية تنبع من العمل الشريف، وأن نهضة مجتمعاتنا لا تتحقق إلا بسواعدهم القوية وعقولهم الراجحة وعطاء بلا حدود،ويجسد هذا اليوم رمزية تاريخية لنضال الطبقة العاملة من أجل الكرامة والعدالة والحقوق، ويُعيد التأكيد على أن العمل ليس مجرد وسيلة للعيش، بل قيمة إنسانية ومصدر للكرامة، وجوهرٌ للتنمية والاستقرار والتقدم، وسدد العمال والعاملات فاتورة باهظة في ظل حرب منتصف أبريل الكارثية ،التي مزّقت البلاد، وتحملوا أثقال النزوح والفقر والحرمان، ومع ذلك ظلّوا في مقدمة الصفوف، يزرعون الأمل، ويصنعون الحياة، ويقفون في الطليعة رغم المعاناة والظروف القاسية، ونحن نقول لعمال في عيدهم العالمي ندعم نضالكم المشروع والعمل على ضمان بيئة عادلة تحفظ حقوقكم وتصون جهودهم في إطار دولة مدنية ديمقراطية، تحترم التعدد والتنوع، وتحقق العدالة الاجتماعية والعدالة الإنتقالية، وتصون كرامة الإنسان ، وفي الختام نردد مرة أخري ما قاله الشاعر حميد (بأسم السلام نبدأ..ﺭﺍﺣﺔ ﻏﻨﺎﻭﻳﻨﺎ..ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮﻭ ﺗﺘﻤﺪﺍ ﺳﺎﺣﺔ ﺣﻜﺎﻭﻳﻨﺎ..ﺑﻨﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﺘﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ..ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﺍﻝ ﻛﻔﻮ ﻭﻳﺤﻴﻴﻨﺎ..ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﻮﻧﺶ ﺷﻐﺎﻝ ﺻﻨﻌﺔ أﻳﺎﺩﻳﻨﺎ..ﻳﺎﺩﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﻮﺻﺎﻝ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻭأﻣﺴﻴﻨﺎ..ﺑﻲ ﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺯﺭﺍﻉ ﺑﻮﺍﺩﻳﻨﺎ)
نقابيون..العمال والمزارعيين ساهموا في كل الثورات لكن التغيير غير منصف لهم
سودان سواسوا: 30 أبريل 2025
كتب:حسين سعد
أكد خبراء نقابيون علي الدور الكبير الذي قامت به النقابات في الثورات في السودان قبل أو بعد الإستقلال ،وأشاروا الي ابعاد العمال والمزارعيين في المشاركة في الحكومات الإنتقالية والرقابة عليها والإسراع في تنفيذ إصلاحات قانونية لصالح العمال والنقابات ،وتنظيم العمال والمزارعين ،والدفاع عن حقوقهم، والمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور، وتوفير الخدمات الاجتماعية لأعضائها، مثل الدعم الصحي والتعليم والإسكان.
وقال الخبير النقابي محجوب كناري ان تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الثوري لم يفتح الباب أمام العمال والمزارعين وأقتصر الأمر علي الأجسام المهنية فقط ،وهو ذات الحال حدث في ثورة مارس أبريل حيث أبعد التجمع النقابي، النقابات التي ساهمت في الثورة من المشاركة في الحكومة بعكس جبهة الهيئات التي أشركت النقابات والمزارعين في الحكومة الانتقالية، وأضاف حاولنا إقناع تجمع المهنيين بإدخال العمال والمزارعين لكنه رفض وأتهم الخبير النقابي كناري تجمع المهنيين بالإنشغال في الصراع السياسي والإبتعاد عن بناء التنظيمات النقابية جاهلاً البناء النقابي لذلك صار قيادة بلا قواعد .
وقال كناري في ملف السودان أرض البطولات والثورات الذي يناقش عبر سلسلة من الحلقات نضالات العمال والنقابات ضد الانظمة المستبدة ،قال ان الثورات الثلاثة التي ساهمت فيها النقابات لم تهتم بالرقابة علي الجهاز التنفيذي لذلك صار هنالك تناقض بين القيادات والقواعد الجماهيرية التي كانت لها مطالب محددة وتابع(هذا أضعف المكون الثوري وساهم في ردة الثورة المضادة)
من جهته قال عضو لجنة المعلميين عمار يوسف ان النقابات كانت لها إسهامات واضحة في كل الثورات والتغييرات التي حدثت بالسودان منذ تأسيس نقابة هيئة شوؤن العامليين بالسكة حديد في العام 1947م،كما ساهمت في إخراج الإستعمار من البلاد والمساهمة الكبيرة في مناهضة الانظمة المستبدة وأضاف بالرغم من مساههمة النقابات في الاطاحة بالانظمة لكن ما ينتج من تغييرات لا يرتقي لطموحات العمال والنقابات.
وفي المقابل قال الصحفي خالد فضل النقابات لها أدوار مؤكدة عبرالتاريخ , ومصطلح الإضراب السياسي كان واحدا من تلك الأدبيات الثورية طيلة عهود الأنظمة الديكتاتورية في بلادنا . في الواقع تاريخ الحكم في السودان هو تاريخ المؤسسة العسكرية وليس العمل السلمي والجماهيري الذي ظل لحوالي 60سنة في خنادق المقاومة , وتلك من المفارقات بالطبع .. النقابات أسهمت بفعالية في تلك لمقاومة المستمرة جبهة الهيئات لها القدح المعلى في اسقاط ديكتاتورية عبود في 1964م , بل شكلت حكومة الفترة الإنتقالية عقب سقوط الديكتاتور في عهد تسلط الجيش بقيادة النميري في حقبة مايو ظلت النقابات نشطة على جبهة الموالاة لأول عهدمايو ثم تحولت إلى خانة المقاومة بعد العام 1971م .
مركز رؤية للسلام والتنمية
ومنظمة تاجة لدعم النساء، الفتيات والأطفال تطلق ( نداء إنساني ) بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة “طويلة” – ولاية شمال دارفور
سودان سوا سوا: 13 أبريل 2025م
تشهد منطقة طويلة بولاية شمال دارفور أوضاعاً إنسانية كارثية نتيجة تدفق أعداداً هائلة من الفارين من نيران الحرب الدائرة في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، حيث أصبحت المنطقة ملاذاً لآلاف الأسر النازحة التي وصلت في ظروف غاية في القسوة، في ظل غياب تام للمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني.
الوضع الراهن:
بلغ عدد النازحين أكثر من 10,000 شخص خلال الأسبوعين الماضيين.
الإحتياجات العاجلة:
-الغذاء والماء الصالح للشرب.
-المأوى (خيام، مشمعات، بطانيات).
-الرعاية الصحية الأولية والدواء.
-خدمات الصرف الصحي.
-دعم نفسي وإجتماعي للنساء والأطفال.
التحديات:
-شبه انعدام كلي للمنظمات الإنسانية والإغاثية.
-عدم وجود مراكز صحية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين.
-نقص حاد في المواد الغذائية ومياه الشرب.
-احتمال انتشار أمراض بسبب تلوث البيئة وضعف البنية التحتية
نداؤنا:
نحن في مركز رؤية للسلام والتنمية ومنظمة تاجة لدعم النساء،الفتيات والأطفال نناشد المجتمع الإنساني الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية بسرعة التدخل لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم العاجل للنازحين في منطقة طويلة.
نوجه هذا النداء إلى:
-مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
-برنامج الغذاء العالمي (WFP).
-المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).
-منظمة الصحة العالمية (WHO).
-جميع منظمات العون الإنساني الدولية والإقليمية والمحلية.
معلومات الإتصال: للتواصل والتنسيق:
-مركز رؤية للسلام والتنمية:visionsentere.vcpd@gmail.com
-منظمة تاجة لدعم النساء، الفتيات والأطفال: tajaorgwomen@gmail.co
إن الوضع في طويلة ينذر بكارثة إنسانية ما لم يتم التحرك العاجل، لذا نأمل من كافة الجهات المعنية الإستجابة لهذا النداء وتقديم العون العاجل للنازحين الذين يعيشون أوضاعاً مأسوية، ولا تزال هنالك العشرات من الأسر تنزح يومياً من الفاشر وما حولها.
قراءات في الوعي ‘بالمشروع الوطني ‘
سودان سواسوا: 13 أبريل 2025
كتب: الدومة علي
نائب رئيس مجلس التحرير الثوري- مكتب فرنسا – حركة/ جيش تحرير- قيادة السودان -أ. عبدالواحد محمد
( كوفي عنان) ‘مهمتنا هي مواجهة الجهل بالمعرفة، والتعصب بالتسامحّ
تتمثل مهمتنا في التصدي للجهل من خلال نشر المعرفة، ومواجهة التعصب الأعمى بالتسامح. ومن هذا المنطلق، يتعين علينا إدراك أن أساس هذه المهمة يبدأ بتشكيل مشروع وعي جمعي يخدم الشعوب المقهورة، التي عانت من التجهيل القسري عبر التاريخ. ويتطلب هذا المشروع جهودًا متواصلة لإخراج تلك الشعوب من مناهج تغييب الوعي التي فُرضت عليها، سواء كان ذلك عن عمد أو نتيجة لأنظمة استلاب ممنهجة خدمت مصالح فئات اختبأت خلف شعارات وطنية زائفة.
إن مشاريع استنارة العقول لا يمكن أن تنطلق إلا من قبل المستنيرين الذين تجاوزوا المصالح الضيقة، وتحرروا من القيود الفكرية المصطنعة، التي لا تعبر عن آمال الشعوب ولا تلبي تطلعاتهم، بل تُعمق الفجوة بينهم وبين مشروعهم الوطني الحقيقي. ومن هنا، تبرز أهمية نشر مناهج التنوير التي تواجه بشكل مباشر سياسة التجهيل الممنهجة، وتعمل على فضحها وإزالتها من الوجود، من خلال أدوات البحث العلمي والنقد الموضوعي، لتشخيص أسبابها، وتفكيك مرجعياتها، ثم بناء أسس فكرية جديدة تأخذ في الاعتبار معرفة جذور الأزمات وتحديد أهداف التغيير، المستمدة من فهم عميق لواقع تلك الشعوب.
غالبًا ما تتأسس تلك الأزمات على بنى مشوّهة أنشأتها مجموعات صفوية، انطلقت من دوائر ضيقة، سعت للهيمنة على مقدرات الأغلبية، من خلال السيطرة على الوعي الجماهيري واستغلال الموارد، مستخدمة في ذلك أساليب التلقين وترويج الشعارات المنمقة التي تتضمن سياسات “فرّق تسد”، بالإضافة إلى الخطابات الديماغوجية الموجهة لعامة الناس، والتي تتوافق غالبًا مع أيديولوجيات تلك الفئات، بهدف الحفاظ على امتيازاتهم التاريخية، حتى وإن أدى ذلك إلى سقوط الوطن في الهاوية، كما هو الحال في السودان اليوم.
وعليه، فإن المعرفة المنشودة يجب أن تُستمد من واقع الشعوب، عبر احترام ثقافاتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، ومعتقداتهم الروحية، التي ينبغي الاعتراف بها وتضمينها في الدستور الدائم، الذي يضمن الحقوق والواجبات بالتساوي بين جميع المواطنين، ويعزز قيم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة الكاملة.
وعندما تُحقق هذه الحقوق الإنسانية المشروعة وتصبح واقعًا ملموسًا، فإن التعصب سيندثر تلقائيًا، لأنه في جوهره نتاج أفكار رجعية وخاطئة، تعبّر عن الكراهية ورفض الآخر. وبزوال هذه الأفكار، ستسود قيم التسامح التي تخلق مجتمعات متماسكة، منفتحة على بعضها البعض، تحكمها المبادئ والأهداف التي نصّ عليها الدستور، وتعكس الإرادة الجمعية للشعب، ضمن إطار من السيادة الوطنية النابعة من وجدان الشعوب، بعيدًا عن أي تلاعب خارجي أو شعارات فكرية مُضلّلة.
الحرب.. خلفت دمار واسع في التعليم العالي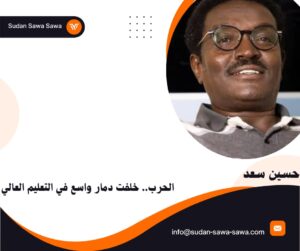
سودان سواسوا 12أبريل 2025
كتب: حسين سعد
اكدت دراسة دراسة معهد الاخدود الافريقي العظيم (اثر الحرب في السودان علي التعليم التعليم العالي ومجتمع البحث الاكاديمي) أكدت وجود 39 جامعة عامة قبل الحرب و25 جامعة خاصة وما لايقل عن 700 الف طالب وطالبة و14 الف من المحاضرين الجامعيين منهم 8 الف حاصل علي درجة الدكتوراة،وجاءت الدراسة باللغتين العربية والانجليزية من اعداد مني القدال وربيكا غيليد وتقع الدراسة في (43) صفحة تناولت ملخص تنفيذي وخريطة للمعابر الحدودية السودانية ومقدمة ومنهجية البحث وخلفية عن التعليم العالي في السودان ومؤسساته والحرب واثرها علي الطلاب والاكاديمين السودانين والتحركات الخارجية لكل من مصر واثيوبيا وجنوب السودان ويوغندا ودول شرق افريقيا.
وقالت الدراسة ان الحرب خلفت دمار ومعاناة لاحصر لها مما شكل تهديدا لمؤسسات مهمة علي امتداد القطر ومن ضمنها مؤسسات التعليم العالي التي لم تواجه تدميرا للمنشات المهمة فحسب لكن ايضا النزوح الجماعي للطلاب وهيئات التدريس وتعطل نشاط الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية بينما اعاد بعضها التموقع في بلدان اخري ولجأت اخري للدراسة عبر الانترنت بمقدرات شحيحة بينما استمرت بعض الجامعات في العمل بدرجات مختلفة اذا يعمل المعلمون ببطولة لمساعدة الطلاب لاكمال دراستهم وذلك من خلال كورسات الانترنت حيث يرسل المحاضرون محاضرات مسجلة مسبقا للطلاب عبر تطبيق تيلغرام وواتساب حتي وهم يعملون بنسة (60%) من رواتبهم التي هي اصلا منخفضة القيمة ومدفوعة علي شكل متاخرات كما تمكن مدرا الجامعات من تنظيم الامتحانات بشكل دوري في المناطق الامنة بالسودان التي تعمل فيها الوزارات الحكومية في الشرق لي وجه الخصوص وقد وفرت جامعة الخرطوم مواقع للامتحانات في مصر والسعودية وفي ذات الوقت عرقلت هذه الجهود لتنامي الحرب وكانت وزارة التعليم العالي قد شكلت لجنة تحت اشراف جامعة الجزيرة لمراقبة المؤسسات التعليمية المتاثرة بالحرب تتخذ من ود مدني بولاية الجزيرة مقرا لها وتصدر توجيهاتها من هناك ومع دخول قوات الدعم السريع الي ولاية الجزيرة في ديسمبر 2023م انتقل نشاط تلك اللجنة الي بورتسودان حيث صار مقرها الرئيسي نتذ الك الحين كما دفعت الحرب العديد من الاسر الي النزوح مرة ثانية وما صاحبها من انقطاع للانترنت فضلا عن فقدان بعض السجلات الاكاديمية بما فيها السجلات الجامعية ونهبت وبعضها دمر مثل المعامل والورش والمكتبات والقاعات والمكاتب الادارية وقد كان الدمار اكثر وضوحا في جامة امدرمان الاهلية حيث احرقت مكتبة وارشيف مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية وجامعة النيلين اما الجامعات خارج الخرطوم فقد كان الدمار فيها كبيرا لاسيما في دارفور مثل جامات زالنجي والجنينه ونيالا وكذلك جامة الجزيرة وجامعه البطانة بولاية الجزيرة
واوضحت الدراسة ان بعض الجامعات نجحت في حفظ نسخ رقمية من السجلات الاكاديمة بعيدا من المعارك مثل جامعة امدرمان الاسلامية وجامعة الخرطوم وجامة السودان للعلوم والتكنلوجيا وقد جرت عملية تامين السجلات الاكاديمية علي مدي ستة اشهر الي ثمانية اشهر علي الاقل في جامعة الخرطوم ولا زالت مستمرة في جامعات اخري اما الجامعات التي لم تصلها نيران الحرب فقد كان ليهم الوقت لحفظ سجلاتهم كما تباينت حالة السجلات الاكاديمية للجامعات الخاصة والاهلية حيث وفرت بعضها سجلات احتياطية في مخدمات خارج السودان وقد استطاعوا تطمين الطلاب علي سجلاتهم
اثار الحرب علي الطلاب والاكاديمين السودانيين..
مع اندلاع الحرب هرب الكثيرين من الخرطوم الي ولايات اخري او خارج السودان وكشف تقرير للمفوضية السامية لشوؤن اللاجئين بالامم المتحدة في اغسطس 2024م ان اكثر من (10.3) مليون اجبروا علي النزوح و(2.1) مليون الي بلدان اخري و(7.9) مليون داخل السودان وتمثل هذه الارقام الحد الادني وقد اخذا هذه البيانات عبر مراقبة معسكرات النازحيين داخليا والسودانيين المسجلين في البلدان المجاورة بوصفهم لاجئيين او طالبي لجوء وفي ديسمبر 2023م مع دخول الحرب الي ولاية الجزيرة ارتفعت اعداد الفارين من الحرب وبعضهم ترك ممتلكاته وامواله والحواسيب المحولة في الخرطوم نظرا لتوقعه توقف الحرب سريعا او خوفا من نهب تلك الاموال في الطريق عبر اللصوص ومن بين الفارين من جحيم الحرب اساتذة جامعات وموظفين وطلاب وطالبات وفي المناطق التي نزوحوا اليها كانت بعض المنازل غير مشيدة بشكل يناسب اعداد القادمين وكذلك ارتفعت قيمة الايجارات بشكل كبير لاسيما الذين نزحوا الي مدني ومن ثم الي سنار ثم سنجة ثم القضارف او كسلا او بورتسودان خلال هذه الرحلة فقدوا ما كان معهم من مال اما الذين ليس لديهم اقارب في تلك الولايات او لايملكون قيمة الايجارات الباهظة فقد سكنوا في معسكرات النزوح والمدارس هناك عدد قليل من الاستاذة والطلاب خارج السودان مقارنة بما هم في داخل السودان ليه يواجه الطلاب والخريجين صعوبات فريدة بينما يواجه طلاب الماجستير والدكتوراه الذين هم في مراحل البحث او الكتابة تعطيلا كبيرا وفقدان للبيانات وتقييد لمقدراتهم علي مواصلة ابحاثهم اما حال اعضا هيئة الاساتذة في الجامعات اوضاعهم هشه وبعضهم تم تسريحه او تغيير شروط توظيفهم وكانت وزارة التعليم الالي بطئية في ارسال اجور الجامعات استخدمت جامعة الخرطوم حساباتها الخاصة لتدفع لهئية تدريسها اجر شهر واحد لكن الجامعات العامة الاخري لم تتمكن من فل ذلك بعد شهور من الحرب كذلك اعلنت وزارة المالية نظاما يستلم بموجبه اساتذة الجامعات نسبة (60%)من رواتبهم لكنها ظلت تدفع علي نحو غير منتظم وعلي شكل متاخرات تاركة الاساتذة غير متاكدين متي يستلمونها ثانية وقد انخفضت قيمة مبلغ (60%) مع سقوط قيمة الجنية السوداني امام الدولار في السوق الموازي بينما ارتفعت اسعار السلع ارتفاعا صاروخيا كذلك النت وزارة المالية ايقاف اجور الاساتذة الجامعييين في دارفور نسبة لتوقف النشاط هناك بعض من الحديث ن ان جامعة زالنجي ستبداء نشاطها بولاية النيل الابيض لكن ذلك ليس مضمونا علي ايه حال اما اساتذة الجامعات الخاصة والاهلية وجدوا انفسهم في وضع اكثر صعوبة ميلة لهشاشة عقود عملهم وانعدام الدعم الاقتصادي من جامعاتهم كما الغت بعض الجامععات الخاصة التي نقلت دراستها خارج السودان الغت عقود عملها تاركة الاساتذة الجامعيين في السودان بلا عمل لتعين اساتذة جامعيين في مواقعهم الجديدة وعرضت بعض الجامعات علي الاساتذة عمل عن بعد في التعليم الاليكتروني وهذا يحتاج الي الانترنت وقيمته
التحركات خارج السودان
يبني الاكادميون والطلاب السودانيين قرارتهم مثل كل النازحين الي اين يذهبوا باوضاعهم الاقتصادية وروابطهم الاجتماعية فعملية النزوح مهلكة عقليا وبدينا واقتصاديا عند اندلاع الحرب كان السفر بالطيران مستحيلا حيث تم قصف مطار الخرطوم وحجز مطتار وادي سيدنا لطائرات الاجلاء الطارئة وقد تم معظم السفر عبر البصات والمركبات فر الناس الي حدود تشاد ومصر واثيوبيا وارتريا وجنوب السودان وفي الايام المبكرة بالبواخر الي السعودية تبايتنت الظروف في الحدود وتباينت متطلبات الدخول لم تتطلب البواخر نحو السعودية فيزا سارية فحسب لكن ايضا امكانية الصعود علي متن السفن تطلبت تصريحات اكثر علي كلا الجانبيين السوداني والسعودي في البداية اغلقت ارتريا واثيوبيا حدودهما رغم ذلك عبرها بعض الناس بحلول اغسطس 2024م كان اكثر من (47) الف في معسكرات قريبة من ولاية النيل الابيض الاوضاع مريعة وبعضهم تعرضوا لهجمات من مجموعات مسلحة عند دخول اثيوبيا من المتمة فان الناس مطالبين بالسفر بالبص الي قندر مباشرة حيث يحجزون طائرة بعدها الي اديسس ابابا اما الحدود مع تشاد كانت في حالة سيولة ومع بداية الحرب فر الكثيرين من الجنينه الي تشاد مع هذه الوضعية اتجه بعض من اساتذة الجامعات لاسيما النساء الي مهن اخري بديلة مثل اعداد الطعام وصنع وبيع المنجات السودانية مثل العطور والبخور لكسب المال واخرين الذين لديهم امكانيات فتحوا مخابز واعمال تجارية صغيرة وبعضهم لجاء للتدريس في المدارس الثانوية الخاصة مثل المدارس التي نلقت نشاطها الي مصر في كل هذ التحديات مضافة للتكلفة البشرية لهذه الحرب فقد قتل طلاب واساتذة جامعات اثناء القتال بين الاطراف المسلحة كما انهم ماتوا من انعدام الوصول الي العتاية الطبية الذي سببته الحرب حيث دمرت العديد من المنشات الطبية وكذبك مات اعضاء هيئة تدريس من كبار السن من حالات سببها الصددمة او فاقمتها
الاكادميون في مصر..
في مصر تضاعفت قيمة الايجارات ثلاث مرات في القاهرة حيث فاقم انخفاض قيمة الجينة المصري في اواخر 2023م اوضاع المعيشة المرتفعة م التضاعف السريع في سعر الدولار مقابل الجنية المصري كان الحصول لي الفيزا سهل نسبيا وعندما اندلعت الحرب غمرت الطلبيات القنصلية المصرية في وادي حلفا وفي الاشر من يونيو2023م اعلنت الحكومة المصرية ان كل المواطنيين السودانيين سيحتاجون الي الحصول لي فيزا للدخول صارت عملية التقديم صعبة لي نحو مضطرد مع عوائق اجرائية اكثر فاكثر ووقت انتظتار طويل م قوائم الانتظار الطويلة مع تدهور الاوضا في السودان لجاء العديدون الي تهريب انفسهم للدخول الي مصر هذه الملية مكلفة جدا
جنوب السودان
الدخول الي جنوب السودان عبر عدد من نقاط العبور في الغالب الاعم بر رحلة كوستي ثم الرنك من خلال ركوب رحلات طيران الي جوبا ونقاط اخري عبر اويل وملوط والنيل الازرق ودارفور هذه مكلفة والرحلات شاقة ومكلفة الذسن يسافروا الي جوبا لديهم خيار البحث عن عمل في جوبا او السفر الي يوغندا الرحلة اسهل عبر البصات او الطيران الي عنتبي الدخول الي يوغندا سهل جدا والفيزا بمبلغ 50 دولار وهي صالحة لمدة 3 اشهر وقابلة للتجديد الي ما مجموعه الكلي 6 اشهر يمكن للذين لايملكون المال للحصول علي الفيزا التقديم للحصول علي وضع اللاجئئين اذا ما سلموا جوازاتهم رغم انهم سنقلون بعدها الي معسكر اللاجئين في كرياندقو علي بعد 200 كيلومتر شمال كمبالا حيث الظروف اولية للغاية كانت جهود توظيف الاكادميين السودانيين اكثر بروزا بالنسبة للاطباء وغيرهم من الاساتذة الجامعيين بالكليات الطبية رغم وجود بعض التوظيف في كل المجالات جعلت حكومة جنوب السودان الامر يسيرا نسبيا بالنسبة للاطباء للممارسة الطب وقد خلق هذا تدفقا من الاطباء السودانيين الي المستوصفات السريرية الخاصة في جوبا وكذلك الجامات الخاصة والعامة في العام 2023م وبالرغم من انخفاض قيمة العملة في جنوب السودان لكن الاساتذة الجامعيين السودانيين يحصلون علي اجور جيدة نسبيا مقارنة مع المهن الاخري رغم ذلك فقد مروا بتاخيرات في الحصول علي اجورهم وان عليهم تغطية تكاليف معيشية جراء الاوضاع في جوبا
اثيوبيا
الوضع بالنسبة الي الاكادميين والطلاب السودانيين في اثيوبيا مشابه لوضع كل السودانيين الذين وصولوا الي اثيوبيا انتقالي علي نحو قصدي وغير مستقر يمكن للذين دخلوا بتاشيرة ان يمددوا تاشيرتهم لمدة ستى اشهرمقابل 600 دولار بعد ذلك يتوقع منهم المغادرة رغم انهم يستطيعون التقديم للحصول علي تاشيرة اخري علي المستوي العملي وجد المحاضرون السودانيين صعوبة شديدة في الحصول علي عمل نتيجة لبنية التعليم العالي في اثيوبيا والحدود المفروضة عليها بواسطة الدخول المالية والاولويات التليم العالي في اثيويبا شديد المركزية مع صدور القرارات المتعلقة بالقبول والميزانية والتوظيف من وزارة التعليم وفي حرب التقراي في الام 2020 الي 2022م فقدت وزارة التعليم العالي الكثير من تمويلها مما يعني ان ميزانيتها للتعينات الخارجية محدودة للغاية لكم هناك حاجة وامكانية للجامات الاثويبة لتوظيف محاضريين جامعيين سودانيين مؤهلين وعلي وحه الخصوص الحاصليين علي الدكتوراة والقادروين بالمحاضرة باللغة الانجليزية اما الطلاب السودانيين فهم يواجه وضعا اكثر صعوبة حتي فيما يتعلق باحتمالات التسجيل بالجامعات الاثيوبية يجب ان تاتي طلبات التقديم اما عبر وزارة التعليم العالي السودانية بواسطة وزارة الشوؤن الخارجية السودانية قبل ان ترسل الي وزارة الشوؤن الخارجية الاثيوبية ومنها الي وزارة التعليم وترسل من هناك الي سلطات النعليم والتدريب الاثيوبية للنظر فيها لتحدد معادلة الطالب ومستواه قد يقبل الطالب لكن يتطلب منه دفع الرسوم الدراسية كاملة
الاكاديميون في يوغندا
لاتشارك يوغندا حدود مباشرة مع السودان السودانيين الداخلين الي يوغندا عليهم العبور الي جنوب السودان عم طريق السفر بالبر او عبر الطيران الي عنتبي من بورتسودان مما يرفع كلفة الوصول اليها بينما تتسم سياسة يوغندا مع اللاجئين مفتوحة نسبيا السودانيين الذين لا يملكون المال للحصول علي التاشيرات او للسفر اللاحق عند وصولهم الي الحدود اليوغندية يجلبون الي معسكر لاجئيين في كرياندمقو علي بعد 200 كيلو متر جنوب الحدود للحصول علي وضعية اللاجئي الفرص في هذا المعسكر محدودة بالنسبة الي المحاضريين الجامعيين حيث انها تركز علي الزراعة يمكن للحاصلين علي بطاقة لاجئي ان يوفوا علي نحو منتظم بواسطة شركة او جامعه او معهد بدون اذن عمل وهذه افضلية كبيرة بما ان الاذونات تكلف مابين 500 الي 2500 دولار في السنة اضافة الي ذلك يمكنهم فتح حساب بنكي والعمل ضمن الاقتصاد الرسمي ايضا لغة التدريس باللغة اللانجليزية تعتبر عائق امام العديد من الاكاديميين السودانيين
الاكاديميون في شرق افريقيا
الاوضاع في اقطار شرق افريقيا بما فيها كينيا وتنزانيا ورواندا اشبه بالاوضاع في يوغمدا بينما توجد فرصة السفر بالطيران من بورتسودان الي نيروبي يتطلب السفر الي تنزاينا او راومدا بورا اضافيا عبر البر او الطيران عبر بلد اخر لذلك عدد الجالية السودانيية في البلدان اصغر رغم ذلك فقد ذهب عدد منهم الي كينيا للعمل في الامم المتحدة او المنظمتن غبر الحكومية التي انتقلت الي هناك القليل من الجامعات السودانية اعادت التموضع في شرق افريقيا مثل جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا التي تعمل من رواندا وتنزانيا كان توظيف المحاضريين وتسجيل الطلاب محدود نتيجة لاسباب مماثلة لتلك التي في يوغندا تعوق الاكاديميون والطلاب الحاجة الي اللغة الانجليزية والفرنسية والسواحلية
الاكاديميون في الخليج
يمكن للسودانيين الوصول الي الخليج عبر الطيران والبواخر الحركة الي الخليج بما في ذلم السعودية وقطر والامارات علي تالروابط الاجتماعية ولي المقدرة علي التقديم للتاشيرات ضمن ارضية قانونية متحولة معظم الاكادميون السودانين والطلاب الذين سافروا الي الخليج فعلوا ذلك بمساعدة من الموجودين هناك سلفا وقد امن بعضهم التاشيرات عبر كفالة العائلة بينما فعل اخرون ذلك عبر العلاقات المهنية وشبكات اخري
التوصيات
1-يمكن تطوير المنح متوسطة الحجم لمساعدة الجامعات السودانية في الانتقال الي التعليم عبر الانترنت والتعليم عن بعد وتخصيص تمويل للطلاب لشراء سعات الانترنت لتنزيل المحاضرات
2- الدعم التقني والمادي للجامعات السودانية لتطوير منصات للتعليم الاليكتروني
3- منح طؤاري للمحاضريين السودانيين لاسيما المهجرين خارج السودان
4- علي المؤسسات الدولية العاملة في حفظ المنشات الثقافية والعلمية توظيف علماء سودانيين ذوي التخصصات المتعلقة بهذه المجالات.
السودان أرض البطولات والثورات(1)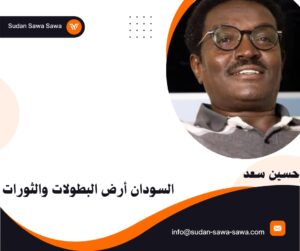
سودان سواسوا 10أبريل 2025
كتب :حسين سعد
عندما إندلعت ثورة الياسمين في تونس كنت قد كتبت تحليل في صحيفتنا أجراس الحرية قبل إغلاقها من قبل نظام المؤتمر الوطني في يوليو 2011م جاء ذلك التحليل بعنوان (من تونس الي السودان الهم واحد والحل أيضا) فالشعب السوداني المعلم مفجر الثورات وأرض البطولات إستبق دول عديدة في تفجيره للثورات الشعبية ،وعقب إستقلال السودان عام 1956 حدثت عدة ثورات قامت ضد الحكومات العسكرية المستبدة وكان أولها عام 1964 ضد نظام الفريق إبراهيم عبود والثانية في 1985ضد نظام المشير جعفر النميري والثالثة في ديسمبر 2019 ضد نظام المشير عمر البشير، ونجحت هذه الثورات في الإطاحة بكل هذه الأنظمة، ويعتبر الشعب السوداني أول من يطلق ثورة شعبية في إفريقيا والوطن العربي،واليوم ونحن في أبريل 2025م وبعد مرور سن النبوة علي ثورة مارس ابريل 1985م ، التي إطاحت بالنميري ،ومرور سبع سنوات علي إعتصام القيادة العامة في أبريل 2019م الذي أطاح بالبشير ، يجب ان نستلهم الدروس والعبر،لخيبات الامل والنكاسات كما أسماها الاستاذ عمار الباقر في مقالاته بعنوان(في ذكري ثورة ديسمبر) حيث جاءت النكسة الاولي عقب التوقيع علي وثيقتي الاتفاق السياسي والوثيقة الدمستورية وأتت بحكومة الفترة الانتقالية الاولي. وهنا تجدر الاشارة الي أن هذه النكسة قد أضعفت الثورة ولكنها لم تنجح في قتلها،وسوف نتناول أيضا وبالتحليل العميق الطبقة السياسية التي تصدرت المشهد السياسي وكنت قد كتبت في كتابي (حلم الثورة وتحديات الانتقال) فصل عن وحدة قوي الحرية والتغيير ،ومكوناتها، التي كانت تحديـات عديـدة وتتصاعـد حــدة الخلافــات يومــاً بعــد يــوم وتتزايــد معهــا نقــاط الخــلاف، إلا أن تلــك الخلافــات باتــت خطيــرة للغايــة لأســباب عديــدة، ولاحقاً تمزقت قوي الحرية والتغيير وإستنزفت كل الاسماء حتي وصلت الي تقدم وصمود لكنها لم تصمد أمام الرياح العاتية ، وأيضا نشير الي النقابات ودورها في التغيير ؟وماهو نصيبها من خيبات الامل والانتكاسة؟وقصور الاعلام في الحكومة الانتقالية في دعم الانتقال الديمقراطي ،والتبصير بالإخطاء والتقليل من حدة الصراعات القبلية التي أطلت بشكل واضح أيام الحكومة الانتقالية في كل من دارفور، والخرطوم وجنوب كردفان وكسلا وبورتسودان والجزيرة،ومحاولات تصفية الثورة حتيالتي قتلت المدنيين وشردتهم وتهديدها لنحو بالمجاعة،وتدهور الاوضاع الاقتصادية والصحية والمعيشية،وحملة الاعتقالات الواسعة حيث مات البعض خلف تلك السجون والمعتقلات للدعم السريع والاغتصابات والانتهاكات الجنسية البشعة التي وثقتها تقارير المنظمات الحقوقية،ومن أجل المصلحة العامة نحاول إجراء مقاربات لاستلهام الدروس أيضا من إنتفاضة مارس أبريل 1985م، ونعيد أيضا ما كتبه الاستاذ تاج السر عثمان بعنوان (في ذكراها الأربعين ما هي دروس انتفاضة مارس – أبريل ١٩٨٥؟)
بأسمك الأخضر يا إكتوبر:
في 21 أكتوبر سنة 1964 أندلعت ثورة شعبية ضد نظام الراحل الفريق إبراهيم عبود مطيحةً بنظامه وكانت أول ثورة شعبية في افريقيا والعالم العربي،إنطلقت الثورة من جامعة الخرطوم بعد مقتل الطالب بالجامعة أحمد القرشي، وكان تشييعه شرارة الثورة،حيث تغني الفنانان السودانيان الشهيران محمد وردي ومحمد الأمين لثورة أكتوبر، وما يزال السودانيون يذكرون هذه الثورة الشعبية بكثير من التقدير والحفاوة
باسمك الاخضر يا اكتوبر الارض تغني..والحقول اشتعلت قمحا ووعدا وتمني
والكنوز انفجرت في باطن الارض تنادي…..باسمك الشعب انتصر
حائط السجن انكسر..والقيود انسدلت جدلة عرس في الايادي
كان اكتوبر في امتنا منذ الازل..كان عبر الصمت والاحزان يحيا
صامدا منتصرا حتي اذا الفجر اطل..اشعل التاريخ نارا واشتعل.
كما ردد الشعب مع الشاعر الراحل هاشم صديق..
لما لليل الظالم طول وفجر النور من عينا اتحول.. قلنا نعيد الماضي الأول
ماضي جدودنا الهزموا الباغي وهدوا قلاع الظلم الطاغي
وفي ليلة وكنا حشود بتصارع عهد الظلم الشب حواجز شب موانع
جانا هتاف من عند الشارع.. قسما قسما لن ننهار طريق الثورة هدى الأحرار
والشارع ثار.. وغضب الأمة اتمدد نار والكل يا وطني حشود ثوار
- ثورات أبريل،وديسمبر:في السادس من أبريل 1985م أندلعت ثورة أبريل ضد نظام جعفر نميري بالعاصمة والاقاليم، وجاءت تلك الثورة الظافرة عقب إعلان نمبري حالة الطؤاري بالبلاد، وتمدد موجة إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية والوقود،وفي العام 2013م اندلعت إنتفاضة سبتمبر 2013م عقب رفع حكومة المخلوع البشير للدعم عن السلع الاستهلاكية والوقود ،وفي العام 2016م أندلع إضراب اطباء السودان ،إعتراضاً علي الإهمال الحكومي المتعمد لقطاع الصحة ثم جاء الاعتصام في العام 2017م ، وفي ديسمبر 2018 وذلك بعد شهور من انعدام البنزين وشح في العملة النقدية المحلية والارتفاع الشديد لأسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني. استمرت الثورة لمدة 4 أشهر حتى يوم 6 أبريل 2019 كانت أكبر دعوة لاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة داعيين لاسقاط نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم وضد نظام العسكر والمخلوع عمر حسن أحمد البشير، وعليه تم خلع الرئيس وبإعلان مجلس عسكري انتقالي في نهار 11 أبريل 2019، لم يرضى الشعب برئيس المجلس (الفريق أول ركن/ عوض ابن عوف) الانتقالي الذي كان محسوبا على النظام السابق، وفي نهار يوم 12 أبريل 2019 تنحي عن منصب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وتم تنصيب (الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان). ورغم ما حدث استمر الثوار بالاعتصام حتى تحقيق مطالب ثورتهم، ولكن ازداد عدد الشهداء لأكثر من الضعف، ووقعت مجزرة غدر وخيانة في أخر أيام شهر رمضان الفضيل في فترة مفاوضات الطرف الثوري قوى اعلان الحرية والتغير، والمجلس العسكري إلى ان تم الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الدستورية في 17اغسطس 2019م(يتبع)
سودان سواسوا 8 أبريل 2025
الروائى. محمد عبدالله
“طعنات سامة تستهدفني، غرسوا أنيابهم في جلدي، ولكن لم يعد يؤلمني أكثر من أشواك المؤامرات، وخبث تسلطهم، يستأثرون بالسلطة والمال، وترسانات ضخمة من الأسلحة، دمروا مستقبل وآحلام الأطفال، قوانينهم ظالمة، قلوبهم مفطورة على إرتكاب أبشع الجرائم، هؤلاء لا يريدون قلماً يفتح مسامات الوعي لدى جماهير الشعب، فقط يريدون قلماً يكتب لهم عن القيل والقال وتزوير الحقائق، فقط يريدون أقلاماً تكتب لهم علي أنهم عادلون ومُنجزون ومُنصفون وجميلون وأتقياء وأنقياء، وليسوا هم بحاجة إلى أقلام تفجعهم بالحقيقة، وببشاعة ما يرتكبونه من إنتهاكات وجرائم بحق الوطن وأبنائه، وهم مستعدون لإستخدام كل أدوات المكر والإجرام لإسكات تلك الأقلام، ولكن لهم بالمرصاد يا أباليس الإنس والجن”..
(جهر) أوقفوا الحرب القائمة على اجساد النساءالصحفيات السودانيات يعملن بمهنية عالية، فى ظروف وأوضاع قاهرة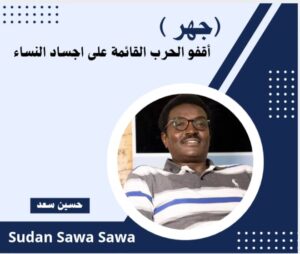
كتب:حسين سعد
سودان سواسوا: 9 مارس 2025
شدد صحفيون لحقوق الانسان (جهر) علي ضرورة وقف إستهداف الصحفيات والصحفيين ،ووقف الحرب وعدم الافلات من العقاب فى الجرائم المرتكبة بحق الصحفيات والصحفيين
وقالت جهر في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتزامن في الثامن من مارس من كل عام قالت :مع تصاعد النزاع المسلّح فى السودان، بين طرفيها الرئيسيين (القوات المسلحة) و(قوات الدعم السريع)، والجماعات والمليشيات والحركات المتحالفة معهما، أصبحت النساء، والنساء الصحفيات، أهدافاً مباشرة للعنف، والاضطهاد، والاستهداف الممنهج، الذي وصل حد القتل، والتعذيب، والإخفاء القسري، والعنف، والعنف الجنسي، فى هذه الحرب الكارثية التي تخلّى طرفاها عن قواعد القانون الدولي الإنساني، وعن الالتزام بمسئولياتهم الدولية، فى التعامل مع المدنيين/ات، والأعيان المدنية، كما تخلّوا عن واجباتهم فى حماية وسلامة المدنيين، وفى مقدمة المدنيين، الصحفيات والصحفيين، وغيرهم/ن من الفئات المدنية الأخري، من مقدمي ومقدمات الخدمات الصحية والطبية، وعمّال وعاملات الإغاثة الإنسانية، وجميعها من الفئات المجتمعية المدنية، التى يجب أن تحظي بالحماية، وفق القانون الدولي الإنساني.
ووصفت جهر اليوم العالمي للمرأة بانه يومٌ عزيز على قلوب النساء، والصحفيات السودانيات، وعلى قلوب النساء فى العالم أجمع… ياتي الاحتفال – هذا العام – تحت شعار “الحقوق والمساواة والتمكين، لجميع النساء والفتيات، من أجل مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً للجميع”، وهو شعار يُراد منه الدعوة إلى “العمل على تسريع الإجراءات التى من شأنها أن تفتح الباب أمام المساواة فى الحقوق والقوّة والفرص للجميع، ومستقبل نسوي لا يتخلّف فيه أحد عن الركب”.
وقالت ان اليوم العالمي للمرأة، هذا العام يأتي ،والعالم يشهد أزمات جديدة، ومتداخلة، كما يشهد تراجعاً وتآكلاً مريعاً فى الحقوق، وبلادنا – السودان – لا تزال ترزح تحت وطأة الحرب الكارثية المدمّرة، التي اندلعت فى عاصمة البلاد فى صباح يوم السبت 15 أبريل 2023، واتّسعت رقعتها لتشمل كل البلاد، ومازالت رحاها تدور على أجساد النساء السودانيات، تهجيراً قسرياً من مراتع صباهن، وبيوتهن، ومدنهن وقراهن، وأماكن عملهن، وقد أصبحت هذه الحرب المروّعة والباطشة “حرب على أجساد النساء”، بحقٍّ وحقيقة، لا مجاز، وقد استهدفت حرب السودان، النساء والفتيات، تقتيلاً فظيعاً، وعنفاً ممنهجاً، وأصبح سلاح الاغتصاب والاختطاف والإخفاء القسري، و”السبي” للنساء والفتيات، من الأسلحة الفتاكة، التى أُستخدمت فى هذه الحرب الكارثية، وبصورة ممنهجة، وحاطة للكرامة الإنسانية للنساء، وقد أُضطرت آلاف النساء لمغادرة أماكن إقامتنهن الطبيعية، نزوحاً وتهجيراً، وتشتيت شمل الأُسر، بسبب الاستهداف الممنهج للنساء، ليواجهن تكبُّد مشقّات وصعوبات البحث عن ملاذات آمنة، فى مناطق النزوح داخل الوطن، وأمكنة، وأزمنة اللجوء فى دول المنطقة العربية، والإفريقية، بحثاً عن الأمان الجسدي والنفسي والعائلي، فى ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية بالغة السوء والتعقيد.
وأضافت فى هذا المناخ المعادي للنساء، تواصل الصحفيات السودانيات مسيرة كفاحهن ونضالهن الجسور، فى القيام بواجباتهن المهنية بمسئولية عظيمة، ومهنية وإحترافية عالية، فى ظروف وأوضاع قاهرة، يستحيل العمل تحتها، وقد أجبرت الحرب العشرات منهن للنزوح الاضطراري والإجباري، إلى مناطق آمنة نسبيّاً، داخل البلاد، أو للفرار بجلودهن من حضن الوطن، إلى المجهول، بحثاً عن الحصول على بطاقات اللجوء، أو الإقامة القانونية، فى ما وراء الحدود، ومازالت هناك، عشرات الصحفيات، يقبعن فى قلب الخطر، يواجهن مصيراً مجهولاً وقاتماً فى محرقة الحرب، واستمرارها المتزايد، فى مناطق سيطرة طرفي الحرب، يواجهن تحديات الحياة، والمعيشة ونقص الدواء ومعينات العمل، وصعوبات أداء رسالتهن المهنية، فى البحث عن الحقيقة تحت ركام البيوت، التى هدمها القصف الجوّي العشوائي، وهدير المدافع، والمسيّرات الحربية.
ودعت المجتمع الصحفي، والمجتمع المدني السوداني، لرص الصفوف، وتجميع الجهود، وشحذ الطاقات والهٍمم، لبناء أوسع تحالف مجتمع مدني سوداني، مناهض للحرب، ولخطاب الكراهية والتمييز، ويدعو للسلام والحرية والعدالة، ويعمل لوقف الحرب، من موقعه المستقل، ويلتزم بوضوح تام، بمبدأ المساءلة لطرفي الحرب، وكل الجهات المشاركة معها، فى انتهاكات حقوق الإنسان فى السودان، مع التأكيد على عدم إفلاتهم من العقاب، لارتكابهم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز نسيانها أو إخضاعها لمساومات أو تسويات سياسية، تتغاضي عن تحقيق العدالة، والانصاف، وجبر الضرر، لضحايا النزاع المسلّح فى السودان.
الجدير بالذكر ان الاحتفال هذا العام يتزامن مع الذكري الثلاثين لإعلان ومنهاج (إعلان بكين) الصادر فى عام 1995، واعتماد الوثيقة التاريخية الهامة الصادرة عنه، المتعلقة بحقوق المرأة، فى جميع أنحاء العالم، وبخاصّة، الحق فى الحماية القانونية، والوصول إلى الخدمات، وإشراك الشابات والشباب، والتغيير فى المعايير الإجتماعية والصورالنمطية والأفكار العالقة فى الماضي.
مع نساء السودان في عيدهن يجب وقف الحرب وتحقيق العدالة
بقلم.. حسين سعد
سودان سوا سوا: 9 مارس 2025
إحتفل العالم يوم السبت الموافق الثامن من مارس الحالي باليوم العالمي للمرأة، تخليداً لنضالاتها وجسارتها وعطائها ،تقديراً لكفاحها اليومي والدوؤب، بلا حدود من أجل تأمين العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للناس كل الناس ،وفي مدن وقري وفرقان السودان جاءت هذه المناسبة العظيمة وبلادنا مثخنة بحرب 15 أبريل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع حيث سددت النساء السودانيات فاتورة باهظة الثمن لهذه الحرب الكارثية تمثلت في القتل والاغتصاب،والعنف الجنسي، والتشريد والنزوح الجماعي والقسري للقري والمدن كما حدث في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنجة وغيرها من الولايات التي تاثرت بالحرب التي إمتدت تداعياتها لتشمل غياب تام للخدمات الصحية والتعليمية وتفشي العطالة والفقر وإنتشار للسلاح وغياب الامن، ومعاملة الملايين من النساء كمواطنين من الدرجة الثانية، حيث إنهن عديمات الحقوق، فضلاً عن تعرضهن الى أشكال مختلفة من التمييز الصارخ الذي تندى له جبين الإنسانية،ولا يتقاضن الأجور سواء التي تكفل معيشتهن وتأمين حياة اسرهن، او تضاهي ما يتقاضاه الرجل، وتتنصل الدولة عن القيام بمسؤوليتها تجاه الأطفال من حيث توفير دور الحضانة ورياض الاطفال مما يثقل كاهل المرأة ، وتفرض عبودية العمل المنزلي عليهن، ويتعرضن للاغتصاب جراء الحروب ، وتفشي العنف المنزلي ، فضلاً على ذلك ، فرض القوانين التي تقوض من مكانتها وتسلبها حق الاختيار في نمط الحياة ونوع العمل والشريك وتمتعها بحرية التنقل والسكن وحضانة الأطفال، كما سنت عشرات القوانيين المناهضة للمرأة مثل النظام العام والاحوال الشخصية، وسلب حضانة الأطفال من المرأة وشيوع زواج الطفلات ،مشكلات عديدة وعصية إستحكمت حلقاتها علي النساء السودانيات وأحالت حياة الناس إلي جحيم،وبحسب تقارير لمنظمات عالمية فهنالك أكثر من 10 مليون نازح بسبب الحرب منهم نحو (90%) نساء وأطفال،وهنالك أكثر من 5 مليون سيدة وطفلة تواجه خطر الاعتداءات الجنسية، وهناك تقارير مقلقة عن وجود أسواق لبيع النساء في السودان. وفي مواكب ومظاهرات ثورة ديسمبر المجيدة كانت المراة السودانية في مقدمة الصفوف والمواكب ،وعندما جاءت حكومة الثورة تم تهميشهن وإستبعادهن من مراكز صنع القرار في الحكومة الانتقالية وذلك بالرغم من مساهماتهن وتضحياتهن النبيلة حيث تم وعدهن بتخصيص نسبة 40% للتمثيل النسائي لتلبية تطلعات النساء السودانيات لكن ذلك الوعد لم يحقق، والنسب التي نالتها النساء كانت أقل مما وعدن به، مما يعكس إخفاقاً في تلبية تطلعات النساء السودانيات والاعتراف بدورهن الحيوي في المجتمع والعملية السياسية، ونري ان الخلاص من ذلك الكابوس ، بوقف الحرب وتحقيق العدالة والانصاف هو تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء والابتعاد من نهج الحكم الحالي القائم علي المحاصصات القبلية والمحسوبية وتغيير شامل في منهجية إتفاقيات السلام التي لم تحقق لبلادنا سوي المزيد من الحروب وتمدد خطاب الكراهية والعنصرية التي حلت مكان المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ، وعندما يبداء الحراك في عمليات السلام كما حدث في فترات سابقة يتم إقصاؤهن في الوقت نفسه من المشاركة في العملية السياسية الرامية لوقف الحرب وتحقيق السلام ،وأحيانا نري مشاركة صورية لبعض النساء، فمن الدروس المستفادة العديدة من تجارب تحقيق السلام في السودان وحماية النساء هي ان بلادنا لديها تاريخ طويل من الإفلات من العقاب، كما إن عدم محاسبة مرتكبي الفظائع لا يشكل عائقًا أمام العدالة الانتقالية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى استمرار دائرة العنف هذه، حيث صارت العديد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي وقعت في إقليم دارفور منذ سنوات، تتكرر في الخرطوم والجزيرة ،وسنجة والنبيل الابيض ،وأماكن أخرى ، فالافتقار التام للعدالة يعكس فشل الدولة السودانية والمجتمع الدولي، ويرسل رسالة للضحايا مفادها أنهم لا يستحقون العدالة، وأن الجناة يمكنهم مواصلة أفعالهم دون خوف من العواقب، وفي اليوم العالمي للمرأة، نقول بأنه لا حرية للمجتمع دون تحرر المرأة، ولا معنى لاية معايير إنسانية ومتمدنة ومتحضرة دون تحقيق المساواة التامة للمرأة وتمتعها بجميع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المساوية، وانهاء كل القوانين التي تمس مكانة المرأة وماهيتها وكرامتها الإنسانية،وفي ظل الحرب الحالية بالسودان ندعو المجتمع الدولي بوضع ملف النساء خلال هذه الحرب ضمن أولويات المفاوضات الجارية والمستقبلية، وضمان أنها تحظى بالحماية الكاملة وأن أطراف النزاع لا يعتبرون النساء واحدة من ساحات الحرب المشروعة التي يمكنهم خوضها والإفلات بعد ذلك من العقاب كما جرت العادة. إضافة لتعزيز المساواة وتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل القرار 1325 حول النساء والسلام والأمن، والتي تدعو إلى زيادة مشاركة النساء في جميع جهود الوقاية من النزاعات وحلها والعمل علي تضمين قضايا النساء بشكل فعال في محادثات السلام والمفاوضات الانتقالية، وضمان تمثيلهن بنسب تتناسب مع واقعهن ومساهماتهن في المجتمع. النساء في السودان لسن مجرد ضحايا فهن أيًضا قائدات ومحركات رئيسية للتغيير والسلام، ويجب اعتبارهن شريكات في عملية بناء سالم مستقبل السودان. ويجب أن نتذكر أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان لن يكون ممكنًا دون معالجة جذور المشاكل التي تعاني منها النساء في السودان وضمان حقوقهن بشكل كامل. الوقت قد حان لتغيير السردية وتركيز الجهود على بناء مستقبل يضمن للنساء مكانة يستحققنها في قيادة ووضع لبنات السلام للسودان الجديد وفي الختام نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للنساء في العالم أجمع وفي السودان بشكل خاص بحلول عيدهن العالمي ونردد مع شاعر الشعب محجوب شريف (صباح الخير مساء النور..يا ست البيت وست المكتب الفاتح على الجمهور..حلال وبلال عليك يا ام مرتب بالتعب ممهور..وتقومي دغشا بدري.. رتبتي القميص والطرحة…حفظتي النشيد والسورة..أحب القرقريبة والهبابة)
أهم مظاهر السلوكيات المرتبطة بالتعصب:

كتب : عاطف محمد أحمد
مهتم بدراسة العلوم الإنسانية
سودان سوا سوا :6 مارس 2025
1. تغير اللفظي داخل حدود الجماعة: لذلك يتصرف هذا أقل أو يعبر عن التعصب، حيث لا يقوم الفرد ليصبح الأذى صادقا في الإبداع. يعالج الأشخاص الذين يعانون من بعض حالات التعصب الحديثة إلى سلبًا أمام هؤلاء الأصدقاء والمقربين، أو في بعض الأحيان أفراد جماعتهم.
2. التوقف عن تجنب أو التحاشي : اتخاذ خطوات لتفادي التعامل مع الأعضاء القياديين الذين لا يبغضونها الفرد، بغض النظر عن مدى ذلك. وفي هذه الحالة، نجد أن الشخص المتعصب لا يوجه الأهتمام المباشر إلى الجماعة بالتفصيل بالكراهية، ولكن يبتعد تماماً عن أي تفاعل مع أعضائها، مما يضمن الالتزام بالتجنب.
3. التمييز بالتمييز أو التفرقة : يبدأ هذا السلوك مؤشرا على بداية ظهور التدريب العشبي، حيث تخصص الشخص المتعصب إلى أعضاء حرمان المبدعين التفاصيل من الحصول على التسهيلات والامتيازات التي يفخر بها الآخرون. ويتم ذلك من خلال القوانين التي تحكمها السلطات في بعض المجتمعات بشكل صريح، كما هو الحال في السودان حاليا واشتهر سابقا.
4. العنف والعدوان الجسدي : ناشط الكارهة بين المبدعين، في ظل حالات الانفعال الشديد، إلى مستوى من العنف والعدوان الجسدي على أعضاء الجماعة ولكن بالكراهية.
5. الإبادة الجماعية: هذه المرحلة من مراحل العداوة والكراهية بين المبدعين، حيث تشمل الإبادة الجماعية أو تشكل دون بداية، أو أي من أشكال العنف الجماعي.
أصوات الاستغاثة تتعالى وسط جحيم الحرب…!
سودان سواسوا 2 مارس 2025
كتب: أنس يعقوب
تتعدد وسائل القتل في المناطق ، حيث تتفجّر البراميل إلى استخدام أرض جو- أرض أهداف سامية المحظورة الأيرلندية، مما يؤدي إلى زعامة المسلمين في المجتمع. هذه واستعملت نطاق الأسلحة وتجاوزات القانون الدولي التجريبي. في هذه الظروف، برزت أصوات تنبعث من المنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية لمكافحة الأمراض، حيث ناشدت حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبدالواحد محمد أحمد النور، بالإضافة إلى بعض المنظمات المحلية، والمنظمات الدولية والحقوق الإنسانية بالشأن، وكذلك منظمات الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لتوفير الخدمات الغذائية والصحية والاجتماعية للمدنيين في مناطق مختلفة من السودان، من خلال فتح ممرات آمنة لقوافل الصليب الأحمر الدولي ومنظمات أخرى. لكن، لم تتجب أطراف متباينة إلى حد كبير للتسامح، وخاصة الجيش السوداني، الذي يعتبر أن الوقت قصير للعبور القوافل ورفض فتح ممرات الحدودية المفتوحة بشكل غير فعال، مما يؤدي إلى فشل المرضى سلاحًا أخيرًا ضد الجميع.
إن العمل على إنهاء الحرب من خلال فترة زمنية جديدة ، في ظل الظروف الراهنة والحالة الراهنة نتيجة لمنصة نيروبي، هناك خطوة نحو تحقيق التغيير الجذري. وواصلت الأحداث للأطراف المتنازعة للا لم مبادئ القانون الدولي التطبيقية، وخاصة فيما يتعلق بحماية المناطق.
الجيش السوداني (سلاح الطيران الحربي): العقاب الجماعي والخضر لقواعد الحرب!
السودان: سودان سوا، 26 فبراير 2025
كتب: أنس يعقوب
الحرب… ليست كالإعلان عنها، فالأشخاص الذين يعيشون تحت وطأتها لا يحبون الكبسولات التي يطلقون شرارتها. في خضم تنافس، وجدت ضحايا وأبرياء لا علاقة لهم بالصراع، وقد شهد العالم منذ ستينيات القرن الماضي تحولات جذرية في مجالات الحرب. من خلال هذه التغييرات، القوى العاملة المتنازعة من النظام هيمنتها ونفوذها في الفضاءات الأخرى. بفضل تميز تلك التحولات هو التقدم التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي، الذي دخل في جاكوت، حيث تم تصميم طائرات مقاتلة متنوعة خصيصًا لتدمير العسكري والقدرة على الوصول إلى أحد متخصصين عسكريين على أيدي جديدة. ومع هذه الثورة الاستراتيجية، أصبحت الحروب أكثر دموية ودمارًا، مهدرةً أرواح البشر ومواردهم.
وبناءً على ذلك، أصبح مصير الإنسانية أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى. وفي ظل أهمية قضية الوجود البشري، اجتمع الأعضاء في الأمم المتحدة لعقد مؤتمر أُطلق عليه لاحقًا اسم الاتفاق المعني بحقوق المدنيين في مناطق النزاع، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1949، حيث تم الإعلان عن قوانين الحرب وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
السودان، تلك الأرض الواسعة، تحمل تاريخًا مثقلًا بالحروب، حيث تحمل المدنيون العبء الأكبر من ويلات هذه الصراعات. ومن الجدير بالذكر أن الحرب التي بدأت في 15 أبريل 2023، انقسمت إلى معسكرين، يسعى كل منهما إلى القضاء على الآخر، مكونين مليشيات من جهة، وأتباعهم من جهة أخرى، وكل منهما يعد العدة كقنبلة موقوتة ضد خصمه. وقد تلوح في الأفق حرب فاصلة قد تحدث قريبًا أو بعيدًا، ولكن ما لن يحدث هو وحدة هذين الأضداد، حتى وإن حقق أحدهما انتصارًا ساحقًا، إذ سرعان ما ستتفتت تلك الوحدة إلى آراء متباينة.
أما التاريخ الحربي للسودان، فهو مليء بالغارات الجوية على جنوب السودان وأجزاء من كردفان ودارفور، وخاصةً حرب الجيش السوداني ضد حركة جيش تحرير السودان في مناطق جبل مرة، حيث كانت تُنفذ دوريات جوية متتالية تُسقط البراميل المتفجرة على كل من يجرؤ على الظهور، مما بث الرعب في قلوب من تبقى أحياء، فضلاً عن تدمير المنازل فوق رؤوسهم.
الحرب الحالية في السودان تمثل وصمة عار جديدة على جبين الجيش السوداني، حيث تبرز الاعتداءات الفظيعة والمنظمة ضد المدنيين باستخدام سلاح الجو. تشير التقارير الطبية والمعلومات المتاحة إلى أرقام كبيرة لعدد الغارات الجوية منذ بداية النزاع، وما خلفته من دمار للبنية التحتية والآثار الوحشية في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى عدد الضحايا من المدنيين والجرحى. وتستمر الانتهاكات بلا حدود، حيث تتعرض المناطق المختلفة للقصف بناءً على سيطرة الدعم السريع أو بسبب وجود مكونات اجتماعية معينة.
المقاومة المدنية من أعماق الأرض:
في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع في السودان، وفشل مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين، لجأ السودانيون إلى حفر أنفاق في باطن الأرض والاختباء في الكهوف في المناطق الجبلية الوعرة، حيث يواجهون الموت جوعًا، بينما تتعالى أصوات استغاثاتهم.يستغيثون برب العرش العظيم… يا الله، إنهم فقط يقصفون، ولا يدركون الأذى الذي تسببه قذائفهم المتفجرة..! وفي لحظات أخرى، يناشدون الطيار برحمة… يا من ارتفعت إلى السماء، ارحمنا… (هذه العبارات تعكس لغات المكونات الاجتماعية المدنية التي تعرضت للقصف الجوي والمدفعي).
مدخل نفسي لظاهرة التعصب والتفرقة العنصرية في المجتمع السوداني
[1]
الكاتب: عاطف محمد أحمد
مهتم بدراسة العلوم الإنسانية
يتعين على الجميع العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بناءً على الجنس أو اللغة أو الدين. يجب أن تُراعى هذه الحقوق والحريات بشكل فعلي، كما تنص الفقرة (ج) من المادة الخامسة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك، لا يزال التعصب السلبي والعلاقات العنصرية السلبية من أقسى المعاناة التي يواجهها الكثيرون في عصرنا الحالي، على الرغم من التقدم الذي حققته البشرية في مجالات الحياة المختلفة.
تعريف التعصب:
في اللغة العربية، يُشتق التعصب من العصبية، التي تعني نصرة الفرد لعصبته سواء كان ذلك ظلمًا أو مظلومية. قدم علماء النفس العديد من التعريفات لمفهوم التعصب، حيث ركزت هذه التعريفات في البداية على نوع واحد فقط، وهو التعصب السلبي، أكثر من التعصب الإيجابي. قد يكون السبب في ذلك أن الظواهر النفسية والاجتماعية تبدأ بالاهتمام من الزاوية التي تعوق أو تتعارض مع متطلبات التوافق السلبي والتكيف الاجتماعي. يُعرف التعصب بأنه حكم انفعالي يؤدي إلى تفكير الفرد وسلوكه بطرق تتماشى مع حكم سابق، بناءً على دليل منطقي غير مناسب، ويقوم على أساس نسق من القوالب والتصورات الجامدة.
أهم خصائص التعصب:
1. يُعتبر التعصب اتجاهًا نفسيًا، وبالتالي له ميل نحو اتجاه من المكونات الرئيسية للمعرفة، وهي المعرفة والانفعالية الوجدانية والسلوكية.
2. يتضمن حكمًا مسبقًا لا أساس له ولا يوجد سند منطقي يدعمه.
3. يؤدي وظيفة لمتبني الاتجاه التعصبي، أي يُحقق غرضًا يضمن له الإرضاء الذاتي.
4. تلعب المجارة دورًا هامًا في تبني مواقف التعصب والاستجابة وفقًا لها، حيث يتعامل الشخص المتعصب مع الأمور الاجتماعية بشكل أعمى تجاه الجماعة التي ينتمي إليها.
مظاهر التعصب:
1. *السياق القومي:
يتمثل التعصب في حب الوطن والغيرة عليه والعمل لصالحه قبل المصلحة الشخصية، والشعور بالانتماء له، والتضحية من أجله، والثقة في المنتجات الوطنية، وفي قدرة البناء الوطني على الابتكار، وكراهية الدول الأخرى المعادية التي تهاجم دون سبب واضح أو تحاول نشر الشائعات العدائية ضد الوطن عبر وسائل إعلامها.
2. السياق الديني:
يتمثل في الإيمان بأن نجاح الإنسان في حياته يعتمد على اعتناق دين معين دون سواه، والتعاطف مع الأشخاص الذين يدينون بنفس الدين عند تعرضهم لمأزق، وذلك من خلال تقديم المساعدة لهم، والثقة والصداقة والمصاهرة فيما بينهم، والتحمس للدفاع عن الدين، والالتزام بأداء الشعائر الدينية في أوقاتها، والنفور من من يعتنقون دينًا آخر، والشعور بالتهديد كلما زادت قوة الدين الآخر، وعدم الموافقة على إقامة علاقات مع أفراد الدين الآخر سواء في شكل علاقات صداقة أو عمل أو تقديم أو تلقي خدمات معينة.
3. السياق السياسي:
يدور مضمون التعصب حول تبني فكرة سياسية معينة والدفاع عنها بشتى الطرق، والإيمان بأنها الوحيدة الصحيحة والهادفة، والسعي للانضمام إلى الحزب السياسي الذي يمثل هذه الفكرة، وصعوبة تقبل الأفكار الأخرى المخالفة، والغضب الشديد من أي محاولة لنقدها، وعدم الارتياح للأشخاص الذين تختلف معتقداتهم عن تلك الأفكار والمعتقدات السياسية التي يتبناها الفرد.
*السياق الرياضي:*
يتجلى في الميل نحو تشجيع فريق رياضي معين دون غيره، والشعور بالانتماء إليه، والاعتقاد بأنه يتفوق على باقي الأندية. كما يظهر هذا الميل في تقدير مهارات لاعبيه الفنية التي تُعتبر متفوقة مقارنةً بلاعبي الأندية الأخرى، بالإضافة إلى الشعور بالحزن الناتج عن الهزيمة.
السياق الطبقي:
يُحدد التعصب في هذا السياق بالاعتقاد في ضرورة اقتصار التفاعلات الاجتماعية على الأفراد الذين يتشابهون في المستوى المادي أو الاجتماعي، أو الذين يقيمون في نفس المنطقة السكنية. كما يتضمن ذلك إقامة علاقات الصداقة أو الزواج مع هؤلاء الأفراد، والاقتناع بضرورة معرفة كل شخص لحدوده الطبيعية وعدم تجاوزها. يُعتقد أيضاً بوجود فروقات بين أبناء الأغنياء والفقراء في الذكاء والسمات الشخصية، مما يؤدي إلى تفضيل بعضهم على بعض بناءً على خصائص ثابتة.
السياق التمييز بين الجنسين:
يكشف هذا السياق عن الاتجاهات التعصبية التي يحملها الرجال تجاه النساء، حيث يُعتقد أن مكانة المرأة أقل وأنها لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الرجل بأي شكل من الأشكال. تُعتبر المرأة كائناً ضعيفاً، ومكانها الطبيعي هو المنزل. كما تتجلى هذه الاتجاهات في رفض مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يُعتقد أن المرأة أقل ذكاءً وأن تفكيرها سطحي، مما يجعل الثقة بها محدودة، ويُعتبر إنتاجها وإبداعها ضئيلاً في مختلف مجالات العلم والأدب والفن. كما يُظهر هذا التعصب احتقاراً للمرأة، حيث يُعتقد أنها تتحين الفرصة للخيانة وأنها سبب تعاسة أي رجل، مما يُبرر التعامل القاسي معها. من جهة أخرى، تُظهر النساء اتجاهات تعصبية ضد الرجال، حيث يعتقدن أنهن لا يقلن شأناً عنهم، وأنهن قادرات على المنافسة في جميع مجالات العمل. كما يُعتقد أن المجتمع يبالغ في تقدير الرجال ويهضم حقوق النساء، مما يمنعهن من الحصول على فرص متساوية في المناصب القيادية. وتعتبر بعض النساء أنهن يمكن أن يعشن بدون أزواج إذا كان الزواج يُهدر كرامتهن، ويعتقدن أن الرجال هم سبب تعاسة أي امرأة، وأنهم ماكرون وغادرون بطبيعتهم.
السياق التعصب العنصري:
إن مفهوم العنصرية أو العرق يُعتبر مفهوماً بيولوجياً لا يشير فقط إلى الخصائص الجسدية التي تميز جماعة عن أخرى، بل يتضمن أيضاً الخصائص النفسية والاجتماعية. وبالتالي، تُعرف الجماعة العنصرية بأنها مجموعة من الأفراد الذين يشتركون في سلالة مستمرة تتسم بتكرار وراثة عدد من الخصائص الجسدية. لا يكفي وجود خاصية جسدية واحدة لتحديد الهوية العنصرية، إذ قد يختلف الأفراد المتشابهون في لون البشرة بشكل كبير في خصائص جسدية أخرى. لذلك، لا يوجد اليوم شعب أو قبيلة يمكن اعتبارها “عنصراً نقياً”. وقد اتجه الباحثون لتعريف الجماعة العرقية على أنها أي مجتمع من الأفراد يعتبرون أنفسهم ويعتبرهم الآخرون مشتركين في واحدة أو أكثر من الخصائص التالية: الدين، الأصل العنصري أو العرقي، الأصل القومي، اللغة والتقاليد والثقافة. وبالتالي، أصبح مفهوم الجماعة العرقية أكثر عمومية، حيث يمكن إطلاق هذا الاسم على الأمريكيين أو الروس أو الصينيين بناءً على الأصل القومي، وكذلك على اليهود والمسيحيين والمسلمين بناءً على الدين.
شاركنا برأيك
نيروبي: سودان سوا سوا 10 فبراير 2025
طالبت وزارة الخارجية السودانية المجتمعين الدولي والإقليمي بتقديم الدعم لخارطة القوة الوطنية والمجتمعية، التي تتضمن بشكل رئيسي تعديل الوثيقة الدستورية تمهيدًا لفترة انتقالية.
ما رأيك في مستقبل العملية السياسية بعد انتهاء الحرب؟
تلفون : 254710226030+
إيميل : info@sudan-sawa-sawa.com
“الحركة الشعبية قيادة “الحلو” تعلق علي احداث كادوقلي”
كادوقلي: سودان سوا سوا 4 فبراير 2025
الحركة الشعبية لتحرير السُّودان شمال – SPLM – N
في تصريحٍ لها، أفادت الحركة الشعبية بأن “الجيش الشعبي” يصد هجوما ل”مليشيا بورتسودان” إستهدف مناطق تمركزه.
قامت مليشيا بورتسودان التي تسمى ب”القوات المسلحة السودانية” في الساعات الأولى من صباح الإثنين 3 فبراير 2025 بقصف مناطق سيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال، كما حاولوا التقدم للإستيلاء على هذه المناطق.
بدأت التحركات العدوانية منذ 30 يناير 2025 عندما سيروا متحرك إلى منطقة “الكويك” وتمركزوا في جبل “حجر المك” داخل كادقلي، وفي 1 فبراير 2025 بدأوا قصف مناطق سيطرة الحركة الشعبية في (كيقا، سرف الضي، تلو، الدشول، حجر المك)، وبعدها تم إجلاء المواطنين قسريا من داخل أحياء كادقلي إلى حجر المك ووضعهم في مرمى النيران.
تصدت قوات الجيش الشعبي للقوة المهاجمة وكبدتهم خسائر كبيرة في منطقة مأهولة بالسكان، وقد تم رصد تحرك الجيش مع المواطنين وهم يحاولون التقدم نحو مناطق سيطرة الجيش الشعبي.
ما حدث من قبل “مليشيات بورتسودان” هو إمتداد للإعتداءات المتواصلة التي تقوم بها منذ قصف مدينة “يابوس” في إقليم الفونج الجديدة بتاريخ: 19 ديسمبر 2024 وقتل ثلاثة من موظفي برنامج الغذاء العالمي، ثم تبع ذلك الهجوم على عدة مناطق في إقليم جبال النوبة بهدف طرد وكالات الغوث الإنساني وإيقاف عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
هنالك تحركات أخرى مماثلة من مدينة الدلنج، ولكن الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال يرصد جميع هذه التحركات، وهو في كامل جاهزيته وإستعداده لرد أي هجوم أو إعتداء يستهدف مناطق سيطرته.
أيها الجيش سلاما يقودونك إلى طريق جهنم المتلفز وما البراء إلا ارهابيين قتلة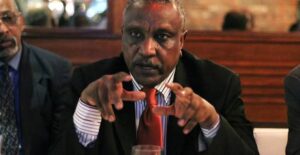
سودان سوا سوا 1فبراير2025
كتب:ياسر عرمان
أشعر بأسف عميق من إنشغال الناس والمدنيين على وجه الخصوص بمماحكات فك الارتباط وهم يتركون القتلة وكتائب الارهاب المسماة زوراً وبهتاناً بكتائب البراء التي تستأسد على الابرياء وتهاجم جماعاتها مدنيين غير مسلحين وتقوم بقتل المئات وتوزع جرائمها المتلفزة على وسائل التواصل الإجتماعي في تطور غير مسبوق لجرائم الحرب في السودان.
يظن قادة الإسلاميين وقادة هذه الكتائب من أمثال أسامة عبدالله وأخواته وإخوته الممتلئين حقداً على ثورة ديسمبر، انهم بذلك سيقضون على كل اثر للمقاومة في نفوس الناس ويطوون ذكر وذاكرة الثورة وهم لا يدركون ان الثورة باقية ما بقي الشعب بل هي طريق الشعب نحو الحياة الكريمة، وعائدة ما عاد الناس إلى منازلهم والإيمان بها كالايمان بالله لا يتزعزع.
الإسلاميون لهم زواج مصلحة مع الفئة العليا من قادة الجيش، قائم على عهد السلطة واكتناز الثروة بلا مباديء أو ذكر لله أو الوطن، عهد غير مأذون ولم يوقع أمام مأذون.
الإسلاميون يعشقون امتطاء ظهر الجيش فهو الحبل السري نحو السلطة ولكنهم يخشون الجيش أيضُا وقد حاولوا حماية انفسهم من الجيش بتعددية جيوش ومليشيات مقابلة ومنافسة للقوات المسلحة وعلاقتهم ملتبسة بالجيش، وقد شهدنا ذلك عن قرب في الفترة الانتقالية في نيفاشا وفي فترة ما بعد ثورة ديسمبر ولديهم جوقة إعلامية للهجوم على قيادة الجيش متى ما استرابوا من امرهم، ومن مصلحتهم ان يظل الجيش على عداء تام مع بنات وابناء شعبه، وأكثر ما يفزعهم ان يقترب الجيش نحو الشعب أو ثورة ديسمبر على وجه الخصوص، ودفع الجيش ثمناً باهظًا في عهد الإنقاذ فصلاً وتشريداً مثله مثل كل مؤسسات الدولة المختطفة، ولم يخلو الجيش في اي وقت من الاوقات من مقاومة الاسلاميين ومحاولتهم لتحويله لجناح عسكري، ويحيطونه اليوم بكتائب الإجرام والارهاب في تحالف قابل للتصدع مثل ما شهد تصدعات في اكثر من محطة تاريخيّة.
الجيش يعاني من خلل بنيوي قديم وجديد ومتعاظم في تكونيه القومي فتركيبة الضباط لا تماثل تركيبة الجنود ولا تعكس التنوع السوداني، وازداد خلله بخوضه لحروب الريف لسنوات طويلة، من قبل شكلٍ الجنوبيين ٢١٪ من قوامه وترتب على ذهاب الجنوبيين بالسماحة والندى ازدياد خلله، ودار فور شكلت ٣٤٪ من قوامه وجبال النوبه ١٣٪ ، وهجر الكثيرون من ابناء هذه المناطق الجيش بحكم حروب الريف وعدم الاهتمام بالفئات الدنيا من منتسبيه، وازداد تشويه الجيش في فترة الإنقاذ التي اعتمدت مبدأ التسييس ومبدأ تعددية الجيوش والمليشيات، شهدت هذه الحرب شهادات ميلاد جديدة للمليشيات وآخرها أورطة كسلا المصنعة في الخارج.
الجيش ومؤسسات السيادة والأمن استحوذت على ٨٠٪ من ميزانية الدولة ولم يتبقى شيء ذو بال للتعليم والصحة والخدمات وتم تدمير الريف والطبقة الوسطى وازدادت أعداد الفقراء والمهمشين، والعطالة وسط الشباب الذين توجهوا نحو حمل السلاح وقد لخص ذلك بذكاء بليغ الراحل جلحة رحمة المهدي رحمة ( نحن ام باقة لا جواز لا بطاقة مكلفين الدولة فوق الطاقة، الميت شهيد والحي مستفيد) ان الدولة التي تهمل الريف وشبابه غير قابلة للحياة.
ان العقيدة العسكرية للجيش لا تقوم على ان السيادة للشعب وان مهمة الجيش هي الدفاع عن سلطة الشعب وسيادة البلاد وقامت العقيدة العسكرية على معادة الحكم المدني الديمقراطي. الحركة الاسلامية لا مصلحة لها في مهنية الجيش او اعادة بنائه، فهي تخشى الجيش المهني والقوي المنحاز للوطن ولا تخشى الله وتحتاج لجيش منحاز للتنظيم والجماعة.
ان تجفيف المقاومة امر مستحيل وقتل كتائب البراء المتلفز للأبرياء والمدنيين يضرب النسيج الاجتماعي في الصميم ويعظم الغبن الإثني والجغرافي ويمزق روابط البناء الوطني وروابط الوطنية السودانية ووحدة المجتمع ومؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة.
في اليوم التالي لاستعادة الجيش لمدينة ود مدني كتبت مقال بعنوان ( هل قادة الجيش على اعتاب تحويل نصر مدينة ود مدني لهزيمة؟ وهل يسعى الإسلاميون مجدداً لدفع الجيش لطريق لاهاي؟) ان الحركة الاسلامية التي يقودها مطلوبين للجنائية لا تريد لقيادة الجيش ان تبحث عن حلول خارج طريق جهنم الذي حددته وتريد ان تقودهم لطريق الجنائية، ظنًا منها ان المجتمع الدولي سيتصالح معها كما فعل مع بعض الجماعات التي صنفها كجماعات ارهابية مثل ما حدث في سوريا، وهنا يخطيء الإسلاميون في التدقيق في فوارق الجغرافيا السياسية والفرق بين دمشق والخرطوم حينما يتعلق الأمر بالمصالح الدولية.
امام القوات المسلحة فرصة للبحث عن سلام حقيقي ومعافاة وطنية لن تتحقق بمعادة ثورة ديسمبر، فالثورة أعمق وأرسخ من الحرب وأكبر من ارهاب البراء سيما انه ليس البراء ابن مالك الصحابي الجليل بل هو اسامة عبدالله! الحركة الإسلامية دفعت القوات المسلحة نحو الانقلاب وفشل الانقلاب ثم سعت نحو الحرب ودمرت المجتمع والدولة، والشعب يدرك ان الفترة الانتقالية المدنية كانت خيار أفضل من الانقلاب ومن الحرب وما ان يعود المجتمع والدولة إلا ويطال الإسلاميين غضب الشعب ومحاسبته رغم الأكاذيب والجعجعة والسلاح ومن لا يصدق ذلك فليسأل عمر البشير ورهطه، كيف انتهى به المقام حبيساً بدلاً من رئيساً.
الجرائم الواسعة والفظيعة المرتكبة من طرفي الحرب اتخذت عنفاً ممنهجاً ومنظماً وخلفها فكرة داعشية عند كتائب البراء، وعلى الإسلاميين السودانيين اصحاب الفكر الداعشي ان يسألوا أنفسهم اين داعش نفسها؟
من واجبنا القيام بعمل واسع ومنظم في الداخل والخارج يرصد ويوثق ويعمل مع المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية لإعلان الحركة الإسلامية وجناحها العسكري في كتائب البراء جماعة ارهابية وعلى قادة الجيش ان يدركوا ان الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة وان تكون لديهم حساسية تجاه الجرائم المتلفزة التي لا تسقط بالتقادم وتفاقم الشقاق الوطني ودوامته مما يُصعب الاتفاق على امكانية بناء القوات المسلحة وفق برنامج وطني جديد متوافق عليه ويثير أسئلة إثنية وجغرافية حول قومية القوات المسلحة وهي أسئلة قديمة ومتجددة عمّقتها جراحات هذه الحرب، ان ما يجري لن يمر إقليمياً ودولياً دون مساءلة ومن مصلحة القوات المسلحة ان تفرز عيشها بعيداً عن عيش الإسلاميين ولو بالتدرج ونحن ندرك المصاعب في هذا الطريق وعلى قيادة الجيش ان تعترف بالجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
على الحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة رغم اختلافنا العميق مع توجهاتها، ان تقف ضد جرائم كتائب البراء وارهابها الذي تحكمه بوصلة ذات توجهات إثنية وضد قوى ثورة ديسمبر وستطال هذه الحركات نفسها يوماً ما، وحسناً فعلت حركة تحرير السودان مني مناوي بإدانة بعض هذه الجرائم علناً.
أخيراً نحن في القوى المدنية علينا ان نترك موضوع الحكومة الموازية وفك الارتباط خلفنا، فقد انفك الارتباط ولنرتبط بشعبنا ووطننا وبالثورة السودانية من ١٩٢٤ إلى ديسمبر ٢٠١٩.
البُعد السياسي للعدالة الانتقالية
سودان سواسوا 29يناير 2025
الكاتب: عبدالرازق أبكر
العدالة الانتقالية من القيم الإنسانية التي اتخذها مفكرو العصور المتعاقبة كقوانين وضعية لإصلاح بعض الأنظمة المستبدة في السلطة ومحاسبتها عن الجرائم التي ارتكبتها. وهي بمثابة المفتاح الأساسي للنظام في الدول، ويليها القيم الثانوية كالديمقراطية والليبرالية والفدرالية. ولذلك، تأخذ تلك العدالة بُعدًا سياسيًا هامًا؛ لأنها تتعامل مع الفترات الانتقالية في الدول التي شهدت نزاعات أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
لا بد للعدالة الانتقالية أن تهدف إلى بناء الديمقراطية، التي بدورها تُرسخ قواعد الديمقراطية من خلال الإصلاحات السياسية وتعزيز مؤسسات الدولة لتكون شفافة وقوية، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن حقوق المواطنة وتطبيقها على أرض الواقع. كما تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية، مما يؤدي إلى تشجيع الحوار والتفاهم بين مختلف الفئات السياسية والاجتماعية، والعمل على جبر الضرر ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الحربية وجرائم ضد الإنسانية، التي تتلخص في التشريد والقتل والإبادة وغيرها من الجرائم.
يجب محاسبة هؤلاء المسؤولين أمام محاكم دستورية عليا، سواء كانت دولية أو إقليمية أو محلية، لتنقية ما تبقى من الظلم والانتهاكات ولتجنب تكرارها. وفيما يتعلق بحكم سيادة القانون، وإنشاء نظم قضائية عادلة وفعالة لمحاسبة الانتهاكات، يجب ضمان أن تكون جميع السياسات والإجراءات مبنية على أساس قانوني، يليها توزيع عادل للثروة بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويقلل من الفوارق الاقتصادية. يجب أيضًا تعزيز سياسات التنمية المستدامة لدعم الفئات المهمشة.
لكي تتحقق هذه العدالة، لا بد من وجود إصلاح مؤسسي لإعادة هيكلة الأمن والقضاء، لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات وتعزيز المهنية والنزاهة في المؤسسات الحكومية. ولذلك، اتخذ العالم هذه العدالة كحل بديل أو كمفتاح لاستقرار بقية القيم الإنسانية، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وبناء ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
خلاصة الأمر، إن العدالة الانتقالية ليست فقط مسألة قانونية أو اجتماعية، بل لابد أن تلعب بُعدًا سياسيًا كحل أفضل لإزالة الشوائب من بقية جوانب تهدف إلى إعادة بناء الدولة والمجتمعات على أسس العدالة والإنصاف والمساواة. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية والتزام من جميع الأطراف المعنية.
غارق في فارغ
سودان سوا سوا 29 يناير 2025
الكاتب الباحث/عثمان زكريا
ورائي غارق في كأس فارغ
أقطع نصف المسافة إليك
يستبيحني الليل
ويفتتني ندوب ذكريات
تشعل أوراق عمر
وأتساءل
ما هو السر في عشقي لك
وأنا التي أكتبك دائماً
بحرف الروح ونبض القلب
هويتي أنت، أسرار الوجود
قادم من كوكب مسحور
تضحك والسكين تتلوى
في خارطة جسدك
ورائنا غارق في كأس فارغ
تنزف تاريخاً بين أعمدة دارفور
وجنوب كردفان والنيل الأزرق
هويتنا صور تبكي دمعاً
هي قضية أراضيك الخصبة
ومواردك الوفيرة
سودانياً عشقي أنا
أرض السلاطين والحضارات والمماليك
أبداً لن تستكين
ستعود أحلى، ستعود أغلى
سأباهي بك الخلق يوم الدين
أشتاق لك وأنا أضمك قرباً
فكيف وأنا غربةً ألهج باسمك
أحبك؟
أحيا فيك وأعيش بك ولك
أيها الوطن الذي إسمه أنا
وأنت لم يبق لي إلا حرف متمرد.
استطلاعات نيروبي: سودان سوا سوا 24 يناير 2025
شارك برأيك:
السودان: أبلغنا دولة جنوب السودان بوجود مرتزقة جنوبيين ضمن صفوف الميليشيات، ورغم ذلك لم تتخذ أي إجراء. سنقوم بما يتناسب مع الرد على التجاوزات العديدة ضد جوبا على المستويات الدولية والإقليمية.
ما رأيك في مستقبل العلاقات بين البلدين؟
Email info@sudan-sawa-sawa.com
254710226030+
إستمرار القوات المسلحة السودانية في الإبادة بإستخدام الأسلحة الكيميائية
نيروبي: سودان سوا سوا 23يناير 2025
كتب : متوكل عثمان سلامات
أشرنا في المقال السابق للهلوسة التي أصابت قائد الإرهابيين العنصريين جراء تسريب خبر إحتمال فرض عقوبات عليه من دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم فرض عقوبات بالفعل على كل من عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأحمد عبدالله سوداني وأكراني الجنسية ومسؤول في منظومة الصناعات الدفاعية ومورد الأسلحة للقوات المسلحة السودانية، وشركة بروتكس للتجارة المحدودة. ونبهنا كذلك المتابعين أن هناك تسريب آخر خطير جداً متعلق بإستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية في حربها مع الدعم السريع، وهذا الموضوع لخطورته وعدنا بأننا سنفرد له مقالاً منفصلاً.
في هذا المقالة سنحاول التعرف على طبيعة الخبر، ونتعرف معاً على “الأسلحة الكيميائية” ما هي؟، وكيف إتحصلت القوات المسلحة على هذه الأسلحة المحظورة دولياً؟ وهل إستخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في حربه مع قوات الدعم السريع هي اول حالة؟ أم أنها قد إستخدمت هذه الأسلحة الكيميائية في حروب أخرى ومناطق مختلفة من السودان؟، هل السودان وقع وصادق على إتفاقية حظر حظر إستخدام الأسلحة الكيميائية؟ ما هي الإجراءات التي تتبع في حالة عدم إلتزام دولة عضو ببنود الإتفاق؟، وكيف يمكن التخلص من هذه الأسلحة خاصة أن هناك إحتمال كبير لإمكانية إنكار وجودها من قبل حكومة الأمر الواقع؟ وإحتمال كبير لإمكانية إستخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم؟.
يأتي طبيعة الموضوع من الخبر المنشور في صحيفة “نيويورك تايمز” بقلم “ديكلان والش” و”جوليان إي بارنز” مفاده (..أن هناك أربعة من المسؤوليين الأمريكيين الكبار أفادوا بأن الجيش السوداني بتوجيه من قائده عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان إستخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع … وأن هذه الأسلحة تم نشرها مؤخراً في مناطق نائية من السودان … وأنهم قلقون من إمكانية إستخدام هذه الأسلحة قريباً في مناطق مكتظة بالسكان بالعاصمة الخرطوم …).
إذاً، ماهي الأسلحة الكيميائية وفقاً للقانون الدولي؟
عرفت المادة الثانية من إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية “الأسلحة الكيميائية” بأنها (ما يلي، مجتمعاً او منفرداً:
المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الإتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض،
الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة او غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة إستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية(أ)،
أي معدات مصممة خصيصاً لإستعمال يتعلق مباشرة بإستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب)).
كما عرفت ذات المادة مصطلح “المادة الكيميائية السامة” بانها (أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العملية الحيوية أن تحدث وفاة او عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان او الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر منشئها او طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق ذخائر او أي مكان آخر).
تشير بعض التقارير إلى أن الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة يحصلون على التسليح من بعض دول في أوروبا وآسيا وبعض دول شمال إفريقيا، وكان للصين وروسيا وإيران الدور الكبير في إرسال الإمدادات العسكرية للحكومة السودانية. وقد تطور التسليح السوداني بعد إنشاء “مجمع اليرموك” للتصنيع العسكري والحربي، وكان يمكن أن يكون المجمع مفخرة لكل سوداني، ولكن كان الهدف منه هو تصنيع وتطوير السلاح والزخيرة لإبادة السودانيين في الجنوب سابقاً والفونج وجبال النوبة ودارفور والمناصير وفي الشرق، وإنتشرت أنباء عن وجود خبراء”إيرانيين” و”عراقيين” و”أتراك” وجنسيات أخرى يعملون على إنتاج أسلحة محرمة دولياً “أسلحة كيميائية” بغرض ردع الحركات الثورية السودانية وإبادة الشعوب المختلفة مع توجهات الدولة “الإسلامية والعربية”، والتي تطالب بالحرية والعدالة والمساواة، وكذلك يتم تهريبها للمجموعات الفلسطينية لردع إسرائيل والدول العربية التي يشتبه في تعاملها معها، ومنذ ذلك الوقت تحول مجمع اليرموك إلى “مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية”، وهناك مجمع “جياد” بعد تحول نصفه للصناعات العسكرية، وقد وردت أسماء مواقع أخرى تقوم بذات الأنشطة وسكت عنها الجميع بعد إستهداف إسرائيل لمجمع اليرموك، مثل “كربلاء” و”القادسية” و”قري” ومواقع أخرى مخفية في الصحراء، وتحوم بين هذه المواقع داخلياً وخارجياً شركات عديدة وطنية ومتعددة الجنسيات.
لم تلتزم الحكومة السودانية في حربها على مواطنيها في إقليمي الفونج وجبال النوبة في الحرب الأولى من 1984م – 2005م، والحرب الثانية من سنة 2011م – وحتى الآن، بنصوص القانون الدولي الإنساني، او إتفاقية حظر إستخدام الأسلحة الكيميائية، حيث إستخدمت الأسلحة المحظورة دولياً ضد المدنيين في الإقليمين، وقامت بإستخدم الألغام البشرية والألغام المضادة للدبابات (Anti- personnel and anti-tank landmines) وتمكن الجيش الشعبي من الإستيلاء عليها بعد هزيمته للقوات المسلحة السودانية في مدينة “هيبان” بتاريخ يونيو/2011م، وفي معركة “تروجي” بتاريخ فبراير/2012م، وهذا ما أكدته (منظمة مسح الأسلحة الصغيرة) بتاريخ مايو/2012م.
كما إستخدم سلاح الجو الحكومي قنابل عنقودية (Cluster bambs) ضد المدنيين في جبال النوبة بمنطقة “تروجي” أيضاً بتاريخ 29/2/2012م، ووثقت كذلك ذات المنظمة إستخدام سلاح الجو الحكومي للقنابل الحارقة (Incendiary bombs)وذلك عندما أسقطت طائرة الأنتنوف قنابل حارقة على المدنيين بمنطقة “جاو” التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بتاريخ 6/3/2012م بشهادة شاهدين من الضحايا، ، وذهبت الحكومة السودانية أبعد من ذلك عندما إستخدمت الأسلحة الكيميائية والسامة (Toxic weapons)في مدينة “تلودي” سنة 2012م وذلك بعد رصد حالات تسمم أدت إلى الوفاة نتيجة لإستنشاق غازات خانقة أطلقتها القوات المسلحة السودانية، وقد أكد هذه الجريمة الخطيرة أشخاص يعملون في المجال الطبي ممن أشرفوا على علاج العديد من الضحايا الذين كانوا في تلك المنطقة وتعرضوا لإصابات توضح طبيعة هذه الأسلحة، وذكروا أن طبيعة الأعراض التي ظهرت على المصابين يحتمل أن تكون ناتجة عن التسمم بـ(Organo-Phosphate)، وهذا ما أكده محرر منظمة نوبة ريبورت بتاريخ 10/10/2016م، عندما أوضح أن بعض الضحايا الذين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى أبانوا أن سلاح الجو الحكومي قد أطلق عليهم قنابل تخرج دخاناً رمادي اللون وسرعان ما يتحول إلى اللون الأبيض، وناشدت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال المجتمع الإقليمي والدولي لحماية المدنيين وإتخاذ إجراءات تمنع حكومة السودان من إستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة المحظورة دولياً ولكن دون جدوى.
قبل ثمانية سنوات وفي نفس شهر يناير 2017م نشرت منظمة العفو الدولية تقرير يؤكد إستخدام السودان للسلاح الكيميائي في جبل مرة بدارفور قبل سنة من نشر التقرير، عندما هاجمت القوات المسلحة السودانية المنظقة في هجوم واسع النطاق لمدة تسع أشهر متواصلة وكان أغلب الضحايا مدنيين، وكانت المنظمة قد حصلت على أدلة دامغة على إرتكاب الحكومة السودانية لجرائم حرب في الإقليم من خلال القصف العشوائي للمدنيين والقتل خارج نطاق القانون، وإختطاف النساء وإغتصابهن ونهب القرى وحرقها والتنزيح القسري، بعد أن تم تقييم هذه الأدلة بواسطة خبراء الأسلحة الكيميائية وهما “كيث وارد” و”جنيفر ناك”، وطالبت المنظمة بضرورة محاسبة الجناة ولم تتحرك، الدول أعضاء “إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” لأسباب واهية وغير منطقية.
لم يكن إستخدام الجيش السوداني ومليشياته للأسلحة الكيميائية في حربه مع الدعم السريع هو المرة الأولى وإنما هي عملية متعارف ومعتاد عليها في حروبه المستمرة ضد الشعوب السودانية في الفونج الجديدة ودارفور وجبال النوبة وضد حركات الكفاح المسلح السودانية المتمثلة في الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال وجيش تحرير السودان ويحدث ذلك في ظل صمت المجتمع المحلي المغيب والمجتمع الإقليمي والدولي.
رتبت إستخدام هذه الأسلحة الكيمياوئية آثار سالبة على صحة الإنسان في تلك المناطق من قتل وظهور الأمراض الجلدية ومشاكل العيون وأمراض الجهاز التنفسي وتشوه الأجنة وتفسخ وتفحم الضحايا وبتر اعضاء بعضهم، وآثار سالبة على الحيوان والبيئة من تلوث المياه والهواء ونفوق الحيوانات الأليفة والبرية وهروب معظمها ونفوق الأسماك وإفساد التربة والزرع، وهذه فقط على سبيل المثال لا الحصر، وقد تستمر بعض هذه الآثار للمدى البعيد.
من المعروف عن القوات المسلحة وحكومة الأمر والواقع في بورتسودان وسابقاتها عدم الإلتزام بالإتفاقيات والعهود كما لا تحترم حتى وثائقها شبه الدستورية وقوانينها المشوهة التي تسنها، فبالرغم من عضوية السودان في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتوقيعها ومصادقتها على إتفاقيتها وأصدرت بموجب ذلك “قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2004م” والذي نص في المواد (14، 15، 16، 17) على حظر تصنيع أو إستخدام أو إنتاج أو حيازة أو نقل أو إستعمال أو الترخيص بإستخدام الأسلحة الكيميائية، وحظر إستيراد أو تصدير المواد المشتملة على كيمائيات محددة، وحظر إستحداث أو إنتاج أو تخزين أو إستعمال مواد كيميائية محددة، وحظر إقامة المنشآت الكيميائية، إلا أن ما نشر في “نيويورك تايمز” بإستخدام الجيش للسلاح الكيميائي لأمر يثير القلق، خاصة وأن هناك سوابق لهذا الجيش ومليشياته، كما أنه جيش غير مهني، وتقوم عقيدته القتالية على أساس الدين والعرق والجهاد في سبيل الله، ففي ظل هذا الوضع غير الطبيعي فإن إحتمال عدم إمتثاله وإلتزامه بهذه الإتفاقية وقانونه الوطني لأمر وارد لا شك فيه.
وفي ظل هذه المعطيات التي تشير إلى عدم إحترام او إلتزام الحكومة العسكرية بالموثيق الدولية وفرض عقوبات عليها، يلاحظ أن معظم الشعوب السودانية وضحايا الإنتهاكات الإنسانية أصبحو يشككون في فعالية هذه العقوبات وفي قدرة واشنطون على إنفاذها، أو قدرتها مع حلفائها في المؤسسات الدولية على إتخاذ خطوات جريئة بشأن هذا التجاوز الخطير للسودان لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ظل إصطدام آمالهم وطموحاتهم المستمرة في تحقيق السلام والإستقرار والإنصاف من خلال مؤسسات الأمم المتحدة بالفيتو الروسي او الصيني الناتج عن تقاطعات المصالح في السودان والصراع الدولي. ومع ذلك مازالت آمالهم كبير في أن تسهم هاتين الدولتين إيجاباً وتقفا إلى جانبه بجانب المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحرجة.
سيكون على الولايات المتحدة الأمريكية او أي دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يقوموا بواجبهم الإخلاقي ودورهم الإنساني المعهود من أجل تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولى، أن يقدموا طلب مستعجل للمجلس التنفيذي للمنظمة بغرض الحصول على توضيح من القوات المسلحة بشأن حيازة وإستخدام هذه الأسلحة الكيميائية الخطيرة والمحظورة دولياً، كما عليهم في حال إنكار القوات المسلحة إمتلاكها وإستخدامها لهذه الأسلحة عليكم أن تضعوا خطة واضحة ومحكمة لتدمير هذه الأسلحة الكيميائية بما يضمن سلامة المواطنين السودانيين، أما في حالة إعترافها بحيازتها لهذه الأسلحة فعلى المنظمة أن تفرض عليها عقوبات صارمة وتضغط عليها لتقديم خطتها التفصيلية لتدمير هذه الأسلحة الكيميائية وفق الإجراءات المتبعة في الإتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.
#حماية السودانيين من الأسلحة الكيميائية
#فرض عقوبات رادعة على الجيش السوداني ومليشياته
#انهاء الحروب بمعالجة أسبابها التاريخية
#تحقيق السلام بمعالجة جذور المشكلة السودانية
بين الموت والحياة
السودان: سودان سوا سوا 22يناير 2025
الكاتب الباحث/عثمان زكريا
لا تنشري أحلامي كأنها شعار
صدِأت كل الشعارات
أحلامنا صارت غبار
كنت أيقنت أن أحلامي رجاء
أشكو افريقيتي أو السفهاء
لاذ فرارا حاضري!
ترىُ وغدي؟
المدن امتلأت بالبؤساء
الناس فيها كلهم غرباء
يعيش الكثير من الموتى
والقليل من الأحياء
الحيّ يشعر بالموت
والميت يشعر بالحياة
يا لثنائية الوجود
كم تنتشي بدمار الأماني
لقد سقطَ العالم بصمته
أمام الفظائع التي تُرتكب
بحق شعبٍ أراد الحياة فوق أرضه
فليكتب التاريخ ما يشاء
ما عاد للتمني وهجٌ
ما عادت الشمس شمساً
ولا عادت الأحلام صالحات
أكتب يا تاريخ وأشهد أنه
براجمات الفناء تلوّثت
دموع السماء.
خواطر ومقولات:
#سودان سوا سوا 18يناير2025
الروائي/ محمد عبدالله عبدالله أبكر
-1-
“تركوا أوطانهم، هاجروا إلى بلاد الغربة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، حياتهم بين جحيم الغربة والوطن، بالرغم من ذلك المجتمع لا يرحمهم، ينظر لهم نظرة مادية، كأنهم مضخات للأموال، طلبات بلا حدود، لحتي ضاعت أعمارهم وأحلامهم في الغربة، إنطوت ذكرياتهم، تبقي المغترب مكتوي بين نار الوطن ونار الغربة”..
-2-
“أسوأ عام مر في تاريخ حياتي، أكثر دمويه وإستباحة دماء أبناء الشعب من قبل الجنرالات، كان مثقلاً بالأحزان والآلام إفتقدنا فلذات أكبادنا، الحروب وأدخنة البارود، الخراب والدمار، موتي، أشلاء، جثث متناثرة، إبادة جماعية، تشريد، نزوح، لجوء بلا عودة، صرخات نساء، عجائز، أطفال، بسبب الجوع والبرد والعطش، نأمل هذا العام أن يكون بداية حقيقية لعام جديد، ليسعى معه الشعب السوداني، يطوي صفحات الحزن والألم، مستقبلاً صفحات جديدة مليئة بالفرح والأمل، وإغلاق صفحات الحروب وأدخنة البارود والحرائق التي أشعلها الجنرالات، مع إعلان السودان الجديد حينها نحتفل بميلاد السودان الجديد”..
-3-
“مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت قدسية الحياة ظواهر مخيفة تُرخي بظلالها على المجتمع لتُسلب خلايا الترابط الاجتماعي، منصات تنغمس في المشاهد، الصور، الفيديوهات، البث المباشر، يشاركون قصص، حكايات حزينة لأبطال وهميين، رقص عاري، برنامج روتيني يومي، أصبح نداء للفساد، تُظهر المرأة مفاتنها، أعضائها التناسلية مكشوفة للمشاهدين إلا قطعة صغيرة من القماش الشفاف، أخرون يستعملون آيات قرآنية وأحدايث نبوية يُحلفك بالله من أجل جمع اللايكات والتعليقات مقابل نقود، وأخرون يتاجرون بمآسي الفقراء والمرضى يلعبون دور وسيط الأعمال الخيرية بإستهداف المغتربين، حتي الطرقات لم تسلم منهم تجدهم منتشرون في الأستوبات تجد من يرش خليط من الماء والمنظفات الرديئة على زجاج السيارة يتبعها تمرير ممسحة بالية، كل ذلك من أجل الحصول على مكاسب مالية على شكل هدايا بمظهر خداع، وخلف قناع الفقر، يُقرع هؤلاء أبواب الاستعطاف من خلال هذه المواقع لكسب مشاهدات جديدة تغني حساباتهم البنكية، وتستقطب مساهمين جدد ضحايا الخداع والإحتيال، طريقتهم الرقمية شكلت لهم ملاذاً آمناً يذلل لهم العار والإحراج الذي يتعرض له ممن يمتهن تسول الواقع”..
-4-
“لن تنهض الدول طالما هناك نُخب نرجسية إنتهازية، تستبيح كل شئ في صراع لاحتكار السلطة، والهيمنة والإقصاء والخضوع على الفشل، لن تنهض أبداً طالما الدول تُدار بالمسكنّات نحو الاستبداد والتبعية والفساد”..
-5-
“وحشية سجون المليشيات الليبية قتل، تعذيب بالأسلاك الكهربائية، ضرب مبرح بالسياط، وإستخدام العصي في الإهانة النفسية والجسدية، إلي أن تصل لدرجة الإعاقة الجسدية، هذا التعذيب من أجل دفع فدية مالية، حينها يتم الإفراج عنك، وإن لم تدفع تتعذب إلي أن تلاقي ربك في ملكوت السماء”..
-6-
“لقد أمسكت بضرع البقرة لقرون، حلبت قدر ما شئت إلي أن توفها الله، لكنها تركت إبنتها يتيمة، وعندما كبرت الإبنة أخبرها جدها بكل تاريخ أمها، وقال لها: هولاء لصوص لا ترضخي لهم، حتي تحررت دول من هؤلاء اللصوص، لذلك يا ماكرون لا ترفع أنفك، لولا أفريقيا ما كانت فرنسا، من المفترض تقول شكراً للأفارقة، هذا رداً لكلام ماكرون: لولا الأفارقة لكانت فرنسا اليوم ألمانية”..
-7-
“بعد كل النفاق والتطبيل تريد أن تكون والياً، ولكن لا ترقص علي جماجم الموتي”..
-8-
“تبقى الأم أماً رغم كل الصعوبات والتحديات، في زمن الشدة تجدها صامدة تحتضن أطفالها بإرادة تضخ فيهم روح الحياة والأمل، والكل يتعجب من مصدر تلك القوة التي تنبع من قلبها الصغير الذي يختفي خلف أضلعها، قلب إحتار الجميع في سره، فهو قمة الحنان والعزيمة، هي أهم شخص في حياتي أعوام من التضحيات والتسامح، علمتني ما هو الايمان بالتضحيات والنضال والحب الحقيقي، ولن أكون علي قيد الحياة بدون أمي، فأنتِ مصدر قوتي، عن جد فخور بيكي جداً، أمي نبض حياتي”..
-9-
“الإنسان الأفريقي مقهور إجتماعياً، غُسل دماخه بواسطة المناهج التعليمية، والوسائل الاعلامية، مما أدي إلي كراهية ذاته، لذلك تجد الإنسان الأفريقي غير متسامح مع نفسة، وفي داخله غُبن تاريخي تجاة الأخرين”..
-10-
“الرفيق ود النوبة فنان إبداعي وثوري، وصل رسالة حقيقة لشعبه السوداني عبر الفن الثوري، كان له رؤية واضحة ضد الهيمنة والظلم والقمع، هذا يمثل شكل من أشكال الفن، أشعل نار التمرد، داعماً لقضايا وطنه بعمله الفني إستطاع معالجة أكثر القضايا عبر فنه الثوري”..
-11-
“الرفيق المناضل يؤمن بأهداف المبادئ من أجل التغيير، ثائر في وجهه كل من عاش في الأرض فساداً، يعافر ويكافح في جدارِ اليأس سبيلاً للفقراء والمساكين ليسْلكوه، ويتحرروا مِن عَبث العابثين، يا رفيقي تَحمل كل الهموم والغموم، واجه كل المصائب والمتاعب، قاوم كل التحديات والضغوطات، لا تنكسر، لا تنهزم، لا تستسلم، لا تنهار، كن قوياً صلباً متماسكاً كالجبل الشامخ، ولا تكن كالذين يبيعون كل شئ حتى ذواتهم بلا مقابل”..
“تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” تحمل القوات المسحلة والقوات المقاتلة معها مسؤولية الجرائم الفظيعة”
الفظيعة”
#سودان سوا سوا 16يناير 2025
روعت ولاية الجزيرة بجرائم فظيعة في حق المدنيين عقب سيطرة القوات المسلحة والقوات المتحالفة معها على مدينة ود مدني ومناطق في الولاية، حيث انتشرت تسجيلات مصورة تضمنت فظائع وحشية شملت إعدامات ميدانية وقطع رؤوس وبقر بطون واستهداف عنصري وحرق مناطق سكنية.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الفظائع حيث شهدت مناطق الحلفايا وولاية سنار عقب سيطرة القوات المسلحة عليها حوادث شبيهة تحت ذريعة معاقبة “المتعاونين” وهو تعبير فضفاض يشمل وفق مرتكبي هذه الجرائم تصنيفات جهوية وقبلية وسياسية. هذه الممارسات تقف شاهداً على تصاعد النشاط الارهابي للمؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية عبر كتائبهم وعناصرهم داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، تهدف من ذلك المضي في مشروعها التقسيمي في البلاد وتصفية المخالفين وزرع الرعب في قلوب الناس تمهيداً لسيطرتهم على البلاد بقبضة من حديد عبر حربهم التي اشعلوها سعياً لسلطة على جماجم الناس.
نحمل القوات المسلحة والقوات المقاتلة معها مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة، وندعو لتحقيق مستقل وشفاف يحدد المنتهكين ويمهد لمحاسبتهم على ما اقترفت ايديهم من فظائع. كما ندعو كافة جماهير ثورة ديسمبر المجيدة لتوحيد الصوت ورفعه ضد المؤتمر الوطني/الحركة الاسلامية ومشروعهم الإرهابي، والتصدي لها ولخطابات الكراهية والعنصرية التي تتصاعد عبر أبواق الحرب الاعلامية.
الأمانة العامة
١٦ يناير ٢٠٢٥م
#نعم_للسلام #لا_للحرب #أوقفوا_الحرب #سلام_السودان #حماية_المدنيين
بسم الله الرحمن الرحيم
#سودان سوا سوا 16يناير2025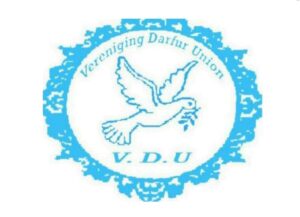
إتحاد أبناء دارفور بهولندا
بيان شجب واستنكار
الى شرفاء أبناء وبنات الشعب السوداني في الداخل والخارج الي المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الإنسان الي الأمم والشعوب المحبة للسلام والعدالة.لقد ظللنا نتابع بقلق بالغ استمرار الحرب العبثية بين القوات المسحلة وقوات الدعم السريع في السودان والتي انتجت أكبر كارثة إنسانية من صنع البشر في عالمنا اليوم !كما تكشف هذه الحرب اللعينة! اقحام المدنيين الأبرياء في وسط السودان وتحديداً مواطني الكنابي بمنطقة الجزيرة كطرف في هذه الحرب التي ليس لديهم بها اي صلة من بعيد او قريب يكشف بوضوح العقلية المدبرة لحملات الإبادة الجماعية المنظمة ضد مكونات اجتماعية بعينها.
يستنكر اتحاد أبناء دارفور بهولندا بأشد العبارات الانتهاكات غير الإنسانية المتكررة التي يتعرض لها المدنيون العزل في السودان عموماً وفي دارفور خصوصاً.
إن شعبنا يواجه أبشع الجرائم ضد الإنسانية من إبادة جماعية وتطهير عرقي ترتكبها مليشيات الدعم السريع وأتباعها في عمليات واسعة من التهجير القسري والاعتداءات الجنسية ، والقتل الجماعي ، شهدت مناطق كتم ،سرف عمرة ، كلبس ، زالنجي ، ومناطق اخرى في دارفور هذه الجرائم المروعة .وفي منطقة الكنابي بالجزيرة ، تعرض المواطنون لانتهاكات جسيمة شملت الذبح العلني ، الرمي في مياه النيل من الكباري ، والرمي بالرصاص في الشارع وهي جرائم فادحة ترتكب من قبل الجيش السوداني وكتائب البراءة تحت مسمى المتعاونون مع الدعم السريع او قانون الوجوه الغريبه.
الوضع الإنساني الكارثي
يمر شعبنا في السودان عموماً ودارفور بشكل خاص بظروف إنسانية قاسية تفوق الوصف . يموت النساء والأطفال جوعاً ، ويعيش من تبقى في خوف دائم من المصير المجهول.يبحث الناجون عن ملاذ آمن في ظل انعدام الأمن والطعام ، مما يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة تستدعي تدخلاً عاجلاً من المنظمات الإنسانية لإنقاذ الضحايا.
يطالب اتحاد أبناء دارفور بالآتي:
1.إيقاف القصف العشوائي:
ندعو طرفي النزاع إلي وقف القصف العشوائي للمدن ومعسكرات النازحين بالمدافع الثقيلة والطيران.
كما نطالب بإبعاد الحرب عن المناطق السكنية وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية.
فك الحصار:
2.نطالب مليشيات الدعم السريع بوقف الحصار المدن والولايات ، والسماح بوصول الإمدادات الأساسية والمواد الضرورية للحياة.
3.تقديم المساعدات الإنسانية:
نناشد المجتمع الدولي ، الأمم المتحدة ،منظمات الشؤون الإنسانية ، الاتحاد الأفريقي ،والمنظمات المحلية والإقليمية بتحمل مسؤولية إيصال المساعدات الإنسانية لإنقاذ المتضررين في جميع أنحاء السودان.
4.محاسبة المسؤولين عن الجرائم:
ندعو الجهات العدلية والحقوقية إلي إصدار مذكرات اعتقال ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة فوراً.
5.وقف الحرب فوراً:
نطالب الأطراف المتنازعة بإيقاف الحرب فوراً والعمل على تحقيق السلام الشامل.
إن ما يعيشه شعبنا في دارفور خاصةً والسودان عامةً هو كارثة إنسانية تهدد الحياة والوجود. لابد من تضافر الجهود لإنقاذ الأرواح ،وتحقيق العدالة ، وضمان مستقبل كريم وآمن للمتضررين.
وفي الختام
نسأل الله العظيم أن يصلح حال السودان ،ويعم الأمن والسلام ربوع البلاد ،وأن يجنب أهلنا ويلات الحروب والمحن ،وأن يفرج كربهم ويكتب لهم حياة كريمة وآمنة.
العدالة لكل أبناء السودان. لن تٌهدر دماء الضحايا سدى. السودان وطن للجميع.
إتحاد أبناء دارفور بهولندا
16يناير 2025
سودان سوا سوا 16يناير 2024
#د. عبدالله حمدوك
رئيس الوزراء السابق
الانتهاكات والمذابح الجارية في ولاية الجزيرة امر مروع، وقد ظل شعبنا يتعرض لهذه المجازر منذ أكثر من ثلاثة عقود.على العالم ان يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من هذه الجماعات الإرهابية التي تمارس أبشع المجازر ضد شعبنا، كما اناشد كل الشرفاء من أبناء وبنات الشعب السوداني عدم الانسياق وراء حملات التعبئة العنصرية وخطاب الكراهية وعدم الانسياق وراء حملات التحريض ضد مختلف المكونات الاجتماعية التي تسعى لإحداث المزيد من الفتنه بين السودانيين.
نناشد كل دعاة السلام في العالم العمل على حمل الأطراف المتصارعة الي وقف فوري لهذه الحرب المدمرة.
من محطات تجارة الحروب
#سودان سوا سوا 16يناير 2025
الكاتب الباحث/عثمان زكريا
لا يدفع ثمن الحروب والدمار على مر تاريخ السودان سوى المهمشين والتعابة والغلابة والبؤساء، ولا يدفع ثمن الجهل والتخلف وإستغلال الإنسان والتطرف الديني القاتل سوى المهمشين والجاهلين ويذهبون ضحيةَ التعبئة الطائفية الدينية البغيضة، بينما يجلس أصحاب المصالح غير المُبالين والسياسيون وراء موائدهم يتبادلون أطراف الحديث ويشربون نخب الصفقات، تماماً كما يجلسون اليوم في قصورهم المُزيَنة؛ ويقتلون المواطنين وأطفالهم في تصفيات التي لا تستهدف أصلاً إلا على أساس العرق واللون والإنتماءات الضيقة لطمس هوياتهم، وكما حدث في أغلب ولايات السودان كدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها وما زال يمارسون نفس الممارسات البشعة لسكانها.
وما يحدث لمواطني الكنابي بالجزيرة “ود مدني” بنفس المنوال هؤلاء الذين يقتلونهم بدم بارد عن طريق التصفيات الممنهجة من قبل المليشيات الصفوية بأشد أنواع التعذيبات ولا أحد يفعل شيئاً لإيقاف هذه الحرب الوسخة، ففي ظروف الحرب قد يسود الجنون وقد يتفتق العبقريات.
لماذا لايقرر البعض لإجراء تعديلات على قواعد لعبة تجارة الحرب؟
ربما كان ذلك انتقاماً من سيادة بعض البديهيات الفارغة والبسطاء من الداعين إلى اخضاع البديهيات اللاعلمية إلى سلطة العقل، لان
لتجارة الحرب تتمحور حول هدف أساسي هو حماية الإمتيازات التاريخية لهم ولو طلب الأمرُ التضحية بأغلبية الشعب السوداني.
وإن إقترح أبناء الشعب السوداني هو لاستبدال لعبة تجارة الحرب المدمر الي لعبة الديمقراطية الحرة التي تحترم حياة كل فرد على إعطاء حقه في العيش الكريم وتلزم القادة بالسير أمام نحو وطن عادل وشامخ يتساوى فيها الكل بدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو على أساس الإنتماءات الضيقة.
“لا أنتمي إلى جيل يسمع حكايات عن مدينتي الفاضلة
#سودان سوا سوا 14يناير 2025
الروائي. محمد عبدالله عبدالله ابكر
وما يسرده جيل القرون الماضية عن جمال شوارعها وأزقتها وملامح التحضر فيها، لكن لم يشهدها جيلي الذي فتح عيونه على المدينة في زمن الحروب والفوضى والخراب والدمار، لم يتركوا معلماً إلا عملوا على هدمه، دمروا كل ملامح الجمال إستطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلت إليه من خراب ودمار وفوضى على يد من الجنرالات، ملامح الفوضى تجدها في كل مكان من بنايات مشوهة وشوارع متهالكة، ومناطق يخيم عليها البؤس والفقر والحرمان، وبمجرد دخولك إليها تُوحي لك مداخل المدينة أين وصلت مراحل الخراب والدمار والإهمال في هذه المدينة، لكن يبدو أن ما يحدث للمدينة هو من نتاجات طبقة سياسية إستولت على الحكم وتحمل في داخلها حقداً دفيناً على كل شئ تاريخي حضاري في هذه المدينة، وربما لا تشعر بالانتماء إلى هذه المدنية، سلبوا منها روح المدينة، وحولوها إلى كيان مسخ لا ينتمي إلى عالم المدنية والتحضر، لم يتبقي منها غير القصائد والأغاني نتغنى بها، رغم كل الدمار الممنهج والمقصود للقضاء على معالم الحياة في المدينة، كل المُدن المنكوبة التي هدمت بهجتها الحروب والنزاعات، عن تلك التي تنام وتستيقظ على أصوات القذائف والطائرات التي تهتك حرمتها، مُدن أصبحت الحرب فيها نشاطاً يومياً، واقع يجب التأقلم معه، مُدن تُصبح فيها بلحظة مهجراً ولاجئاً أو نازحاً بالشوارع، والأحبة الذين كنت تستظل بهم أصبحوا أشلاءً، عن مدنٍ فيها الصبية والأطفال لا يعرفون طعم اللعب أصبحوا بلا وطن، حياتنا كلها حروب وفناء ومجاعة وإستهتار بحياة الانسان وتمزيق حريته وخنق أنفاسه في وطن كسيح، تُسلب حقوقك وتهان كرامتك لا تدري أين تذهب، تصبح نازحاً مهجراً مطروداً بلا وطن، والجوع كافر يحفر أثره في بطون الناس”..
خطر العنف في المدارس:
#سودان سوا سوا 11 يناير 2025
الروائي/ محمد عبدالله عبدالله أبكر
يعد العنف المدرسي، من أخطر الظواهر التي أخذت تنتشر وتتفاقم في كل المجتمعات، حيث تأخذ أشكالاً متعددة، أبرزها اللفظية والجسدية والرمزية، وهي سلوكيات مرضية تنعكس بدورها على كل الجوانب، المعرفية، النفسية، الاجتماعية..
إن العنف المدرسي لم ينشأ من العدم، يقف خلفه جملة من العوامل الاجتماعية المرضية، منها أساليب التنشئة الاجتماعية، وسائل الإعلام وما تحمله من مضامين مشجعة على ممارسة العنف، إلى جانب تأثير المخدرات..
العنف يعني سلوك عدواني لفظي وغير لفظي نحو شخص آخر، ويشمل سلوكيات العنف الجسدي، والإيذاء النفسي، والتهديد، وسرقة ممتلكات الآخرين، وفوضى وشغب في المحيط المدرسي..
أسباب العنف المدرسي:
الأسرة:
تقلص دور الأسرة في ظل عمل الأبوين و الالتجاء إلى المحاضن، والتفكك الأسري الناجم عن الطلاق، وعدم إشباع الأسرة لحوجة أبنائها نتيجة تدني مستواها الاقتصادي.
المجتمع:
الفقر والحرمان، وجذور المجتمع المبني على السلطة الأبوية ما زالت مسيطرة، فنرى على سبيل المثال أن إستخدام العنف من قبل الأب أو المُدرس هو أمر مباح ويعتبر في إطار المعايير الاجتماعية السليمة، وحسب النظرية النفسية الاجتماعية، فإن الإنسان يكون عنيفاً عندما يتواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكاً ممكناً مسموحاً ومتفقاً عليه.
النظرة التقليدية القائمة على تمجيد التلميذ الناجح والتقليل من شأن التلميذ الفاشل دراسياً، وهذه المقارنة التحقيرية الدونية تولد سلوكاً عنيفاً.
مناخ إجتماعي يتسم بغياب العدالة الاجتماعية، وعدم وضوح الرؤية للمستقبل، وغياب السياسات الاجتماعية الناجحة في الجهات والأحياء المهمشة وكذلك التخطيط الفعال.
عدم وجود سياسات منظمة لأوقات الفراغ وطرح الأنشطة الترفيهية البديلة، وضعف وسائل الإرشاد والتوجيه الاجتماعي، والمستوى الاقتصادي لبعض الأسر الفقيرة يجعل التلميذ يشعر بالنقص والحرمان بين أقرانه، وهذا يدفعه إلى الإحساس بالكراهية والحقد تجاه الآخر الذي هو أحسن منه حالاً، ويولد تصرفات غريبة تسوقه إلى إقتراف بعض الممارسات العنيفة.
الثقافة:
عزوف الشباب عن دور الثقافة والشباب ونوادي الأطفال لغياب البرمجة الثرية والتجهيزات العصرية، وتسويق تجارة العنف في بعض الأعمال الدرامية والألعاب الترفيهية وفي الحوارات السياسية.
المدرسة:
قلة الأنشطة الثقافي والرياضي، وعدم توافر الأنشطة المتعددة والتي تشبع مختلف الهوايات والميول.
ضعف المقررات والمحتويات الدراسية وعدم مسايرتها للتطورات المتسارعة التي تعرفها تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة، فإعتماد بعض الأساليب التقنية التقليدية التي ما زالت تعرفها المدرسة والتي لها دور سلبي على تكوين وتربية هذا الجيل يولد بدوره ممارسات لا أخلاقية تتسم بالعنف.
إعتماد بعض المواد على الإلقاء وغياب الديناميكية والتي يلجأ فيها التلميذ إلى التشويش..
طرق التقويم المتبعة والتي ترجح التقييم الاختباري عبر المواد وإهمال التعديل السلوكي والتركيز على جوانب الضعف عند الطالب والإكثار من إنتقاده.
غياب الحصص الحوارية وكثافة حصص الإفهام، وإختلال التوازن بين التعليم والتربية، وزوال القدوة التعليمية مما أدي إلي ظاهرة الدروس الخصوصية التي أفقدت المعلم هيبته وأصبح أداة في يد الطالب وولي الأمر، ما أثر على صورته لدى الطالب وأدى إلى انهيار نموذجه كقدوة..
غياب العمل الميداني في مجال دراسة العنف، المرتكز على العمل الإحصائي والاستقصائي والمحدد لمواطن البحث المكانية والزمانية.
الحد من العنف المدرسي:
نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، ونشر ثقافة الإنصات والتواصل بين التلاميذ فيما بينهم وبين الأساتذة والتلاميذ وتنشئة الأطفال منذ الصغر عليها.
تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور لبيان أساليب الحوار ومنح الطفل مساحة للتعبير عن رأيه وبالتالي الإنصات إليه.
إعادة هيكلة الأنشطة الثقافية والرياضية وإعتماد التحفيز لأكتشاف وتشجيع المواهب.
الوقاية الاجتماعية بتحسين للظروف الاجتماعية القاسية التي تعيش فيها الجماعات المعرضة للعنف والانحراف، وإرساء ثقافة النجاح في الحياة، والتربية على فنون التواصل.
مراجعة نظام التأديب المدرسي ليصبح نظام تعديل سلوكي وقائي لا عقابي، والتكثيف من حصص الإصغاء، وتعزيز ثقة الطالب بنفسه وتوعيتهم بالجوانب الإيجابية لديهم، وإدراج حصص في علم النفس التربوي لفائدة المدرسين.
تفعيل دور الأولياء والجمعيات المختصة في المجتمع المدني والاعتناء بمشروع المؤسسة والمؤسسات ذات الأولوية.
تفعيل بدور المرشد الاجتماعي، بحصر التلاميذ أصحاب السلوك العدواني المتكرر لنتمكن من التعامل معهم، ومعرفة أسباب سلوكياتهم.
تكثيف حصص الإرشاد الاجتماعي والتوعية الوقائية عبر المجلات المدرسية والملصقات الحائطية لتحسيس التلاميذ وتحصينهم من الميل الى العنف.
تعزيز الجانب الوقائي بالمدارس، من خلال تفعيل برنامج الإشراف اليومي على حضور الطلاب ومواظبتهم والعمل على تجنب الساعات الجوفاء أو الجداول غير المنتظمة زمنياً.
إحصاء ومتابعة ودراسة حالات العنف داخل المؤسسة من لدن الأسرة التربوية ومجلس الأولياء والمرشد الاجتماعي والطبيب المدرسي والمرافق المدرسي.
خلق التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمؤسسة والأساتذة والتلاميذ، وتفعيل خلايا الانصات والإرشاد الاجتماعي.
الوقاية من العنف بمعالجة الانحرافات السلوكية التي قد يقع فيها التلميذ من شرب الخمر أو السجائر أو التوتر النفسي.
المعالجة بقيام كل من الأسرة والمؤسسة التعليمية بدورهما في التنشئة الاجتماعية من أجل تفادي أسباب المشكلة.
“عاتِبٌ عليكَ يا وطني”
#سودان سوا سوا 9 يناير 2025
الكاتب الباحث. عثمان زكريا
عاتبٌ عليك أنا يا وطني
فأنا احبكَ وأنت لست تحميني!
في صغري كان حلمي أن اشتريَ حذاءً جديداً وسروالاً فما كنتَ تحقق رغبتي؛ ما كنتَ تعطيني!
لا ولم تُؤمن لي مقعداً في جامعاتك فأجبرتني على الهجرة طلباً للعلم فاحتل البلدُ المضيفُ جزءً من عمري ومن حبي وحنيني.
وفي حياتي سلطتَّ عليَّ من أهانوني ومن أغلقوا فمي.
وعندما بلغتُ سن رشدي تركتني عُرضة للحرب، أحتمي بالصدفة وليس لي سواها من قد يحميني، فمنعتني من أن اسكبَ عصارة فكري كتابات قد تفيد غيري.
عاتبٌ عليك أنا يا وطني فلا تتبرّء من دمي!.
عاتب على قُصر نظرك وأنت الذي الغيتَ رضاعةَ الاطفالِ من أثداء الأمهات واستبدلتَ حليبَ الأم بحليب البقر فصار الثيران أخواناً لنا في الرضاعة لنكتسب من عنادهم بالوراثة عِناداً يُضاف إلى عناد الفطرة!
عاتبٌ عليك يا وطني لأنك لم تعدل في حب ابنائك فدفعتَ البعض إلى البحث عن عاطفة تعوض عن الحرمان في العاطفة، وعاتب أنام على لغة الضاد التي استبدلت العواطف بالعواصف على امتداد عمري.
عاتبٌ أنا لكنني لا أبغي اعتذاراً قد لا يصل قبل أن يمضي ما تبقى من عمري!
فها هو عمريَ اليوم يودع ما كنتُ أظنهُ عمري، اليوم اكتشفت أننا لم نُعْطَ فيك أعماراً بل إقامات مؤقتة في فاسدِ الزمن
غياب القراءة في المجتمع:
#سودان سوا سوا 9 يناير 2025
الروائي/ محمد عبدالله عبدالله أبكر
“عندما نقول القراءة هي مُفتاح العقول وطريق لنضج الأفكار ووسيلة لرقيّك لتكون مُميزاً بما من حولك، لكنها غائبة عن مجتمعاتنا، بسبب الأنظمة التعليمية المليئة بالثغرات وبعيدة كل البعد عن منهج التحليل والنقد والتشجيع على المطالعة، علي سبيل المثال تجد معظم الطلاب الذين يتخرجون ما في جعبتهم سوى ما درسوه في الكتب المدرسية والجامعية، وكثرة الملهيات التي توفرت في أيدي الشباب من نت، أفلام، ألعاب، طغيان وسائل التواصل بما تبثه من مغريات وملهيات تأخذ وقت الإنسان بأكمله، فتري الشباب عاكفين أمام شاشات التلفاز والفيديو والقنوات الفضائية، مضيعين كل أوقاتهم في متابعة الأفلام والبرامج والمسلسلات، وهذه المشاهد أصبحت حتي في القطارات والمترو ومواقف إنتظار الحافلات، تجد الكل متمسكين بأجهزتهم الذكية بدلاً من الكتاب، والمبالغة في أسعار الكتب خصوصاً اليوم أن معظم الشباب يعانوا من أزمات مادية، وقلة الحوافز والمكافآت التشجيعية والمسابقات التي تدور حول قراءة الكتب وفهمها وتلخيصها، لذلك ثقافة القراءة في مجتمعاتنا ما زالت غائبة”..
لِمَ هذا التناقض ؟
#سودان سوا سوا 8 يناير 2025
الكاتب الروائي. صلاح الدين السادة
في هذه الحياة الكثير من المرح، ولكن الكثير جدًا من الألم أيضًا. العديد من الأصدقاء، إلاّ أننا نشعر بالوحدة في أكثر الأحيان. الكثير من الأهل، والقليل جدًا من التواصل وصلة الأرحام. الكثير من الحب، والكثير جدًا من الخذلان والتلاعب بالمشاعر. القليل من المحبة الصادقة ، والكثير من الكراهِية المُبْطنة . الكثير جدًا من الشهادات، ولكن القليل من الوعي والتبصر. الكثير من منابر السلام، وما زال الحروب يُدمرُ البلاد. العديد من الدعاة، مقابل الضئيل جدًا من الإلتزام والإستقامة . الكثيرُ من المساجد، ولكن القليل جدًا من المؤمنين والمُخلصين. الوفير من الأراضي الزراعية الخصبة، يُقابلها مجَاعة وفقر حاد. الكثير جدًا من الموارد والإمكانيات، ولكن القليل جدًا من العقول المُبدعة والمُستثمرة. الكثير جدًا من الأطباء، وما زال الناس يموتون بالملاريا والكوليرا.
العديد جدًا من الفرص، والناس بطالة ومستهلكين. العديد من الأثرياء، ولكنهم تُعساء لا يستطعيون الإستمتاع بأموالهم لأن الأمراض المزمنة لا تُفارقهم.
جميعنا مُفَرّغين، ولكننا نَدَعِي أننا مشغولين. الكثير جدًا من الكتب، والقليل من القُرّاء، والذين يقرأون ن لا يتأملون إلاّ القليل من القليل منهم.
في هذه الحياة أناسٌ فرحين ويتلذذون بالأطايب.. وأخرون منكوبين يَفترِشون الأرض حزنًا وغمًا .. جوعًا وعطشًا ؛
هل هذا ما يُسمى بالأقدار ؟
أم أن هناك خيانة في الأمانة والتمتع بحق الغير ؟
لا أدري من أين نتج هذا التناقض؟!
هل نحن متناقضين مع واقعنا ؟!
أم واقعنا هي المتناقض معنا ؟!
هل هذا التناقض لِصالحُنا ؟!
أم هذا التناقض يُجّمِلُ حياتنا ؟!
لماذا لا نجتهد ونُطورُ من أنفسنا ونطمح برواتب عالية ؟!
لماذا نحن سطحيين لدرجة أننا نَتظاهرُ بالخير وفي داوخِلنا الكثير من الألم ؟!
لماذا نَتصافحُ في المساجد، ونتصارع في الطُرقات؟!
لماذا نَسعى لإرضاء الأشخاص البعيدين، ونَتجاهل القريبين مِنا جدًا ؟!
لماذا نحن سطحيين لِدرجة أننا نَخدع بعضنا بعضًا في علاقتنا ونعتبره ذكاءً وتفتيحةً ؟
أليس من الأجمل إن كُنا صادقين منذ الوهلة الأولى ؟
لِمَ الفتيات يَستخدمن مساحيق التجميل من أجل جَذبنا نحن المُهْمِلينَ الذين لم تَنعَمُ وُجُوهنا حتى بالفازلين إلا في موسم الشتاء القارص؟
ألم تَكونينّ جميلات إلا بعد استخدامها ؟
أم لديكنّ عُقدة نقص واعتراض في حق الرب؟
إستفهام أخير، لماذا نقتل بعضنا بعضًا ونطمح بدخول الجنة ؟
أليس إبليس أشرف مِنّا لأنه لم يَرتكب خَطيئة قتل النفس ؟!
ولكن ؛
علينا أن نُكونَ صادقين مع أنفسنا، ومع مَن نُحبهم حتى يكون هناك توازن بين أولوياتنا وثانوياتنا ، بين ما هي مُهم و بين هي أهم ، علينا أن نُعطي وقتًا للأشياء الثمينة في حياتنا – واجباتنا، أمهاتنا، أباءنا، أبناءنا، زوجاتنا، أزواجنا، جيراننا، أعمالنا، تعليمَنا، حبيباتنا، أخواتنا، إخوتنا، أصدقاءنا، صديقاتنا، أحاسيسنا وشعورنا .. وكل شيء جميل في حياتنا – وبحسب تحليلي المتواضع فإن إغفال أحد من تِلكم العناصر التي تمثل جوهر حياتنا ؛ هي ما تُضخم حجم التناقض فِينا.
خلاصة القول : فالفخ الذي نحن فيه لا يُمكننا الخروج منها إلاّ باقتلاع السم الذي يُسبب الداء من جذروه. وفي هذه النقطة بالذات أقتبس لكم جزءًا من قول ( جاي شيتي ) التي أورده في إحدى مقالاته : ( لا يُمكِننا حل المشكلات بنفس الطريقة التي صَنعنا بها المشكلة ).
طالما النخب نرجسية لن ننهض:

#سودان سوا سوا 6 يناير 2025
الروائي/ محمد عبدالله عبدالله أبكر
“يا إبن أدم كن كالشمعة التي إحترقت عبر النضال والكفاح، لتضئ للآخرين دروبهم، وأصرخ في زمن الصمت والخيانة والنفاق، وكن كالنار التي تُحرق عشش القش والفساد، وإختار الموت على الحياة، لأن الموت حياة للآخرين”..
حكام يتسلطون على شعوبهم، ويسيمونهم سوء العذاب في شتى المجالات، ويهدرون مقدراتهم إما لمصلحتهم الشخصية، أو خدم وعملاء لدول الغرب والصهاينة، ويواجهون المفكرين والكُتاب بكل عنف وقسوة، إما بالسجن، أو القتل أو النفي القسري..
أولاً: الأمم والشعوب الحرّة هي القادرة على الصدارة، وعلى الإبداع والتميز والانفتاح في جميع مجالات الحياة، والشعب الحر تكون تحركاته منضبطة بضابط ذاتي وأخلاقي، بدافع داخلي بدون تأثير خارجي يُفرض عليه ما يريد، بعكس الأمم والشعوب التي تعيش تحت العبودية المسيطرة، والظلم، والاستبداد، والطغيان، تجدها عاجزة تماماً وهشة وضعيفة جداً غير قادرة على الإبداع والإنتاج إلا في الحدود التي يُسمح بها الطغاة، وتُغلق العقول والأفواه، وتُكبل الحريات بالأخص حرية التعبير..
ثانياً: العلم أحد أعمدة بناء الأمم وتقدمها، فبالعلم تُبنى الأمم وتتقدم، ويساعد على النهوض بالأمم، ويقضي على التخلف والرجعية، والفقر، والجهل، والأمية، وغيرها من الأمور التي تؤخر الأمم، فالعلم من أهم ضروريات الحياة، ولذلك فإن الدول المتقدمة في العالم، والمتطورة تتميز بصفة مشتركة، أنها دول متقدمة في العلم بكافة المجالات، وتنفخ ميزانية ضخمة من أجل تطوير العلم والبحث العلمي..
عما الدول المتأخرة والمتخلفة فلا تهتم بالعلم، ولا بالبحث العلمي الذي يحقق نهضة علمية حقيقية يمكن من خلالها أن تنهض وتتصدر هذه الدول، ولكن للأسف الشديد يدّعي المستبدين والطغاة أنهم هم العلماء، ويهمِّشون دور العلماء ويحاربونهم، وينفقون جُل ميزانية الدولة تذهب هدراً إلي الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، كأنهم يريدون تحرير فلسطين وغزة، ولكن في نهاية المطاف تجدهم يستخدمونها ضد شعوبهم، هكذا يتربصون ويتمسكون بالسلطة لقرون، إلي أن أماتهم الله أو إنقلاب عسكري أو ثورة شعبية زلزلة عرشة..
ثالثاً: الشباب هم أساس نهضة الأمم، وسر قوتها، وحامل رأيتها، والمستقبل الواعد، وتقدم أي أمة وقلبها النابض وساعدها القوى، وهم عماد أى حضارة ونهضتها، وهم الشريحة الأكثر حيوية وتأثيراً فى أى مجتمع ويسهمون بدور فعّال فى تشكيل ملامح الحاضر، إستشراف آفاق المستقبل، والمجتمع لا يكون قوياً إلا بشبابه، فهم قادة سفينة الوطن نحو النمو والتقدم والنهوض..
لكن يا للأسف، يا للأسف الشديد شبابنا اليوم خريجون، لكنهم تجدهم يعملون في الأعمال الهامشية، وأخرون عاطلون، وجُل العقول النيرة هاجروا إلي أروبا وأمريكا، ومن تبقي منهم تجده إما عاطل أو حرامي أو مجرم أو سكاري بتاع مخدرات، يشربون الكحول لحتي يتخلصوا من هموهم ومشاكلهم، لكنهم وصلوا حد الإدمان، حتي صاروا مجانيين..
لذلك نحن اليوم بحاجة حقيقة لرجل مثل (لي كوان يو)، الذي حول سنغافورة من جزيرة فقيرة كان الجميع يتوقع لها الفشل والانهيار، إلى دولة يتمنى الجميع منا أن يعيش فيها، حيث أحاط نفسه بفريق أصحاب العقول النيرة مما أمكنه أن يحول أحلام سنغافورة إلى واقع حقيقي معاش ملموس، رغم التحديات والخلافات الإثنية والعرقية، أنه إستطاع من كتابة تاريخ الميثاق الوطني الذي يُقرأ كل يوم في المدارس، مع ذوبان الفوارق بين جميع الإثنيات، لتكوين الهوية السنغافورية، وهي صمام الأمان لدولة سنغافورة..
وأخيراً أقول: لن تنهض الدول طالما هناك نُخب نرجسية إنتهازية، تستبيح كل شئ في صراع لاحتكار السلطة، والهيمنة والإقصاء والخضوع على الفشل، لن تنهض أبداً طالما الدول تُدار بالمسكنّات نحو الاستبداد والتبعية والفساد، لن تنهض أبداً..
لن تنهض أبداً..
كفاح ونضال أمونه:
الروائي/ محمد عبدالله عبدالله أبكر
سودان سوا سوا 26ديسمبر2024
أمونه ولدت في بيئة ظالمة، هدرت من حقوقها، حُرمت من الدراسة، تزوجت وهي قاصرة، أُجبرت على الزواج، أنجبت عشرة أطفال..
تستيقظ يومياً في الصباح الباكر، تُحضر لأطفالها شاي الصباح والفطور، تترك أطفالها وهم نيام، تذهب لعملها (عمل حر هامشي في كمائن الطوب)..
أمونه تقطع مسافة طويلة عشرات الكيلومترات من أجل لقمة عيش شريفة، قاومت قساوة الزمن والطبيعة، كافحت من أجل تربية أبنائها، أكل، شراب، ملبس، سكن، مصاريف زوجها (سكاري عاطل، رمتالي، متجول بين بيوت الفداديات، من داله، لدمنة، لكشتانة)..
بالرغم من نضالها وكفاحها في العمل الشاق، يأتي هذا السكاري تلت الليالي يصرخ فيها، يسمعها كلام فارغ، ضرب، إذلال، إهانه، وهي متحملة صابرة كل الألم والعذاب والوجع..
أمونه تعتل أكثر من عشرة طوبه علي رأسها لكي توفر لقمة العيش لأبنائها، ولزوجها مصاريف السُكر والتدخين، أمونه خاضت معارك الحياة بكل كفاءة وجراعة، أصبحت تنفق لزوجها، كافحت تحملت الصعاب وحمل الأثقال..
ظروف قاسية فرضت عليها الحياة، تجردت من أنوثتها، أصبحت أفضل من زوجها العاطل عن الحياة وعن العمل معاً،
تحية لكي يا أمونه، الخزي والعار لذاك الرجل الذي يأكل من كتفك، ولكل رجل يأكل من عرق جبين زوجته وهو نائم متكئ علي وسادة..
التعايش الاجتماعي
اساس النهضة والتطور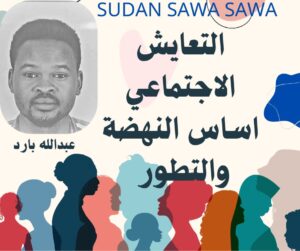
كتب: عبدالله بارد
سودان سوا سوا 18 ديسمبر 2024
تتجلى الأهمية الكبرى لهذا الأمر في مسؤولية الباحثين والدراسين وعلماء الاجتماع، الذين يدرسون البنية الاجتماعية ويشخصون المشكلات التي تعاني منها المجتمعات. إن ضمان استقرار هذه المجتمعات وتواصلها، وتعزيز الروابط بينها، هو أمر بالغ الأهمية. ويعني التعايش بشكل عام إيجاد شعور مشترك بين الفئات المتعددة في مجالات عدة، مثل التعايش الديني والاجتماعي والسياسي والثقافي والحضاري، ضمن وحدة سياسية واحدة تضم كيانات مختلفة، حيث يتشارك الجميع في العيش معًا وقبول الآخر المختلف، والانفتاح عليه من خلال حوار يعزز الثقة المتبادلة بين المجموعات المتنوعة، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى الوحدة والمصير المشترك.
إن المفهوم العام للتعايش وعلاقة الذات بالآخر، والاعتراف بوجود الآخر المختلف، يعكس وجودًا مشتركًا بين الفئات المتعددة، حيث يتفقون على تنظيم حياتهم وفقًا لقواعد يحددونها بأنفسهم، بهدف تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والعدالة بينهم.
التعايش السلمي هو ببساطة الشعور المشترك والاعتراف بوجود الآخرين.
نعم للتعايش السلمي،
نعم للتعايش الديني،
نعم للتعايش الاجتماعي،
نعم للتعايش الثقافي،
نعم للتعايش الحضاري.
التعايش هو أساس النهضة والتطور في أي دولة.
الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان
لجنة المعلمين السودانيين
بيان صحفي
تُعلن الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان عن بدء حملة توعوية حول التعليم اليوم، الثلاثاء، الموافق 17 ديسمبر 2024.
#التعليم_وسيلة_لإسكات_أصوات_البنادق
تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم نتيجة النزاع، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الجماهيري حول أهمية رفض الحرب وما ينجم عنها. كما تسعى الحملة إلى التأكيد على ضرورة إعادة التعليم إلى مساره الطبيعي، باعتباره حقًا أساسيًا لا ينبغي أن يتأثر بالمزايدات السياسية.
تستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام، حيث تبدأ اليوم الثلاثاء وتنتهي يوم الخميس، 19 ديسمبر 2024.
كتب:عثمان زكريا
باحث اجتماعي وحقوقي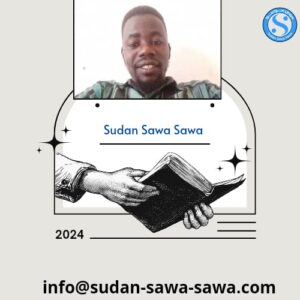
_السودان
هذا المشهد ليس غريباً علينا كما سبق لنا كسودانيين في عهد النظام الإسلامي المخلوع/عمر البشير. بعد أن سقطت الثورة الشعبية، قامت أيادي خبيثة باختطاف الثورة وحلت محلها أنظمة ودويلات مشابهة للنظام السابق. نظام ودويلة آل الأسود تزول ويحل محلها نظام ودويلات مشابهة؛ لا أدري لماذا لا يتعظ القادة الأفارقة والعرب ويدركون أن للتاريخ دورته، وأنه لا ينسى من يتجاهل دروسه.
أتمنى أن أبارك للشعب السوري هذا التغيير المهم، ولكن القلق من المجهول يعكر فرحة الإنجاز، والخوف يكمن في أن تكون المرحلة المقبلة شبيهة بما يحدث لنا في السودان من حروب وميليشيات من مختلف الطوائف الانتهازية القاتلة.
ونحن نرى النهب والسلب قد بدأ في سوريا، إلى جانب التصفيات على أساس الولاءات لهذا النظام أو ذاك الحزب أو تلك الدولة. ندعو أن تجتاز هذه المرحلة بسلام، وأن تصل إلى بر الأمان أسرع مما حدث في السودان معنا، وما زلنا ندفع فواتير ثمنها من أجل التغيير الجذري.
ويا ليت القادة والزعماء الأفارقة والعرب يدركون أن ولاءهم لغير أوطانهم وشعوبهم سيكون يوماً وبالاً عليهم، وسينتهون متسللين بما يحملونه.فدماء الشهداء وصرخات المظلومين لها أثرها، وإن طال الأمد،حمى الرب شعوب قارتنا الافريقية والعربية من ويلات حكامها الطاغية.
رصيف الحرب 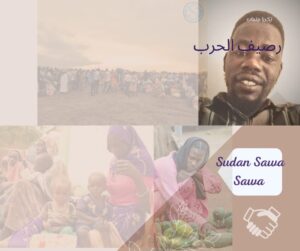
عثمان زكريا
باحث اجتماعي وحقوقي
السودان
على رصيف الحرب الذي نُقش بحوافر الأمم المتغلبة،
تتجلى قوة فائضة في شكل كائن مشوه،
يمتلك دولة مصنوعة مسبقاً،
والموازي لرصيف بائعي الانتصارات
التي انتهت صلاحيتها.
تتواجد المدينة، متكئة
على ظلها المكسور،
كفاعل رئيس،
تقوم ببيع أعضائها الحية الناجية
من فوضى التاريخ،
وتعرض دموعها المستعملة على بسطة
من ذاكرة دارفور الحزينة.
تصرخ في وجه المارة
في سوق البكاء والتباكي،
تسعى لشراء نظارة فرح
لعينيها،
عندما تتوقف الحرب،
لتفادي الإصابة بالتعاسة.
لا أحد يشتري من دموعها
سوى النازحين في الأرجاء
لأجل الذكرى والمتشردين.
هالة الكارب امرأة ملهمة في العام ٢٠٢٤م
#سودان سوا سوا 5 ديسمبر 2024
اختارت بي بي سي ضمن قائمة اكثر مائة امرأة إلهاماً وتأثيراً لعام ٢٠٢٤م الأستاذة هالة الكارب المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي (صيحة)
وكرّست هالة الكارب حياتها للنضال من أجل حقوق النساء والفتيات، وتسليط الضوء على معاناتهن بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في منطقة القرن الإفريقي.
وتمتد إسهاماتها إلى الدفاع عن ضحايا وناجيات العنف الجنسي في مناطق النزاعات، حيث تمكنت من إيصال أصواتهن إلى العالم من خلال جهودها المستمرة وكتاباتها المؤثرة.
هذا التكريم المستحق يعكس عمق إسهاماتها في تعزيز العدالة النوعيّة، ودعم حقوق النساء، والعمل من أجل تحقيق السلام.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، تقوم SIHA بتتبع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتقديم الدعم للنساء والفتيات.
وحذر تقرير للأمم المتحدة صدر في أكتوبر 2024 من الحجم “المذهل” للمشكلة، واتهم قوات الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب “جرائم فظيعة”، وهي الاتهامات التي نفتها قوات الدعم السريع.
وقدر التقرير أنه تمت إحالة ما لا يقل عن 400 ناجية من العنف الجنسي المرتبط بالصراع إلى الدعم اعتبارًا من يوليو 2024، واصفًا ذلك بأنه “قمة جبل الجليد”.
ونشطت الكارب في حماية النساء من العنف الجنسي ودرجت على اصدار عن الحرب وتداعياتها على النساء في كل من الخرطوم والجزيرة ودارفور وعقدت العديد من المؤتمرات الصحفية ونفذت الكارب قبل الحرب ورش عديدة للنساء والفتيات لرفع قدراتهن في شتى المجالات بالعاصمة والولايات ولم تكتفي الكارب بحماية النساء من العنف الجنسي فقط بل قامت بتدريب الفتيات على وسائل لكسب العيش وتعليم حرفة مع التدريب المهني بالخرطوموكانت بي بي سي قد أطلقت قائمة 100 امرأة في العام 2012 بعد عمليات اغتصاب جماعي تعرضت لها نساء في دلهي، وبهدف تحسين مستوى التغطية الإعلامية لقصص النساء، وحازت نساء ملهمات مثل الكارب في الفترة الماضية مثل السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا والمتسلقة الإيرانية إلناز ركابي، التي خاضت منافسة حاسرة الرأس في وقت تشهد فيها بلادها مظاهرات احتجاجا على إلزامية الحجاب والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بيلي إيليش والممثلة والمنتجة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس.
وتحتفي قائمة هذا العام بإنجازات النساء على صعيد العالم أجمع، ومن جميع الفئات، من المتطوعات إلى القائدات الشهيرات.
الجزيرة نزوح قسري للقري (3)
سودان سوا سوا 5ديسمبر 2024
سمعنالنا خبرا في الهلالية..لكنه خبر فاجع وحزين ،فالموت الجماعي يحصد ارواح أسرة كاملة والمئات من المدنيين، بالهلالية التي وصفها الشاعر الهادي ادم بقوله (.لـفــت يد النيل خصراً منك فأرتعشت أمـــواجــه مـن هـيـام فـهــو صفـــاق..ذكــرت فـيـك الصــبا فالـقـلب منفطر..بيـن الــضـلــوع ودمــع العين مهراق) فاليوم نحن قلبنا ايضا منفطر بين الضلوع ودمع العين مهراق لما حاق باهلنا في كل السودان والجزيرة خاصة لتلك الفواجع الدامية ومن يستمع الي تلك القصص المرعبة يعلم مدي فظاعة هذه الحرب التي يجب ان تقيف، ، وفي شرق ودراوة كنت اتحدث عبر الواتساب مع ابن عمتي (عشه) كما يحلو لي مناداتها وهي تبلغ من العمر (80) سنة فسألته عن أحوالهم مع الحرب فقال لي نحن هجرنا القرية كلنا الي شندي فقد اجبرتنا الحرب علي ترك ديارنا وسنين طفولتنا وشبابنا وبلداتنا يقصد أراضيهم الزراعية التي تتم زراعتها في فصل الخريف بمحصول الذرة هجرنا تاريخنا وقريتنا بحثا عن مكان امن،وسرد لي تفاصيل تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر والارتكازات وصعوبة المواصلات وارتفاع قيمتها وعدم وجود المياه النظيفة للشرب والطعام ،وكان همهم طوال الرحلة التي بها اطفال وكبار السن مثل عمتي (عشه) هو الحصول علي القليل من الغذاء مثل البلح او جرعة مياه لاجل البقاء علي قيد الحياة. والسير بالارجل لمسافات طويلة في قيزان ورمال وخيران البطانة
املا في الأمان.
الكوليرا..
وبحسب وكالة رويترز فقد قال مصدر طبي بوجود حالات إصابة بالكوليرا بين النازحين في منطقة الهلالية شرق ولاية الجزيرة، والتي تشير التقارير إلى أن قوات الدعم السريع قد حصرتها ونهبت ما فيها، مما دفع البعض إلى استخدام مياه بئر ملوثة. وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود اشتباه في انتشار الكوليرا في شرق ولاية الجزيرة. وذكر مصدر طبي لوكالة “رويترز” يوم الجمعة 15 نوفمبر أن العشرات من السكان الذين فروا من مدينة الهلالية المحاصرة في ولاية الجزيرة بالسودان ثبتت إصابتهم بالكوليرا، مما قد يفسر الوفيات المسجلة للمئات في تلك المنطقة. بينما يذكر نشطاء محليون أن أكثر من 300 شخص قد فقدوا حياتهم، فقد قامت مجموعة من سكان الهلالية في الشتات بتزويد وكالة “رويترز” بقائمة تتضمن أكثر من 400 حالة وفاة، وهو رقم يقولون إنه في تزايد مستمر كل ساعة.وتحاصر قوات الدعم السريع المدينة، التي تعد موطناً لعشرات الآلاف من السكان المحليين والنازحين، منذ 29 أكتوبر كجزء من حملة هجمات في شرق ولاية الجزيرة انتقاماً لانشقاق أحد كبار قادة القوة شبه العسكرية وانضمامه إلى الجيش. قتل ما لا يقل عن 15 شخصاً خلال هجوم قوات الدعم السريع الذي أدى لبدء الحصار، حسبما أفاد نشطاء. ومع ورود تقارير عن وفيات جماعية، انتشرت شائعات حول أسباب تلك الوفيات وما إذا كان جنود قوات الدعم السريع قد سمموا الناس عمداً.لكن المصدر الطبي أشار إلى أن عددًا متزايدًا من الأشخاص الفارين من المدينة قد ثبت إصابتهم بالكوليرا. ذكر مسعفون آخرون من المدينة لوكالة “رويترز” أنه بعد أن قام الجنود بطرد السكان من منازلهم وسرقة الأموال والسيارات والمواشي، لجأ معظم السكان إلى ساحات ثلاثة مساجد.واستولى الجنود أيضا على الألواح الشمسية والأسلاك الكهربائية المستخدمة في استخراج المياه الجوفية، مما اضطر بعض السكان، على الأقل، للاعتماد على بئر تقليدية ضحلة لم تُستخدم منذ عقود، وربما اختلطت مياها بمياه الصرف الصحي، وفقاً لتصريحات مسعفين وشهود. طلب المسعفون والشهود عدم الكشف عن هوياتهم خوفًا من الانتقام من أي من أطراف الصراع.
نجونا باعجوبة من الموت..
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن وجود تفش محتمل للكوليرا بين النازحين من شرق ولاية الجزيرة، وهو واحد من عدة بؤر تفشي في مختلف أنحاء البلاد، لكنها لم تذكر مدينة الهلالية بشكل محدد. أفادت غرفة طوارئ شرق النيل بأن الأطباء في مستشفى أم ضوابان عالجوا ما لا يقل عن 200 حالة إصابة بالكوليرا من المنطقة. في ظل غموض السبب الحقيقي، بدأ العديد من سكان الهلالية يعانون من آلام في المعدة وإسهال وقيء.وأوضح أحد الأطباء أن الجنود قاموا بنهب المستشفيات والعيادات والصيدليات في المدينة، مما حال دون قدرة عدد كبير من الناس على الحصول على المضادات الحيوية اللازمة للتعافي. بدأ الباقون الذين لم يستطيعوا الحصول على الدواء يموتون.وأفاد شهود عيان وصلوا إلى مدينة شندي التي يسيطر عليها الجيش بأن الذين أرادوا المغادرة دفعوا لجنود قوات الدعم السريع مبالغ كبيرة لنقلهم خارج الولاية. بينما بقي الآلاف في المكان.وقال رجل عمره 70 عامًا: “لقد نجونا بأعجوبة من الموت لأن العديد من حولنا لقوا حتفهم بسبب المرض”. فادت الحرب التي بدأت في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تدمير البنية التحتية في السودان ونتج عنها تفشي الأمراض، مما أدى إلى حدوث أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.
المياه الملوثة..
وفي المقابل اكدت منظمة اوشا تفشي مشتبه به للكوليرا بين النازحين من شرق ولاية الجزيرة بمنطقة البطانة بولاية القضارف وقالت اوشا في بيان صحفي لها الأربعاء الماضي إن المرض ينتشر بسرعة بين مجتمع النازحين حيث لا يستطيع النازحين الوصول إلى مياه الشرب النظيفة ويضطرون إلى شرب المياه الملوثة من مصادر المياه المفتوحة. وتم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 150 حالة كوليرا مشتبه بها في مستشفى الصباغ الريفي، وهو مرفق صغير ذو قدرة محدودة على استيعاب العديد من المرضى. وتستمر قرية الصباغ في استقبال تدفق كبير من النازحين يوميًا، مما يزيد الضغوط على الخدمات الصحية المحلية.
الفرار من المنازل..
وقالت اوشا ان النازحيين المدنيين الفارين من الحرب بولاية الجزيرة ومحلياتها المختلفة الذين نزحوا الي منطقة ريفي نهر عطبرة (منطقة ريفية) بولاية نهر النيل ان الغذاء من الاحتياجات الرئيسية للنازحين الجدد الذين يحتاجون إلى توفير مستمر للمساعدات الغذائية لأنهم فقدوا إمداداتهم وفرص كسب الرزق. واضطرت الأسر إلى تقليل عدد الوجبات واستهلاك وجبات أرخص وأقل تغذية وإعطاء الأولوية للطعام لأطفالهم. واضافت (قد فر النازحون من منازلهم وهم لا يحملون أي شيء، ولا يملك أغلبهم مأوى مناسب لحمايتهم من الظروف الجوية. ويعيش النازحون الذين يعيشون بين المجتمعات المضيفة مع اثنتين إلى ثلاث أسر في غرفة واحدة، وينام الرجال في الهواء الطلق بينما تنام النساء والأطفال في الداخل. ويعيش النازحون في مواقع التجمع في العراء أو تحت الأشجار أو جدران منازل الناس ) وكشفت اوشا عن نقص حاد في الخدمات الصحية لنازحي الجزيرة ومحلياتها المختلفة الذين فروا عقب الاحداث الدامية في 20 اكتوبر الماضي الي منطقة ريفي نهر عطبرة (منطقة ريفية) بولاية نهر النيل،وقالت ان سعة هذه المرافق وطاقم العاملين بها غير كافيين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وخاصة الوصول إلى الأدوية للأمراض المزمنة والصحة الإنجابية وخدمات التطعيم. وهناك وصول محدود إلى المياه النظيفة ويضطر الناس إلى استخدام المياه غير الآمنة من القنوات ومصادر المياه الجوفية. وهناك أيضاً نقص في المراحيض ومجموعات الكرامة للفتيات والنساء. إن مرافق التغذية بعيدة عن المناطق التي تجمع فيها النازحون، والإمدادات غير كافية لتلبية الاحتياجات الجديدة.
المقدمة
في أوقات التغيير وعدم اليقين، تُعد البيانات الصادرة عن القادة، والمنظمات، والمجتمعات أدوات قوية لتشكيل الخطاب العام والتأثير على صنع القرار. في السودان، لعبت البيانات دوراً محورياً في عكس الطموحات، ومعالجة المظالم، ورسم مسار للمستقبل. تُبرز منصة “البيانات” هذه الرسائل الحيوية، مقدمة منصة للأصوات المتنوعة التي تسهم في قصة البلاد المتطورة.
البيانات الرسمية
تُصدر البيانات الرسمية من القادة الحكوميين والمنظمات الدولية لتقديم رؤى مهمة حول السياسات، والنوايا، وردود الفعل تجاه الأحداث المتطورة. غالباً ما تحدد هذه التصريحات أطر العمل، وتقدم التطمينات خلال الأزمات، أو تعبر عن مواقف دبلوماسية.
من خلال أرشفة وتحليل هذه البيانات، تساعد المنصة الجمهور على فهم مواقف الأطراف الرئيسية، مما يوفر رؤية أوضح للمشهد السياسي والاجتماعي في السودان.
المجتمع المدني والحركات الشعبية
تقدم البيانات الصادرة عن مجموعات المجتمع المدني والحركات الشعبية لمحة حقيقية عن المخاوف والمطالب للشعب السوداني. تسلط هذه الأصوات الضوء غالباً على القضايا التي تغفلها السرديات السائدة، مثل العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والتحديات البيئية.
تعزيز هذه البيانات لا يضمن التمثيل فقط، بل يعزز أيضاً الشعور بالمسؤولية الجماعية، مما يمكّن المجتمعات من السعي نحو تغيير هادف.
التضامن الدولي
حظيت رحلة السودان نحو الاستقرار والتقدم باهتمام عالمي، حيث تعكس البيانات الصادرة عن الحكومات الأجنبية، والمنظمات غير الحكومية، والمجموعات المدافعة عن الحقوق التضامن الدولي. غالباً ما تحمل هذه الرسائل دعماً، أو دعوات للمساءلة، أو موارد لمعالجة الأزمات الإنسانية.
تسليط الضوء على مثل هذه البيانات يؤكد على الترابط بين السودان والمجتمع الدولي ويبرز أهمية الاستمرار في المشاركة الدولية.
بيانات التأمل والأمل
إلى السياسة والدعوة، تحمل بعض البيانات رسائل تأمل، وأمل، وصمود. وتشمل هذه الرسائل في بعض الأحيان أنها ثقافية، رئيسة دينية، أو مواطنين عاديين يشاركون في تجاربهم ورؤيتهم لمستقبل.
تعمل هذه البيانات كتذكير بالقوة وصمود الشعب السوداني، ملهمة أخرى ومتفائلين رغم التحديات.
الحدث الجماهيري
تشجع منصة “البيانات” الفعاليات الجماهيرية، مما يتيح للقراء المشاركين من خلال آراء الرأي، والنقاشات، أو تقديم بياناتهم الخاصة. وينتج عن ذلك الشعور التشاركي بالشمولية ويضمن بقاء البناء ديناميكيًا للحوار.
الخاتمة
تُقدم “البيانات” مساحة مُنسقة للأصوات التي تُشكل الرواية السودانية، وتُعرف حول وطنها وطموحاتها. من خلال عرض النظرة المتنوعة، تسد المنصة الفجوات وتعزز الثقة بين الجماهير المحلية للتجارة.
في الوقت المناسب، لا يمكن تهريب الكلمات. عبر “البيانات”، تُروى قصة السودان وتغتني بالأصوات التي تُحدد مسارها إلى النهاية.
